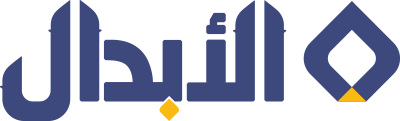قراءة في استعمال الإمام الخميني للظهور في الآيات الشريفات

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والحمد حقّه، كما يستحقه حمداً كثيراً، وأستعين به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسوله، وأنّ علياً وأبناءه المعصومين المطهرين خلفاؤه على عباده، وأمناؤه في حلاله وحرامه.
اللهم صلّ على محمد وعترته الأقدسين، ثم ارحم وترضى على متابعيهم، ومقتفي آثارهم، والمقتبسين من أنوارهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. وبعدُ، استهدف الكاتب من خلال هذا البحث -الاستقرائي الناقص- قراءة تجربة الإمام الخميني (قدِّس سرُّه) في استعمال الظهور، لغرض بيـان أهميـة ذلك في العمليـة التفسـيرية، وشحذ قدرة المهتمـين على تشخيص الظهور، وتحديد الأظهر، لأنّ الظاهر وإن كان بمعنى يُقارب الواضح، إلاّ أنّ المتكلم قد لا يُريد من المفردة أو الجملة هذا القريب الواضح، بل يُريد معنى آخر(1).
وسيظهر لك من المناقشات التي أثارها الإمام (قدِّس سرُّه) في تحديد الظهورات -عندما تطّلع عليها إن شاء الله-، أنّ الظهور قد يُختلف في تحديده، للاختلاف المحتمل وطبيعة النظر في القرائن المتصلة أو المنفصلة أو للغفلة عنها، فمثلاً: قد يوجد مخصِّص للعموم في القرآن نفسه أو في السنة المطهرة، إلاّ أنّ عدم تنبّه مُفسِّرٍ لهذه القرينة حال فحصه عنها موجب لأخذه بالعام، بينما عثور آخر عليها موجب لتخصيص الظاهر أو تقييده، كعثوره على خبر مخصص لعمومات الكتاب، أو مقيد لمطلقاته.
ومما ذُكر يتبيّن لك أنّ تشخيص الظاهر، يتطلب -أحياناً- إعمالاً علمياً عالياً، وحضوراً معرفياً يقظاً، وكلُّ ذلك يجعل دراسة التجارب في هذا المجال ذات قيمة عالية، وهنا مباحث: المبحث الأول: معنى الظهور في اللغة: “الظهر: خلاف البطن من كل شيء”(2)، و”الظهور: بدو الشيء الخفي”(3). يُقال: “ظهر الشيء -بالفتح- ظُهورا: تبيّن”(4).
ومن المعاني التي تُذكر للظهور: البروز(5)، والوضوح(6). والمعنى في الجميع واحد، غير أنّ في بعضها حيثية البدو بعد خفاء. وفي الاصطلاح لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي.
وهذا التحميل لوجود رجحان في اللفظ أوجب انسباق المعنى منه إلى الذهن، وفي هذا إشارة إلى أنّ الظاهر ما احتمل أكثر من معنى، وكان أحدهما راجحاً.
المبحث الثاني: حكم الظهور والإمام (قدِّس سرُّه) قد أثبت حجية الظواهر لتأسيس شرعية العمل بها في كتاب الله تعالى، فقد ذكر: (قدِّس سرُّه) “إن بناء العقلاء تحميل ظاهر كلام المتكلم عليه، والاحتجاج عليه، وتحميل المتكلم ظاهر كلامه على المخاطب، واحتجاجه به”(7)، فـ”المتبع هو الظهور المنعقد للكلام، وإن شكّ في قرينية الموجود، ما لم ينثلم الظهور”(8).
وقال (قدِّس سرُّه): “لا إشكال ولا كلام في أن بناء العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات الاستعمالية، فاللفظ الصادر من المتكلم -بما أنه فعل له كسائر أفعاله- يدل بالدلالة العقلية -لا الوضعية- على أن فاعله مريد له، وأن مبدأ صدوره هو اختياره وإرادته، كما أنه يدل بالدلالة العقلية -أيضاً- على أن صدوره يكون لغرض الإفادة، ولا يكون لغواً، كما أنه يدل بهذه الدلالة على أن قائله أراد إفادة مضمون الجملة خبرياً أو إنشائياً، لا الفائدة الأخرى، وتدل مفردات كلامه -من حيث إنها موضوعة- على أن المتكلم به أراد منها المعاني الموضوعة لها، ومن حيث إنه كلام مركب -من ألفاظ وله هيئة تركيبية- على أنه أراد ما هو الظاهر منه، وما هو المتفاهم العرفي لا غيره، ويدل أيضاً على أن المتكلم – المريد بالإرادة الاستعمالية ما هو الظاهر من المفردات والهيئة التركيبية- أراد ذلك بالإرادة الجدية، أي: تكون إرادته الاستعمالية مطابقة لإرادته الجدية.
وكل هذه دلالات عقلية يدل عليها بناء العقلاء في محاوراتهم، والخروج عنها خروج عن طريقتهم، ويحتجون [بها] على غيرهم في كل من تلك المراحل، ولا يصغون إلى دعوى المخالفة، وهذا واضح”(9).
وقال (قدِّس سرُّه) أيضاً: “والظاهر أن أصالة عدم القرينة -أيضاً- ترجع إلى أصالة الظهور، أي: العقلاء يحملون الكلام على ظاهره حتى تثبت القرينة، ولهذا تتبع الظهورات مع الشك في قرينية الموجود ما دام كون الظهور باقيا.
وبالجملة: المتبع هو الظهور المنعقد للكلام وإن شك في قرينية الموجود ما لم ينثلم الظهور.
وبالجملة: لا إشكال في حجية الظواهر، من غير فرق بين ظواهر الكتاب وغيره، ولا بين كلام الشارع وغيره، ولا بالنسبة إلى من قصد إفهامه وغيره”(10).
وبحث حجية الظواهر في الكتاب الكريم، كاشف عن أثره وأهميته في العملية التفسيرية، وهذا ما دعى لمحاولة التعرف على تجربة الإمام الخميني (قدِّس سرُّه) في استعمال الظاهر في تفسيره لآيات كتاب الله تعالى.
المبحث الثالث: ثمرات تشخيص الظهور ولبيان أهمية تشخيص الظهور، وضرورة المداقّة في تحديده لمعرفة المعنى المراد، يمكن الإشارة إلى الثمرات الآتية: الثمرة الأولى: تشخيص الإطلاق من عدمه: وإليك هذين المثالين: المثال الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ﴾(11)، فقد استُدِل به على جواز استقلال العامي في القضاء بدعوى أن “إطلاقه شامل للمقلد العامي، ومعلوم أنه إذا أوجب الله تعالى الحكم بالعدل بين الناس، فلا بد من إيجاب قبولهم ومن نفوذه فيهم، وإلا لصار لغوا”(12).
ونجد أنّ الإمام (قدِّس سرُّه) يعتمد ظهور الآية في تفنيد الإطلاق، ويخصص الأمر بمن له الأمر، فيقول: “إن الخطاب في صدر الآية متوجه إلى من عنده الأمانة، لا إلى مطلق الناس، وفي ذيلها إلى من له الحكم وله منصب القضاء أو الحكومة، لا إلى مطلق الناس أيضا، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، فحينئذ يكون المراد: أن من له حكم بين الناس، يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل.
هذا مضافا إلى أنها في مقام بيان وجوب العدل في الحكم، لا وجوب الحكم، فلا إطلاق لها من هذه الحيثية”(13).
يقول (قدِّس سرُّه): “والإنصاف: أن هذه الآية ليس لها إطلاق يمكن أن يتمسك به للمطلوب، مضافا إلى أنه لو كان لها إطلاق، ينصرف إلى من كان صاحب الأمر، دون غيره”(14).
المثال الثاني: ما استُدِلَّ بِهِ على جواز استقلال العامي في القضاء، فقد قيل أنّ “قوله تعالى في المائدة: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾(15)، وفي آية: ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾(16)، وفي ثالثة: ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾(17)، دلت بمفهومها على وجوب الحكم بما أنزل الله، وإطلاقه شامل للعامي المقلد”(18).
والإمام (قدِّس سرُّه) يرفض هذا الفهم قائلاً: “إن الآيات الكريمة في مقام بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يستفاد منها جواز الحكم أو وجوبه لكل أحد، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة”(19).
ثمّ يقول (قدِّس سرُّه): “والإنصاف: أن هذه الآية “ليس لها إطلاق يمكن أن يتمسك به للمطلوب، مضافا إلى أنه لو كان لها إطلاق، ينصرف إلى من كان صاحب” الحكم، دون غيره”(20).
ونجد واضحاً اختلاف التفسير، لاختلاف تحديد المراد من الآية.
الثمرة الثانية: تحديد المعنى المراد: إذ إنّ الظهور يعني -فيما يعني- تحديد معنى الآية، ويختلف تفسير الآية عند الاختلاف في تحديده.
ويمكن التمثيل بآية تحريم الخبائث، إذ ادعي أنّ الأصل الثانوي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسات، ثمّ استُدل على هذه الدعوى بالآية المذكورة، “بتقريب أن النجاسات والمتنجسات من الخبيثات، وأنَّ الحُرمةَ إذا تعلَّقت بذاتِ الشيء، تفيد حرمة مطلق الانتفاعات، لأنّ التّعلق بها مبنيٌّ على الدَّعوى، وهي أنسب لها”(21).
ولكن الإمام (قدِّس سرُّه) تنظّر في هذا الاستدلال، وقال: “يظهر النظر فيه بعد ذكر الآية الكريمة قال تعالى: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا -أي: الرحمة- لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾(22)، فإنّ مبنى الاستدلال على دعوى تعلق الحرمة على عنوان الخبيثات، وأنت خبير بأن الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد الإخبار عن أوصاف النبي (صلَّى الله عليه وآله) بأنه ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الخ).
وليس المراد أن النبي (صلَّى الله عليه وآله) يحرم عنوان الخبائث أو ذاتها، ويحلّ عنوان الطيبات أو ذاتها، بل بصدد بيان أنه يُحلّ كلّ ما كان طيباً، ويحرّم كلّ ما كان خبيثاً بالحمل الشايع، ولو بالنهي عن أكله وشربه، فإذا نهى عن شرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير، وهكذا، يصدق أنه حرم الخبائث، فلا دلالة للآية على تحريم عنوان الخبائث، وهو ظاهر”(23).
الثمرة الثالثة: ترجيح أظهر محتملات الآية: ويمكن التمثيل بمثالين: المثال الأول: قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾(24)، وسيتم توضيح ربطه بالمقام من خلال جهتين: الجهة الأولى: في الاستدلال به على أن الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل وقت اختياري للصلوات الأربع، قال (قدِّس سرُّه): “بيان ذلك أن في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾(25)، احتمالات: أحدها: أنه أمر لخصوص النبي (صلَّى الله عليه وآله) بإقامتها من الزوال إلى انتصاف الليل، ويكون أمراً مولوياً وجوبياً.
ثانيها: أنه أمر مولوي متوجه إليه بإيقاعها في القطعة المذكورة، بأن لا يكون الأمر متوجها إلى نفس الصلاة التي ظرفها تلك القطعة، بل إلى لزوم جعلها فيها بعد مفروضية كونها واجبة.
وبعبارة أخرى: لم يكن بيان أصل وجوبها بالآية الشريفة، بل كان ثابتا من قبل، وإنما تعلق الوجوب بجعل الصلوات الواجبة في تلك القطعة.
ثالثها: أنه أمر إرشادي متوجه إليه لبيان شرطية الوقت للصلاة، كالأوامر المتعلقة بساير الشروط، كالطهارة والقبلة.
فعلى هذه الاحتمالات، لما كان الخطاب شخصياً متوجهاً إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لا محالة، يكون الأمر للتوسعة اختيارا، فإن الاضطرار كالسهو والنسيان والخطأ والجهل والإغماء والمرض الموجب لعدم الالتفات إلى أوقات الصلاة، بل النوم الموجب لترك الصلاة في الوقت الاختياري، غير جايز على النبي (صلَّى الله عليه وآله)، وما ورد من نومه منها، لا بدّ فيه من التأويل أو الرد إلى أهله، فلا محالة يكون الخطاب لشخص ملتفت غير معذور، فتكون التوسعة لصلاة المختار، ثم بعد ثبوت ذلك له (صلَّى الله عليه وآله)، تثبت للأمة، للإجماع، بل الضرورة على الاشتراك، وعدم كونها من مختصاته، ولا يفرق في استفادة ذلك بين الوجوه المتقدمة، حتى على الاحتمال الثالث، لأنّ الأمر الإرشادي أيضاً، متوجه إليه، فيكون إرشادا له إلى ذلك.
نعم لو كان المراد من أمره بالإقامة إقامتها في الأمة بأن يكون مأمورا بأن يأمر الأمة بإقامتها، لكان أمره بها قانونيا يصح فيه الإطلاق للحالات العارضة، لكنه خلاف الظاهر.
ولعل الظاهر هو الاحتمال الأول، للفرق بين المقام وغيره مما أمر بالأجزاء والشرايط، لقيام القرينة في سائر الموارد على الإرشاد، لتعلق الأمر بالجزء أو الشرط ونحوهما مما لا يصح فيه الحمل على المولوية، وأما في المقام، فيحمل على ظاهره، لتعلقه بالصلاة في الأوقات المذكورة.
والحاصل، أن الحمل على الإرشاد، حمل على خلاف الظاهر المحتاج إلى القرينة المفقودة في المقام.
فتحصل مما ذكر: أن الوقت المستفاد من الآية وقت اختياري، هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات عليه وعدم صلاحية الروايات الموهمة للخلاف لمعارضتها، بل في نفس تلك الروايات شواهد على أن الأوقات المذكورة فيها أوقات فضل على مراتبه، ولا يقتضي المقام تفصيل الأوقات وأحكامها.
فلا إشكال في أن وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل اختيارا. كما لا إشكال في عدم امتداده إلى الفجر اختياراً بمقتضى الآية الكريمة والروايات”(26).
الجهة الثانية: في بيان طبيعة الوجوب: قال (قدِّس سرُّه): ظاهر الآية الكريمة: أحد الاحتمالين الأولين(27)، ويعني بهما التاليين: الاحتمال الأول: “أن دخول الوقت يحتمل أن يكون شرطا لوجوب الصلاة، فيكون وجوبها مشروطا بمجيء الوقت كساير الوجوبات المشروطة”(28).
الاحتمال الثاني: “أن يكون الصلاة الواجبة معلقة على دخول الوقت، فتكون من قبيل الواجبات المعلقة، فيكون الوجوب فعليا متعلقا بأمر استقبالي هي الصلاة في الوقت”(29).
ثمّ قال (قدِّس سرُّه): “والأرجح بينهما، هو: الأول منهما، فإن الأظهر أن يكون قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، متعلقا بالطلب، فيكون الحاصل: تجب الصلاة عند دلوكها، فيكون الوجوب مشروطا، لا بالصلاة حتى يكون الوجوب معلقاً. وأما كونها بصدد بيان الشرطية، لا الحكم التكليفي، فخلاف الظاهر بعد كون الأمر متعلقا بالصلاة أو متعلقاتها، هذا بالنسبة إلى أول الزوال، وأما منه إلى آخر الوقت فسيأتي الكلام فيه”(30).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾(31)، قال (قدِّس سرُّه) إنّ “الحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج، يدفعه السياق والتفريع، وينافي صدر الآية الذي هو ظاهر في علَّية نفس المحيض، الذي هو أذى في وجوب الاعتزال وحرمة القرب”(32)، فترجح بل تّعيّن احتمال الطهر من خلال ظهور صدر الآية.
المبحث الرابع: مثبتات الظهور فهنا أشار (قدِّس سرُّه) إلى عدد من مثبتات الظهور، وسيذكر الباحث أمثلة تطبيقية، سيتبين من خلالها المثبتات التي يرتضيها (قدِّس سرُّه) من غيرها: المثبت الأول: التبادر: والمراد به -كما قال (قدِّس سرُّه): “ظهور المعنى من اللفظ بنفسه من غير قرينة، لا سرعة حصول المعنى في الذهن بالنسبة إلى معنى آخر، أو سبقه عليه”(33).
وذهب (قدِّس سرُّه) إلى أنه “لا إشكال في اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستنداً إلى حاق اللفظ، لا إلى القرينة، ولكنه هل لنا طريق مضبوط إلى إثباته من الاطِّراد وغيره -بأن يقال: أن التبادر من اللفظ مطِّرداً، دليل على كونه مستنداً إلى الوضع- الظاهر عدمه”(34)، ومع شرطه الاطِّراد يكون “التبادر الناشيء من الغلبة غير مفيد”(35) أيضاً.
ويظهر من بعض كلماته (قدِّس سرُّه) أنه يرتضي التبادر كعلامة للحقيقة في البحوث اللغوية، فمن أقواله (قدِّس سرُّه): “وليس شيء أقرب إلى إثبات اللغة من التبادر، ولا سيما عند أهل اللغة والعرف”(36).
وفي إطار تحقيقه لكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ، قال (قدِّس سرُّه): “وبما أن البحث لغوي، يكون الدليل الوحيد في الباب هو التبادر، وما سوى ذلك لا يغني من الحق شيئاً”(37).
وكيف كان فيمكن التمثيل لكلامه (قدِّس سرُّه) في التبادر بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾(38).
قال (قدِّس سرُّه): “وقد يستدلّ لتشخيص المراد من (الصعيد) في الآية التي في المائدة بلفظة ﴿مِّنْهُ﴾، بدعوى أنّ المتبادر منها هو: المسح ببعض الصعيد؛ لظهور رجوع الضمير إليه، وعدم إمكان المسح بجميعه، فلا بدّ من المسح ببعضه، ولا يمكن ذلك إلَّا بإرادة التراب منه؛ لحصول العلوق به، دون الحجر ومثله؛ سواء كان الاستعمال على وجه الحقيقة أو المجاز.
والمقصود في المقام إثبات المطلوب، لا إثبات المعنى الحقيقي.
وفيه: أنّ المحتمل بدواً فيها: كون الضمير راجعاً إلى (الصعيد)، وكون (مِنْ) ابتدائية، وعليه يكون معنى الآية: (تيمّموا واقصدوا صعيداً، فإذا انتهيتم إليه فارجعوا منه إلى مسح الوجوه والأيدي)، فيكون (الصعيد) منتهى المقصود أوّلًا، فإذا انتهى المكلَّف إليه، صار مبدأ الرجوع إلى عمل المسح، فاستفيد منها عدم جواز مسح الوجه واليد على الأرض، وعدم جواز التمرّغ والتمعّك، كما فعل عمّار (رضيَّ الله عنه)، فكأنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) حين قال: هكذا يصنع الحمار(39)، وإنّما قال الله (عزَّ وجلَّ): ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً﴾(40)، أراد تفهيم أنّ المستفاد من الآية خلاف ما فعله.
بل يستفاد منها كون اليد آلة المسح، وطريق الاستفادة أنّه إذا أمر بالمسح بعد الانتهاء إلى المقصد وهو الصعيد، والرجوع منه إلى مسح الوجه والأيدي، يعلم أنّ المسح باليد؛ فإنّها الآلة المتعارفة للعمل، وبهذا يعلم أنّ المسح بباطن الكفّ لكونه الآلة المتعارفة، وبعد كون باطنها آلته يعلم أنّ الممسوح غيره، تأمّل.
نعم لا يستفاد منها أنّ الممسوح ظاهرها.
ولعلّ هذا الوجه بالتقريب المتقدّم، أقوى الوجوه وأنسبها.
ويحتمل أن تكون (مِنْ) تبعيضية، مع رجوع الضمير إلى (الصعيد)، كما يدّعي المدعي، فيكون المعنى: (وامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعض الصعيد)، فحينئذٍ لا يتضح من الآية أنّ آلة المسح اليد؛ لإمكان أن تكون الآلة نفس بعضه؛ بأن يرفع حجراً أو مدراً ويمسح به، أو يضع وجهه على الصعيد ويمسحه به؛ لصدق مسح وجهه ببعض الصعيد، بل لمّا كان بعض الصعيد هو الصعيد؛ لصدق الجنس على الكثير والقليل بنحو واحد، فكأنه قال: (امسحوا بوجوهكم وأيديكم الصعيد)، فيكون الصعيد آلة المسح أو الممسوح، والماسحُ الوجه، فيكون مناسباً لما صنع عمّار، لكنّه تخيّل أنّ ما هو بدل الوضوء، عبارة عن وضع الوجه والأيدي على الأرض، وما هو بدل الغسل بالمناسبة المرتكزة في ذهنه عبارة عن مسح جميع البدن بالتراب، كما يغسل بالماء.
وهذا الاحتمال مع بعده لأنّ لازمه اعتبار زائد في الصعيد حتّى يخرجه عن المعنى الجنسي الشامل للقليل والكثير بنحو واحد؛ وهو لحاظه مجموعاً ذا أبعاض، وهو خلاف الظاهر، ولأنّ الأصل في “من” الابتدائية، على ما قالوا، والاستعمال في غيرها بضرب من التأويل، ولأنّ ذكر المسح ببعضه غير محتاج إليه بعد عدم إمكانه بجميع ما يصدق عليه الصعيد، بل غير محتاج إليه مع الإمكان أيضاً؛ لأنّ طبيعة المسح توجد بأوّل مصداقه عرفاً، والفرض أنّ (الصعيد) اسم جنس صادق على الكلّ، وبعضه لا يثبت مدعاهم؛ وهو كون المراد من (الصعيد) هو التراب: أمّا أوّلا: فلما عرفت من عدم دليل في ظاهر الآية على أنّ الماسح الكفّ، بل يمكن أن يكون نفس الصعيد برفع بعضه إلى الوجه، وهو يشعر بخلاف مطلوبهم، وأن يكون المراد مسح الوجه على الأرض، نظير ما صنع عمّار.
والمنظور الآن هو النظر في نفس الآية، لا الأدلَّة الخارجيّة والمرتكزات الحاصلة من معهودية كيفية التيمّم، وإلَّا يكون مطلوبهم واضح البطلان، كما يأتي التنبيه عليه.
وأمّا ثانياً: فلأنّ وجه الأرض لا ينحصر بالتراب والحجر حتّى يثبت مطلوبهم، بل كثير من الأراضي يكون لها علوق مع عدم كونها تراباً، كالجصّ والنورة والرمل، بل والحجر المسحوق وغيرها.
ويحتمل أن تكون (مِنْ) للتأكيد، كقوله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾(41).
وقوله: ﴿وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾(42)، فيكون المعنى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الصعيد، وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب من الاحتمال المتقدّم لعدم لزوم التصرّف في “الصعيد”، بما مرّ من لزومه على ذاك الاحتمال، فلا أقلّ من مساواته معه، ويأتي فيه ما مرّ آنفاً في فرض ذاك الاحتمال.
وما قيل: (إنّ مجيء الحرف للتأكيد خلاف الظاهر، والأصل أن تستعمل في معنى من المعاني)، غير مسلَّم إذا كان سائر المعاني خلاف ما وضع له، كما يظهر منهم هاهنا من أنّ الأصل فيها الابتدائية، بل عن السيّد: “أنّ كلمة “من” ابتدائيّة، وأنّ جميع النحويّين من البصريّين منعوا ورود “من” لغير الابتداء.
نعم، لو ثبت اشتراكها بين المعاني المذكورة لها، يكون المجيء للتأكيد خلاف الأصل، لكنّه غير معلوم.
ويحتمل أن تكون بدلية، مع رجوع الضمير إلى (الماء)، وهذا الاحتمال أيضاً لا يقصر من احتمال كونها تبعيضية. ويحتمل أن تكون ابتدائية، والضمير راجعاً إلى (التيمّم).
وأن تكون سببية، والضمير راجعاً إلى الحدث المستفاد من سوق الآية. أو يكون مساقها مساق قوله: (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي بعضها أقرب من التبعيضية أو مساوٍ لها”(43).
المثبت الثاني: صحة السلب: قال (قدِّس سرُّه): “والظاهر أن المراد به صحته عند نفسه لا عند غيره، إذ الثاني يرجع إلى تنصيص أهل اللغة واللسان.
وصحته عند نفسه فالتحقيق أنّ الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق على سلبه، فيكون إسناده إلى سلبه في غير محله”(44).
وقال (قدِّس سرُّه): “إنّ صحة السلب لا تصلح لأن تكون علامة الحقيقة”(45). المثبت الثالث: قول اللغوي: تبناه البعض، غير أنّ الإمام (قدِّس سرُّه) قد ذهبَ إلى أنّ “اللغويَّ مرجعٌ في موارد الاستعمال لا في تشخيص الحقايق عن المجاز”(46)، وقال بأنه “لم يُحرَز رجوع الناس إلى صناعة اللغة في زمن الأئمة (عليهم السلام) بحيث كان الرجوع إليهم كالرجوع إلى الطبيب”(47).
وأنّ الصحابة “لم يثبت رجوعهم إلى مثل ابن عباس وغيره في لغة القران ومفرداته، بل الظاهر رجوعهم إلى مثله في تفسير القرآن المدخر عنده من أصحاب الوحي، وصرف تدوين اللغة في عصر الأئمة (عليهم السلام) لا يدل على أخذ الناس اللغة بصرف التقليد كالرجوع إلى الطبيب والفقيه(48).
نعم الرجوع إلى كتب اللغة ربما يوجب تشخيص المعنى بمناسبة ساير الجمل، كما في رجوعنا إليها، فصرف تدوين اللغة والرجوع إليها في تلك الأعصار لا يفيد شيئاً”(49).
وكمثال تطبيقي يمكن الإشارة إلى الاستدلال الذي ذكر لآيتين كريمتين على كفاية مطلق وجه الأرض، أولاهما: قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾(50).
وثانيتهما: قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾(51)، وهذه الآية عين الموجودة في سورة النساء مع زيادة لفظة: ﴿مِّنْهُ﴾ بعد ﴿وَأَيْدِيكُم﴾.
قال (قدِّس سرُّه): “وقد اختلفت كلمة أهل اللغة والعربية في معنى (الصعيد)، فعن (العين) و(المحيط)، و(الأساس)، و(المفردات) للراغب، وجمع آخر: (أنّه وجه الأرض)، بل عن الزجّاج: (أنّه لا يعلم اختلافاً بين أهل اللغة).
وعن (المعتبر) حكايته عن فضلاء أهل اللغة. وعن (البحار): أنّ الصعيد يتناول الحجر، كما صرّح به أئمّة اللغة والتفسير. وعن (الوسيلة): قد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض وادّعى بعضهم الإجماع عليه.
واستدلّ بعضهم بكونه وجه الأرض بقوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً﴾. وقول النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): «يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً على صعيد واحد»(52)، أي: أرض واحدة؛ لعدم تناسب التراب.
وعن جمع من أهل اللغة: “أنّه التراب”، “الصحاح” والأصمعي وأبي عبيدة، بل عن ظاهر “القاموس”، وبني الأعرابي وعبّاس وفارس، بل عن السيّد حكايته عن أهل اللغة.
ويظهر من بعضهم: الاشتراك اللفظي بين التراب الخالص ومطلق وجه الأرض، بل والطريق لا نبات فيه، قال في “مجمع البحرين”: “والصعيد: التراب الخالص الذي لا يخالطه سَبَخ ولا رمل، نقلًا عن “الجمهرة”. والصعيد أيضاً: وجه الأرض تراباً كان أو غيره، وهو قول الزجّاج.. حتّى قال: لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك، فيشمل الحجر والمدر ونحوهما. والصعيد أيضاً: الطريق لا نبات فيها.
قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أنّ “الصعيد” في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾، هو التراب الطاهر الذي على وجه الأرض، أو خرج من باطنها”، انتهى ما في “المجمع”، بل في “المنجد”: “الصعيد: التراب، القبر، الطريق، ما ارتفع من الأرض”.
وما قيل: “إنّ الاشتراك اللفظي كذلك أي بين مطلق وجه الأرض والتراب بعيد، بل إذا دار الأمر بين اللفظي والمعنوي يقدّم الثاني”، ناشيء من تخيّل أنّ وقوع الاشتراك اللفظي في الألسن من واضع واحد أو طائفة واحدة، لكن الظاهر أنّ الاشتراك حاصل من ضمّ الطوائف بعضها إلى بعض، واختلاط اللغات، كاختلاط لغة العرب بالعجم؛ لأجل سلطة الأعراب واختلاطهم مع غيرهم، فربّما نسي بعض اللغات من إحدى الطائفتين، وقامت اللغة الأُخرى مقامه، وربّما بقيت اللغتان، فبقي لمعنىً واحد لفظان أو أكثر من اختلاط الطوائف، فيظنّ من ذلك الاشتراك اللفظي البعيد أو المرجوح.
وكيف كان: لا يمكن لنا الاتكال في معنى “الصعيد” على قول أهل اللغة مع هذا الاختلاف الفاحش بينهم؛ فإنّ حجّية قولهم إمّا لحجّية قول أهل الخبرة، فمع اختلافهم وتعارض أقوالهم تسقط عنها، أو للاطمئنان والوثوق منه، فلا يحصل معه.
ودعوى الزجّاج عدم الاختلاف بين أهل اللغة، يردّها قول من عرفت من كونه التراب الخالص، أو الاشتراك بينه وبين غيره”(53).
المثبت الرابع: أصالة الحقيقة: وهي الأصل الذي يعتمده العقلاء لتنقيح الظهور عند الشّك في المراد، “والسرّ في ذلك: هو أن أصالة الحقيقة من الأصول المرادية، وهي جارية في مورد الشّك في المراد، لا في إحراز المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد”(54)، ويمكن التمثيل لذلك بما قاله (قدِّس سرُّه) في الرد على من استدل لتحديد معنى كلمة “الصعيد” بأصالة الحقيقة: “كما أنّ الاستدلال على كونه مطلق وجه الأرض بقول الله تعالى: ﴿صَعِيداً زَلَقاً﴾(55).
وقول النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) في النبوي المتقدّم(56)، في غير محلَّه؛ لعدم جريان أصالة الحقيقة مع معلوميّة المراد والشكّ في الوضع، وإنّما هي حجّة في تشخيص المراد بعد العلم بالوضع”(57).
المثبت الخامس: الانصراف: لم يجد الكاتب تعريفاً محدداً للانصراف عنده (قدِّس سرُّه)، غير أنه يمكن استخلاص هذا التعريف من كلماته، بأن يقال: هو عبارة عن انقداح قسم من أقسام الطبيعة إلى الذهن من اللفظ، رغم اتساع المدلول الوضعي للفظ لأكثر مما هو المنسبق منه، وذلك نتيجة تكثر استعماله فيه، وأنس الذهن به.
قال (قدِّس سرُّه): إنّ “الانصراف لا يوجب استعمال الكلي في الجزئي حتى يخالف الظاهر، بل يوجب تعيين الإرادة الجدية بتعدّد الدال والمدلول”(58)، والانصراف يعيّن الإرداة الجدية، “بعد استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية، نظير قوله: “هذا الإنسان كذا”، مشيراً إلى زيد، فإنَّ لفظ “الإنسان” لم يستعمل في زيد، بل استعمل في معناه، والإشارة تفيد الانطباق وتعيّن الإرادة الجدية”(59).
ومن خلال كلمات الإمام (قدِّس سرُّه)، يمكن بالآتي تحديد نوع الانصراف الذي يوجب انسلاب الظهور عن الإطلاق واستقراره في الأفراد أو الحصص المنصرف إليها: أولاً: أن يكون الانصراف موجباً لنشوء علاقة بين اللفظ وبين الأفراد أو الحصص المنصرف إليها، بحيث لا يبقى اللفظ الدال على الطبيعة محتفظاً بصلاحيته للدلالة عليها، ولذا قال (قدِّس سرُّه): “أنّ كثرة أفراد في قسم لا توجب الانصراف، فإنّ الإطلاق عبارة عن الحكم على طبيعة من غير قيد، فلا بدّ في دعوى الانصراف من دعوى كون الكثرة والتعارف وأنس الذهن بوجه تصير كقيد حاف بالطبيعة”(60)، “فلو سلم إمكان دعوى الانصراف، فلا بدّ وأن يكون في مورد يكثر استعماله فيه؛ بحيث يوجب أُنس الذهن به؛ بحيث يوجب انقلاب الذهن وتوجّهه إليه متى انقدح في ذهنه ذلك اللفظ، ويكون المعنى مغفولاً عنه ومهجوراً”(61).
ثانياً: أن يكون الانصراف وفق الميزان، وقد حدد (قدِّس سرُّه) هذا الميزان بقوله: “أنّ الميزان: الانصراف في زمان الصّدور”(62)، فمن أحرز ما تُعورف عليه في زمان الصدور أوجب الانصراف عن الاطلاق إلى ما انصرف إليه.
ويمكن التمثيل لمسألة الانصراف بمثالين: المثال الأول: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً﴾(63)، فقد قال (قدِّس سرُّه) -في الرد على من استدل لتحديد معنى كلمة (الصعيد) بالانصراف إلى الفرد الغالب-: و”دعوى الانصراف إلى التراب الخالص لكونه الفرد الغالب الشائع، في غير محلَّها، لمنع تحقّق الشيوع الموجب له”(64).
والإمام (قدِّس سرُّه) في هذه المثال وإن لم يقبل نفي الظهور في الاطلاق بالانصراف، باعتبار عدم تحقق الشياع الموجب للانصراف، إلاّ أن المثال بيّن في دور الانصراف في الظهور نفياً أو إثباتاً، وأنّ هناك من تبناه في المقام، وهو أمر ينبه إلى عدم بساطة المسألة.
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً﴾(65)، فقد وقع كلام في انتفاء الغيبة عند رضى المغتاب باحتمالية انصراف الأدلة عما إذا رضي المغتاب أو لم يكرهه، فردّ (قدِّس سرُّه) هذا الاحتمال -بدليل ذكره-، ووصفه بالوهن والضعف، ومما قال: “وبالجملة: دعوى الانصراف لا وجه لها.
وقلة الوجود لا توجب الانصراف، بل المناسبات تقتضي قوة الاطلاق. والانصاف أن رفع اليد عن إطلاق الآيات والروايات والتشديدات والاهتمامات الواردة في حرمة غيبة المؤمن، وإذاعة سره، وهتكه، وتعييبه، وغير ذلك، غير ممكن، فالأظهر الأقوى عدم اعتبار هذا القيد”(66).
المبحث الخامس: عوامل تشخيص الظهور وفي البدء يمكن القول بأنّ تعيين الظهور ليست مسألة سهلة، بل قد زلت فيها أقدام الكثيرين، لأنّ “الظهور الكلامي ربما لا يكون كظهور مفرداته عند الوضع، فإنّ مراد المتكلم يفهم من صدر كلامه وذيله، وربما يكون الصدر قرينة للذيل، وربما يكون بالعكس، ولذا نفهم من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾(67): أنّ المراد بالكلام هو التلفظ بإيجاد الصوت في الشجرة، لظهوره كذلك.
ونفهم من قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً﴾(68): أنّ المراد بها هو جهة مبرزية الكلام، ولذا يصدق على المسيح (عليه السلام) أنه كلمة منه.
وإذا كان الكلام في أمر نبع الماء وسفينة نوح في قوله تعالى: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا -ثمّ ورود قوله تعالى:- وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾(69)، فلا مجال لتوهم أنّ الغرق يكون في بحر المحبة والرحمة، وتوهم أنّ ما ورد من الوعيد بالنار من الآيات المباركات، يكون المراد منها نار العشق، بصرف إطلاق النار عليه أيضاً حقيقة أو مجازاً كما يزعم من خرج عن قانون المحاورة والعقلاء، ويدعي من عند نفسه أنّ له لغة مختصة به، فإنّ المتكلم بالعربية لا بدّ أن يلاحظ وضع لغة العرب، وفهم عامة العقلاء الظهور من اللفظ، لا أن يدعي من قبل نفسه أن ّمعنى هذه اللغة هكذا، أو ظهور العبارة كذا، وأنا أفهم لا غيري”(70).
و”الحاصل إذا كان للفظ معنى ظاهر، فنتبعه، وإن كان معناه متشابهاً، فنذره في سنبله، ليبينه معصوم عالم بمعاني الألفاظ في ساير العوالم، فإنّ القرآن الشريف الَّذي هو أفصح كلام وأبلغه، ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾(71).
فإن كان في وسع المخاطب بيان مطلب من المطالب العالية فيبينون له وإلا فيسكتون وهم المعصومون (صلوات اللَّه عليهم أجمعين).
فمن باب المثال فارجع في تفسير ﴿ن﴾ في سورة القلم(72)، وانظر إلى الروايات في تفسير نور الثقلين وغيره، فإنّ كلمة ﴿ن﴾ فسِّرت في كلام المعصوم (عليه السلام): بأنه نهر في الجنة أو أنها لوح من نور، فإنّ هذه الكلمة حيث لا يكون لها ظهور يفهمه كل أحد، بل لا ظهور له بحسب الوضع اللغوي في لسان العرب، ويكون معناه في غير هذا العالم، لا بدّ أن يتبع وضع اللَّه تعالى هذا اللفظ لذاك المعنى، ولا طريق للبشر إلى فهم معناه بهذا النحو إلاّ بإخبار معصوم”(73).
وإليك ذكر عوامل تشخيص الظهور، لتصون التشخيص من الزلل: العامل الأول: مباحث الأوضاع اللغوية: قال الإمام (قدِّس سرُّه): “أكثر ما يبحث عنه في مباحث الألفاظ يرجع إلى تشخيص الظاهر”(74)، وذلك مثل ما يبحث فيه عن الأوضاع اللغوية، كدلالة هيئة (الأمر) على الوجوب، وهيئة (النهي) على الحرمة، ودلالة أداة «العموم» على معانيها، ودلالة (الحصر) على مدلولها، وكمداليل المفردات والمركبات، وكلفظة (كل) و(جميع) للاستغراق، ولفظة (ما)…(إلاّ) و(إنّما) للحصر، ولفظة (لا) لنفي الجنس، إلى غير ذلك من المباحث المدرجة في مباحث الألفاظ، ونتيجتها هو: “تعيين ظهور الألفاظ فيما يذكر لها من المعاني”(75)، لـ”فهم كلام الشّارع؛ لتعيين وظيفة العباد”(76).
ويمكن التمثيل للأوضاع اللغوية بقوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾(77).
قال الإمام (قدِّس سرُّه): “فالظاهر منها أنّ لكلّ رجل نصيباً، وأنّ لكلّ امرأة كذلك؛ لظهور الجمع المحلّى في الكثرة الأفراديّة، في قبال العامّ المجموعي، ولا تعرّض فيها لمقدار النصيب، بل هي في مقام بيان عدم حرمان الرجال ولا النساء، ولعلّه للردّ على الجهّال الذين يقولون: بحرمان النساء، أو يحرّمونهن عملاً”(78).
العامل الثاني: القرائن: ويمكن التمثيل بالقرائن الآتية: القرينة الأولى: اللفظية المتصلة: وذلك كما في الأمثلة الآتية: المثال الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾(79)، فربما يتوهم إمكان استنقاذ الكلية من الموارد الجزئية، فيقُال بإن تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها، يدلّ على حرمة جميع الانتفاعات.
ونحوها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾(80). قال الإمام (قدِّس سرُّه) في الرد على من قال بحرمة مطلق الانتفاع من الأمور التي ذكرت في الآية: “فيه منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة، فضلا عن الإسراء إلى غيرها، أما الآيتان فلقرائن فيهما وفيما قبلهما وبعدهما، تدل على أن المراد بتحريم العناوين تحريم أكلها:
منها: ذكر لحم الخنزير للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغير لحمه، وعدم الجواز في الميتة.
ومنها: عدم ذكر الكلب، لعدم كونه مما يتعارف أكله.
ومنها: استثناء الاضطرار في المجاعة، فإن المراد منه جواز أكلها في المخمصة.
ومنها: قوله تعالى: -قبل الآية الثانية-: ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(81).
وتعقيب الأولى بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾(82). وقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾(83).
فاحتفافهما بما ذكر، يوجب ظهورهما في إرادة الأكل، لا الانتفاعات الأخر، مع أن الشايع من المنافع منها، سيما الدم ولحم الخنزير هو الأكل”(84).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(85).
قال (قدِّس سرُّه): “لا شبهة في أن الأصل الأولي، (كأصالتي الحل والإباحة)، و(عموم خلق ما في الأرض جميعا لنا)، جواز الانتفاع بكل شيء، من كل وجه، إلاّ ما قام الدليل على التحريم، وقد ادعي الأصل الثانوي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة وبالمتنجسات مستدلا بالكتاب”(86)، والآية الآنفة من الأدلة التي ذكرت “بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس، وأنّ وجوب الاجتناب عن المذكورات لانسلاكها فيه، أما حقيقة كالخمر، أو ادعاء كغيرها، وأنّ الرجس هو النجس المعهود، ووجوب الاجتناب عن الشيء يقتضي عدم الانتفاع بشيء منه، وإلاّ لم يناسب التعبير بالاجتناب والتباعد عنه، فتدل على حرمة الانتفاع مطلقا عن كل رجس ونجس”(87).
ولكن الإمام (قدِّس سرُّه) يرد هذا الكلام ويقول: “فيه: أولاً: ممنوعية رجوع الضمير إلى الـ﴿رِجْسٌ﴾، إذ من المحتمل رجوعه إلى ﴿عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، بل لعله الأنسب في مقام التأكيد عن لزوم التجنب عن المذكورات، ولو سلم رجوعه إليه، لا يسلم الرجوع إليه مطلقا، بل مع قيد كونه ﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، وإلاّ فلو كانت علة وجوب الاجتناب كون الشيء رجساً، لم يكن ذكرُ عملِ الشيطان مناسباً.
والرجوع إلى كل منهما مستقلاً لو فرض إمكانه، خلاف الظاهر، فيمكن أن يقال: -بعد رجوع الضمير إلى الرجس الذي من عمل الشيطان-أنّ الرجس على نوعين: ما هو من عمله يجب الاجتناب عنه.
وما ليس كذلك لا يجب. فتدل أو تشعر على جواز الانتفاع في الجملة بالنجاسات.
وثانيا: أن الظاهر منها، ولو بمناسبة قوله: ﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، وبقرينة قوله متصلا به: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ﴾(88).
إن شرب الخمر والمقامرة وعبادة الأوثان رجس من عمله، لا بنحو المجاز في الحذف، بل بادعاء أن لا خاصية للخمر إلا شربها، و لا للميسر إلا اللعب، إذا كان المراد به آلاته، وأما إن كان المراد اللعب بالآلة فلا دعوى فيه، ويكون قرينة على أن المراد بالخمر أيضا شربه، وبالأنصاب عبادتها، بنحو ما مر من الدعوى، فإن ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما هو بشرب الخمر والمقامرة، وإمساكها للتخليل ليس من عمل الشيطان، ولا آلة له لإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، هذا مع أن في كون الرجس بمعنى النجس المعهود إشكالاً، فإنه -على ما في كتب اللغة- جاء بمعان: منها: العمل القبيح، فدار الأمر بين حمله على الرجس بمعنى القذر المعهود، وارتكاب التجوز في الآية زائداً على الدعوى المتقدمة، أو حمله على القبيح وحفظ ظهورها من هذه الحيثية، والثاني أولى.
مع أن في تنـزيل عبادة الأوثان -التي هي كفر بالله العظيم- منـزلة القذارة، أو تنـزيل نفسها منزلتها –أي: منـزلة القذارة الصورية في وجوب الاجتناب-، ما لا يخفى من الوهن، فإنه من تنـزيل العظيم منـزلة الحقير في مورد يقتضي التعظيم، (تأمل)”(89).
المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾(90)، فقد قال (قدِّس سرُّه): “أنّ هذه الآية تدلّ على قول المشهور من جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها، ولا يجب عليها الغسل للوطء، “سواء في ذلك قراءة التخفيف والتضعيف: أمّا الأُولى -أي: دلالة قراءة التخفيف- فظاهر؛ ضرورة أنّ صدر الآية يدلّ على أنّ وجوب الاعتزال، متفرّع على الأذى، وأنّ المحيض بما أنّه أذى صار سبباً لإيجابه.
وقوله: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ﴾ ظاهر في كونه بياناً لقوله: ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء﴾ لا لأمر آخر غير مربوط بالحيض والأذى، فكأنّه قال: (إنّ المحيض لمّا كان أذى فاعتزلوهنّ ولا تقربوهنّ حتّى يرتفع الأذى ويطهرن من الطمث).
وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ تفريع على ذلك، وليس مطلباً مستأنفاً مستقلا؛ بشهادة فاء التفريع والفهم العرفي، فيكون معناه: (إذا صرن طاهرات على أحد معاني باب التفعّل).
والحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج، يدفعه السياق والتفريع، وينافي صدر الآية الذي هو ظاهر في علَّية نفس المحيض، الذي هو أذى في وجوب الاعتزال وحرمة القرب.
وما قيل: (من أنّ التطهّر فعل اختياري، ويشهد به ذيل الآية؛ لأنّ تعلَّق الحبّ إنّما هو بفعل اختياري)، في غير محلَّه إن أُريد ظهوره في ذلك؛ ضرورة أنّ لصيغة «التفعّل» معاني وموارد للاستعمال: بعضها مشهور، وبعضها غير مشهور، كالمجيء للصيرورة، نحو: (تأيّمت المرأة)، أي: صارت أيّماً أو للانتساب، نحو: «تبدّى»، أي: انتسب إلى البادية.
والظاهر في المقام بمناسبة التفريع على ما سبق -وبما أنّ الظاهر من الآية، أنّ المحيض هو: تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القرب- هو: كونه بمعنى الصيرورة.
ودعوى عدم تعلَّق الحبّ إلَّا بالفعل الاختياري، غير وجيهة، كما ورد: «إنّ الله جميل يحبّ الجمال»(91)، ولا إشكال في تعلَّق الحبّ بأُمور غير اختيارية إلى ما شاء الله.
وأغرب من ذلك، دعوى كون (الطهر) حقيقة شرعية في الطهارات الثلاث!! ضرورة أنّ استعمال (الطهر) في المقابل (للطمث) شائع لغة وعرفاً، وفي الأخبار المتظافرة، فاختصاصه بها على فرض تسليم الحقيقة الشرعية ممنوع.
كما أنّ حصول الحقيقة الشرعيّة عند نزول الآية ممنوع.
وتقدّم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية، لا يخلو من منع. وبالجملة: من تأمّل الآية الكريمة وخصوصياتها صدراً وذيلًا، لا يشكّ في أنّ المراد من (الطهر) و(التطهّر) هو زوال الأذى الذي هو المحيض.
وممّا ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة التضعيف؛ فإنّ صدر الآية – كما عرفت- ظاهر في أنّ المحيض الذي هو أذى، موجب لوجوب الاعتزال، ومعه تكون الغاية لرفعه، هو: ارتفاع الأذى، فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعاني لباب «التفعّل» وهو الصيرورة، وليس في هذا ارتكاب خلاف ظاهر بوجه.
ولا يمكن العكس بحمل (التطهّر) على الاغتسال، ورفع اليد عن ظهور الصدر؛ لأنّ حمله عليه بلا قرينة، بل مع القرينة على ضدّه، غير جائز.
ويلزم منه حمل صدر الآية على خلاف ظاهره؛ ضرورة أنّه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال، لا يكون المحيض الذي هو أذى سبباً لوجوب الاعتزال، بل لا بدّ وأن يكون حدث الحيض ممّا هو باقٍ بعد رفعه سبباً له.
مع أنّه خلافُ ظاهرٍ بارد بلا قرينة وشاهد.
وبالجملة: دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر وقرينيته لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك، وبين حملِ اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا قرينة، ورفعِ اليد عن ظاهر آخر بلا وجه.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة؛ بعد ملاحظة الصدر والذيل وقرينية بعض الكلام المبارك على بعض، وعليه فلا مجال للدعاوي التي في الباب”(92).
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف: قال الإمام (قدِّس سرُّه): “ثمّ إنّه لو فرضنا تواتر القراءات والإجماع على وجوب العمل بكلّ قراءة، وقع التعارض ظاهراً بين القراءتين.
ولكنّ التأمّل فيما أسلفناه، يقضي بالجمع العقلائي بينهما بحمل (التطهّر) على الطهر بعد الحيض؛ فإنّ رفعَ اليد عن ظهور (التطهّر) في الفعل الاختياري -على فرض تسليمه، وحفظَ ظهور الصدر الدالّ على أنّ المحيض بما هو أذى، علَّة أو موضوع لحرمة الوطء ووجوب الاعتزال-، أهون من رفع اليد عن الظهور السياقي (للطهر) في كونه مقابل الحيض، وعن الظهور القوي للصدر المشعر بالعلَّية أو الظاهر فيها؛ فإنّ الغاية إذا كانت هي الاغتسال، فلا بدّ أن تكون العلَّةُ أو الموضوعُ حدثَ الحيض، لا الحيض الذي أُخذ في الآية موضوعاً.
بل لا بدّ وأن يحمل (الأذى) على التعبّدي، لا العرفي المعلوم للعقلاء، وكلّ ذلك خلاف الظاهر، وارتكابه بعيد. وأمّا حمل (التطهّر) على صيرورتها طاهرة، فغير بعيد بعد قضاء مناسبة الحكم والموضوع له”(93).
القرينة الثانية: اللفظية المنفصلة: ويمكن التمثيل بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾(94)، ففي إطارها قال الإمام (قدِّس سرُّه): “إمكان دعوى ظهور الآية الكريمة في الركون إلى ولاة الجور؛ فإنّ قوله تعالى: ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾(95)، سياقه يشهد بأنّ الركون إليه أمر عظيم، ومن الكبائر، وذو مفسدة عظيمة؛ حيث أوعد عليه بالنار، وعدم الأولياء والناصر لهم.
وهذا يناسب الركون إليهم؛ حيث ورد فيهم وفي إعانتهم ما ورد في الأخبار، لا الركون والميل إلى فاسق، كان سبب فسقه عدم ردّ السلام الواجب، أو إصراره عليه؛ فإنّ نفس ارتكاب كثير من المحرّمات لم يرد فيها نحو ما في الآية. ويشهد له: عدم احتمال المفسّرين هذا المعنى الأعمّ.
وفي (المجمع): روي عنهم (عليهم السلام): «إنّ الركون: المودّة، والنصيحة، والطاعة»(96).
ومعلوم أنّ ذلك في ولاة الجور والظلمة. وفي رواية الحسين بن زيد في مناهي النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): أنّه تمسّك بالآية في خلال ما قال في حقّ من تولّى خصومة ظالم، أو أعان عليها، ومن مدح سلطاناً جائراً، ومن ولّى جائراً على جور(97).
وفي رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في عدّ الكبائر: «ومعونة الظالمين، والركون إليهم»(98).
وفي رواية الأعمش في عدّها: «وترك معاونة المظلومين، والركون إلى الظالمين»(99). مضافاً إلى أنّ الظالم -عرفاً- هو الذي ظلم غيره، والفاسق ليس ظالماً عرفاً”(100).
القرينة الثالثة: اللبيّة: ويمكن التمثيل لها بالآتي: المثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾(101).
قال (قدِّس سرُّه): “وأمّا مالكيّة التصرّف والأولويّة من كلّ أحد، فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء، بل يرى العقلاء أنّه تعالى أولى بالتصرّف في كلّ مال ونفس وإن كانت ماهيّة الأولويّة أمراً اعتباريّاً، لكنّها اعتبار معقول واقع من العقلاء.
فقوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ معناه أنّه تعالى وليّ أمره، فحينئذ إن حمل قوله تعالى: ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ على ولاية التصرّف، فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقلاء، ولا بحسب ظواهر الأدلّة ولوازمها.
وتؤكّده وحدة السياق؛ ضرورة أنّ التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلى دلالة”(102).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾(103).. قال الإمام (قدِّس سرُّه): “والظاهر من ﴿مِّمَّا تَرَكَ﴾ هو ما بقي بعد موت المورّث، فلا يصدق ذلك إلاّ على ما له بقاء ولو اعتباراً، وذلك مثل: الدين على عهدة المدين، وكالكلّي في الذمّة. وهذا بخلاف الحقوق، فإنّها مع عدم الطرف، لا يعقل بقاؤها ولو اعتباراً”(104).
و”المراد -ولو بمساعدة فهم العرف في باب التوريث، حيث إنّه أمر عرفي ليس من مخترعات الشرع- أنّه ينتقل إلى الوارث، ما يكون الموت موجباً لانقطاعه عنه؛ أي الموت موجب للنقل، لا أنّ الإرث ملك بحكم الشرع بقي بلا مالك، بعد ما ترك الشيء بموته، حتّى يرجع إلى عدم تلقّي الورثة من مورّثهم؛ ممّا هو خلاف الضرورة عرفاً وشرعاً.
فالموت سبب للنقل، ملكاً كان، أو حقّاً كالبيع والصلح، ومعنى: «ما تركه الميت فلوارثه»، أي: ما انقطعت إضافته عنه، لا يبقى بلا مالك، بل مالكه الوارث.
وبعبارة أُخرى: إنّ المراد بهذه الآية وأشباهها -ولو بالقرائن العقلائيّة، وفهم العرف- هو أنّ ما كان للميّت حال الحياة، يكون لوارثه بعد موته، فالموت ليس سبباً لسلب الحقّ وإعدامه، بل سبب لنقله إلى الورثة، فيصدق: (أنّ الميّت ترك لوارثه ما كان له)، لا (أنّه ترك المال بلا إضافة، ثمّ أُضيف إلى الوارث)، فإنّه مخالف للضرورة.
فالحقوق كالأعيان المملوكة، تنتقل بنفس الموت، وتكون من متروكات الميّت، بل لها بقاء وإن تبادلت الإضافات، ولا تصير معدومة في حال.
والشاهد على ذلك -بعد عرفيّة المسألة، وعدم اختصاص الإرث عند العرف بالأعيان، بل يكون ثابتاً في مثل حقّ التحجير وسائر الحقوق، إلاّ ما دلّ الدليل على خلافه-: النبوي المعروف الذي يقال فيه: إنّه مجبور بعمل الأصحاب، حيث نصّ فيه: على أنّ الحقّ ممّا ترك، فلا بدّ وأن لا يكون المراد من ما تَرَكَ، ما بقي بعد الموت وله وجود بقائي مع عدم الإضافة.
بل يكون المراد منه: أنّ ما للميّت من الحقّ، فهو لوارثه عند انقطاع إضافته عنه، وهو عبارة أُخرى عن نقل ما للميّت إلى الورثة”(105).
المبحث السادس: شروط العمل بالظهورات في كتاب الله تعالى الشرط الأول: الاجتهاد العلمي للمسائل الدخيلة في تشخيص الظهور: باعتبار أن العمل بالظهور قد يختلف فيه للاختلاف في طبيعة المبنى العلمي، مما يعني ضرورة إعداد الرأي العلمي المسبق، ليدور فهم الظهور مداره، ويمكن التمثيل بالاختلاف فيما وضعت له الـ(لام)، وكيف أن ذلك يؤدّي إلى الاختلاف في فهم المراد، فقد قال الإمام (قدِّس سرُّه) في الرّد على من تخيّل أن (اللام) موضوعة للملك: أنّ هذا “في غير محلّه؛ فإنه مضافاً إلى منع ذلك، بل (اللام) لا يستفاد منها إلاّ نحو اختصاص، وأكثر استعمالها في الكتاب في غير الملك، بل استعمالها في الملك لم يثبت، بعد كونها بمعنى الاختصاص، كما هو مقتضى استعمالها فيه بلا تأوّل، وللملك أيضاً نحو اختصاص، ولعلّها لذلك استعملت فيه، فتأمل مع كثرة الاستعمال في غير الملك، لا يبقى لها ظهور فيه”(106).
الشرط الثاني: التأني في دراسة طبيعة الظهور: -وهذا أحد دواعي قراءة تجربة ممارسة الإمام (قدِّس سرُّه) في استعماله الظهورات كما تقدمت الإشارة إليه-، ويمكن التمثيل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾(107)، لبيان الظهورات البدوية فيها، ومن ثمّ العدول عنها، ليتضح للقارئ بأنّ التّعرف على الظاهر، عملية ليست يسيرة، بل تتطلب دراية وعناية وتدبراً.
قال الإمام (قدِّس سرُّه): “إنّ الظاهر من (الوفاء)، هو: العمل على طبق مقتضى العقد وافياً، كما يظهر من موارد استعمالاته، مثل: الوفاء بالنذر، والعهد، واليمين. والظاهر البدوي من وجوبه، هو: الوجوب الشرعي، ولازمه تحقّق تكليفين -في مثل البيع- بعد تحقّقه: أحدهما: وجوب الوفاء بعنوانه. وثانيهما: حرمة حبس مال الغير أو غصبه.
وفي الثمن إذا كان كلّياً: وجوب أداء الدين، ووجوب الوفاء بالعقد، والالتزام به مشكل جدّاً. فيدور الأمر بين الأخذ بعموم (العقود) ورفع اليد عن ظهور الوجوب في كونه شرعيّاً -فيحمل ذلك على نحو الالتزامات العقلائيّة- وبين رفع اليد عن العموم، وحمله على العقود العهديّة التي ليس فيها إلاّ التعهّد بعمل، نحو عقد الولاية، والتعهّدات العقديّة المتعارفة بين الدول والأشخاص.
بل ربّما يقال: إنّ المراد بـ(العقود) هاهنا، هي: العهود التي وقعت في عقد الولاية، والجمع باعتبار أنّ العقد كان متعدّداً بتعدّد الأشخاص، أو بتعدّد الواقعة.
وتشهد له رواية ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾(108)، قال: «إنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، عقد عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن، ثمّ أنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾(109)، التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين»(110). وتؤيّدها صحيحة ابن سنان المتقدّمة(111)، وكون الآية في سورة المائدة المشتملة على آية تبليغ الولاية.
لكنّه غير مرضيّ بعد عموم الآية، وتمسّك الأصحاب خلفاً عن سلف بها، وعدم دلالة الروايتين على الانحصار، وعدم جواز الاتكال على مثل تلك التأييدات.
على أنّه لو نزلت الآية الكريمة في خصوص عهد الولاية، لصار شائعاً؛ لكثرة الدواعي على ذلك، فإبقاء ﴿الْعُقُودِ﴾ على ظهورها وعمومها، ورفع اليد عن الظهور في الوجوب الشرعي أولى.
بل الإنصاف: عدم ظهورها فيه، بعد كون لزوم الوفاء بالعقود والعهود عقلائيّاً، شائعاً بين جميع الطوائف، ظاهراً لديهم، وفي مثله لا ينقدح في أذهانهم إلاّ ما هو الشائع بينهم، وهو المناط في الاستظهار، وظهور الأمر في الوجوب الشرعي ليس -كسائر الظهورات- مستنداً إلى دلالة لفظيّة، بل هو كظهور الحال والمقام.
ومع كون وجوبه ولزومه العقلائي مرتكزاً في الأذهان، لا يحمل الكلام إلاّ على ما هو المرتكز، كالأمر بالعمل بخبر الثقة، أو الظهور اللفظي، أو غيرهما ممّا هو معهود عند العرف.
فالآية الكريمة تدلّ على لزوم العمل بالعقود، ولازم ذلك -بحسب الفهم العرفي- أنّ العقود لازمة؛ ضرورة أنّ اللزوم لازم عرفي لوجوب العمل، وكونه ملزماً به، ولو قيل: (إنّك ملزم بالعمل بعقد كذا، ولكن زمامه بيدك فسخاً وإبقاءً)، عدّ ذلك عند العرف تناقضاً.
فالقول: بأنّ وجوب الوفاء، لا ينافي جواز العقد أو خياريّته ساقط جدّاً؛ لعدم جواز الاتكال في هذا المجال على التخريصات العقليّة، بل المناط هو فهم العرف واستظهارهم، كالقول: بأنّ وجوب الوفاء، لازمه وجوب إبقاء العقد تكليفاً، فهو دالّ على جوازه؛ لاعتبار القدرة في متعلّق التكليف ضرورة أنّ ذلك بعيد عن الأذهان جدّاً، بل لازمه إقدار المكلف على المخالفة، ثمّ الأمر بالوفاء.
وبعبارة أُخرى: ردع العقلاء عن البناء على لزوم العقد، ثمّ الأمر بعدم الفسخ، وهو أمر بعيد عن الأذهان، بل لعلّه مستهجن عند العرف لو فسّر المقصود لهم، فلا ينبغي الإشكال في الدلالة على اللزوم.
ثمّ إنّ ما ذكرناه: من أنّ وجوب الوفاء، يحمل على ما هو المرتكز العرفي، ليس المراد منه أنّ «العقود» فيها أيضاً محمولة على العقود المعهودة اللازمة عرفاً، حتّى يقال: إنّ لازمه بطلان التمسّك بالآية، ولزوم الرجوع في كلّ مورد إلى الحكم العرفي.
بل المراد: أنّ خصوص وجوب الوفاء محمول على ذلك، فرفع اليد عن العموم بلا حجّة، لا وجه له، فالعموم على عمومه، ووجوب الوفاء هو اللزوم العقلائي، فتدبّر”(112).
الشرط الثالث: عدم قيام قرينة صارفة للظهور: و”القرينة الصارفة عن الموضوع له، لا بدّ أن تكون معاندة للحقيقة ولو بحسب متفاهم العرف حتى يصح كونها صارفة للفظ عن معناه الحقيقي في فهم العرفي”(113)، وعليه، “فإن مجرد وجود معهود في المقام –مثلاً-، لا ينافي إرادة العموم في المقام ولو بحسب العرف، ولذا لا يصح جعله صارفاً للفظ عن معناه الحقيقي”(114)، بل يجب حمل اللفظ على ظاهره لتجرده عن القرائن الصارفة له إلى غير ظاهره.
ويمكن التمثيل بمثالين: المثال الأول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾(115).
قال (قدِّس سرُّه): “إذا وصلنا إلى مورد ليس في وسعنا استفادة المعنى الذي نريد من هذا اللفظ، ليس لنا أن نطبقه على معقولاتنا إلاّ إذا كان حكم العقل ضرورياً، بحيث يوجب الظهور للفظ، فإذا كان الظهور البدوي من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾(116)، على شيء ينكره العقل الضروري، نفهم عن كلمة ﴿اسْتَوَى﴾ معنى آخر، وهو كون معناها استولى بتفسير أهله”(117).
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾(118)، فقد نقل (قدِّس سرُّه) استدلالاً، يظهر منه توقفه فيه لتعبيره عنه في طيات دراسته بقوله (قدِّس سرُّه): “على تسليم ما ذكر فيه”(119).
الأمر الأول: “النّظر الحكومتي كما قد يتفق”(120): قال (قدِّس سرُّه): “إن تقديم أحد الدليلين على الآخر عرفا، يكون بواسطة الحكومة، والضابطة فيها: كون الدليل الحاكم متعرضا للمحكوم نحو تعرض ولو بنحو اللزوم العرفي أو العقلي مما لا يرجع إلى التصادم في مرحلة الظهور، أو كون دليل الحاكم متعرضا لحيثية من حيثيات دليل المحكوم مما لا يتكفله دليل المحكوم توسعة وتضييقا”(121).
وبعبارة أكثر تفصيل -كما قال (قدِّس سرُّه)-: “الضابط فيها: أن يكون أحد الدليلين متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لا يكون هذا الدليل متعرضا لها، وإن حكم العقلاء مع قطع النظر عن الدليل الحاكم بثبوت تلك الحيثية، سواء كان التعرض بنحو الدلالة اللفظية أو الملازمة العقلية أو العرفية، وسواء كان التصرف في موضوعه أو محموله أو متعلقه إثباتا أو نفيا، أو كان التعرض للمراحل السابقة أو اللاحقة للحكم، كما لو تعرض لكيفية صدوره، أو أصل صدوره، أو تصوره، أو التصديق بفائدته، أو كونه ذا مصلحة، أو كونه مرادا، أو مجعولا، أو غير ذلك.
مثلا: لو قال: (أكرم العلماء)، فهو مع قطع النظر عن شيء آخر يدل على وجوب إكرام جميع العلماء، ويحكم العقلاء على كون هذا الحكم -موضوعا ومحمولاً- متصورا للحاكم، ويكون مجعولا ومتعلقا لإرادته استعمالاً، وجداً، لا هزل فيه، ولا تقية، ولا غيرهما، ويكشف عن كونه ذا مصلحة ملزمة، كل ذلك بالأصول اللفظية والعقلائية.
فلو تعرض دليل آخر لأحد هذه الأمور، يكون مقدما على هذا الدليل بالحكومة، فلو قال: (إن الفساق ليسوا بعلماء)، أو (المتقين من العلماء)، أو (الشيء الفلاني إكرام)، أو (الإكرام الكذائي ليس بإكرام)، أو قال: (ما جعلت وجوب الإكرام للفساق)، أو (ما أردت إكرامهم)، أو (لا يكون إكرامهم منظوري)، أو (لا مصلحة في إكرامهم)، أو صدر هذا الحكم عن هزل أو تقية، يكون مقدما على الدليل الأول بالحكومة.
وأما لو تعرض لما أثبت الدليل الآخر، مثل أن قال: (لا تكرم الفساق من العلماء)، أو (لا تكرم الفساق)، يكون التعارض بينهما في مرحلة الظهورين، فيقدم الأظهر منهما، ولا يكون تقديم أحد الظاهرين على الآخر بالحكومة، كما لا يكون تقديم قرينة المجاز على ذيها بالحكومة، بل إنما يكون بالأظهرية.
فميزان الحكومة هو نحو من التعرض لدليل المحكوم بما لا يرجع إلى التصادم الظهوري، ولو كان التعرض بالملازمة، فأدلة الأمارات التي لسانها الكشف عن الواقع أو ثبوت الواقع مقدمة على أدلة الأصول بالحكومة -بناء على أخذ الشك في موضوعها- فإن التعبد بالثبوت الواقعي ملازم عرفا لرفع الشك تشريعاً، فيكون تعرضها لها بالملازمة العرفية، كما أن أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة الأصول، لأن مفادها إطالة عمر اليقين، فيلازم رفع الشك، بل مفادها حصول غاية الأصول، وهو من أظهر موارد الحكومة، بل حكومة الاستصحاب على الأصول أظهر من حكومة الأمارات عليها ولو لم نلتزم بأمارية الاستصحاب، كما هو المعروف بين المتأخرين.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الحكومة ولو كانت متقومة بنحو من التعرض لدليل المحكوم مما لا يتعرض المحكوم له، لكن هذا التعرض لا يلزم أن يكون بنحو الدلالة اللفظية”(122).
وكيف كان، فالاستدلال نافع في تقريب فكرة نفي الظهور بالقرينة العقلية.
قال (قدِّس سرُّه): “ذكروا في جواب استدلال القائل بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ بقوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾(123)، ببيان: أنّ الظاهر وحدة ظرف الظلم وعدم النيل، فلا بدّ من صدق الظالم على من قضي عنه الظلم.
فأُجيب عنه: بأنّ الحكم المستمرّ إنْ تعلّق بموضوع آني الوجود، لا بدّ وأن يكون تحقّق موضوعه آناً مّا كافياً لترتّب الحكم المستمرّ عليه، والظلم آني الوجود غالباً، وعدم النيل مستمرّ الوجود، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور بالقرينة العقليّة”(124).
القرينة الصارفة: وصيرورة شيء قرينة على صرف ظهور شيء، يمكن أن يتحقق بأمور أذكر ما وجدت له مثالاً من كلامه (قدِّس سرُّه) -بحسب استقرائي الناقص-: الأمر الثاني: الأظهرية: “قوة الظهور”(125)، قال (قدِّس سرُّه): “إن تقديم أحد الدليلين على الآخر عرفا، “يكون بواسطة الأظهرية، وذلك فيما إذا كان التعارض والتصادم في مرتبة ظهور الدليلين، كتقديم قرينة المجاز على ذي القرينة، وتقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، فإن التصادم بينهما إنما يكون في مرحلة الظهور، والميزان في التقديم في تلك المرحلة هو الأظهرية لا غير”(126).
وقال (قدِّس سرُّه): “والَّذي يمكن أن يقال: أنه قد نرى أن العقلاء وأرباب المحاورات قد يقدمون دليلاً على دليل من غير ملاحظة النسبة بينهما، ومن غير ملاحظة أظهرية أحدهما من الآخر، وقد يتوقفون في تقديم أحد الدليلين مع كون النسبة بينهما كالسابقة، مثلاً: لو ورد: (يجب إكرام العلماء)، وورد في دليل منفصل: (يحرم إكرام الفساق)، فيعرض الدليلان على أهل المحاورات والعرف، تراهم يتوقفون في الحكم، ولا يحاولون ترجيح أحدهما على الاخر، ولو بدل قوله: (يحرم إكرام الفساق) بقوله: (ما أردت إكرام الفساق)، أو (ما حكمت بإكرامهم)، أو (ما جعلت إكرامهم)، أو (لا خير في إكرامهم)، أو (لا صلاح في إكرامهم)، أو (لا أرى إكرامهم)، أو (ليس منظوري إكرامهم)، أو (ليس الفساق أهلا للإكرام)، أو (إكرامهم خطأ)، أو (لا أقول بإكرامهم)، أو أمثالها، تصير تلك الألسنة قرينة على صرف قوله: (يجب إكرام العلماء)، عن وجوب إكرام الفساق منهم مع أنّ النسبة بينه وبينها عموم من وجه ولا فرق بين ما ذكر وبين ما تقدم إلاّ في كيفية التأدية والتعبير، وكذا الحال في قوله: «لا سهو على من أقر على نفسه بسهو»(127)، بالنسبة إلى أدلة الشكوك، وقوله: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(128)، أو «لا ضرر ولا ضرار»(129)، أو ﴿لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(130)، بالنسبة إلى أدلة الأحكام مع أنّ النسبة بينهما عموم من وجه، وليس هذا النحو من التقديم بلحاظ مقام الظهور، وترجيح الأظهر على الظاهر، أو النص على الظاهر.
ومن ذلك يعلم أن غير التقديم الظهوري الَّذي يكون معولا عليه عند العقلاء، يكون ترجيح وتقديم آخر، وهو: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لم يتعرضها ذلك الدليل.
وتوضيح ذلك: أنَّ الدليلين إما أن يكون كل منهما متعرضاً بمدلوله لما يتعرضه الدليل الآخر، ويكون الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ذلك في جهات أخر كالإيجاب والسلب، مثل: (أكرم العلماء)، و(لا تكرم العلماء)، أو مع أخصية أحدهما عن الآخر، مثل: (أكرم العلماء)، و(لا تكرم فساقهم)، أو مع كون النسبة عموماً من وجه، مثل: (أكرم العلماء)، و(لا تكرم الفساق)، وكاختلافهما في زيادة قيد مع الاتفاق في الكيف، مثل: (إن ظاهرت أعتق رقبة)، و(إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة)، ففي جميع تلك الموارد ترى أن كلا من الدليلين يتعرض لما يتعرضه الآخر، فكما أن أحدهما تعرض وجوب إكرام العلماء، تعرض الآخر عدم وجوب إكرامهم، وكما أن أحدهما تعرض لعتق رقبة، تعرض الآخر لعدم عتق كافرتها أو لعتق مؤمنتها، فما لمدلول اللفظي من أحدهما هو المدلول الآخر، مع اختلاف في الكيف أو في زيادة أو مثلهما.
وإن شئت قلت: في الأدلة اللفظية أنّ التصادم بينهما في مرحلة الظهور مع اتحادهما في جميع المراحل، من الأصول العقلائية، فإذا كان الدليلان كذلك، يكون تقديم أحدهما على الآخر تقديما ظهورياً، ومناطه أظهرية أحدهما من الآخر، فتقديم: (لا تكرم الفساق من العلماء)، على: (أكرم العلماء)، ليس إلا من جهة تقديم الأظهر على الظاهر.
وجميع الأصول اللفظية: كأصالة العموم، وأصالة الإطلاق، وأصالة الحقيقة، ترجع إلى أصالة الظهور عند العقلاء، فما هو المعتبر عندهم والحجة لديهم هو الظهور اللفظي، (فأكرم العلماء) حجة، لظهوره في العموم بعد تحقق المقدمات الأخرى من الأصول العقلائية، وليس ظهوره معلقا على عدم مجيء المخصص، بل ظهوره منجز، وبناء العقلاء على العمل به من غير تعليقه على شيء، ولكن مع ورود دليل أخص منه يقدم مقتضاه عليه، لقوة ظهوره وأظهريته من ظهور العام في مضمونه. وكذا الحال في المطلق والمقيد، فإن مناط تقديمه على المطلق ليس إلا أقوائية ظهور القيد في القيدية من المطلق في الإطلاق”(131).
الأمر الثالث: القرينة العقلية: في البداية يمكن القول إنّه لا يجوز رفع اليد عن الظهور بعد فرض وجوده إلاّ بدليل.
قال الإمام (قدِّس سرُّه): ولو ادعي “قيام الدليل العقلي على خلافه –خلاف الظهور-، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأي وجه ممكن، لا يجوز رفع اليد عن الحجة، ولو كان الدفع بعيداً عن الأذهان، بنحو لا يصح الالتزام به في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة”(132)، وإن لم يمكن دفع الدليل العقلي، صار صارفاً للظهور.
والحمد لله أولاً وآخراً.
الهوامش والمصادر
- (1) وبسبب هذا التعدد في المحتمل، عدّت دلالة الظاهر ظنية، وأمكن رفع اليد عنها لدليل ظني آخر، ثبتت حجيته بدليل قطعي. وأخذت الدلالة الظنية في بعض التعاريف التي ذُكرت الظاهر، كتعريفه بأنه: «ما كانت دلالته ظنية في العرف» (أصول الاستنباط لنقي الحيدري: 173)، باعتبار أن المعنى الظاهري معنى راجح، والرّاجح أمرٌ ظنّي.
- (2) العين للخليل: 4 / 37.
- (3) العين للخليل: 4 / 37.
- (4) الصحاح للجوهري: 2 / 732.
- (5) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 1 / 49.
- (6) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 5 / 196.
- (7) أنوار الهداية للسيد الخميني: 1 / 241.
- (8) أنوار الهداية للسيد الخميني: 1 / 241.
- (9) أنوار الهداية للسيد الخميني: 1 / 239.
- (10) أنوار الهداية للسيد الخميني: 1 / 241.
- (11) النساء: 58.
- (12) الاجتهاد والتقليد للخميني: 39.
- (13) الاجتهاد والتقليد للخميني: 39.
- (14) الاجتهاد والتقليد للخميني: 41.
- (15) المائدة: 44.
- (16) المائدة: 45.
- (17) المائدة: 47.
- (18) الاجتهاد والتقليد للخميني: 40.
- (19) الاجتهاد والتقليد للخميني: 41.
- (20) الاجتهاد والتقليد للخميني: 41.
- (21) المكاسب المحرمة للخميني: 1 / 33.
- (22) الأعراف: 157.
- (23) المكاسب المحرمة للخميني: 1 / 34.
- (24) الإسراء: 78.
- (25) الإسراء: 78.
- (26) الخلل في الصلاة للخميني: 90.
- (27) الخلل في الصلاة للخميني: 95.
- (28) الخلل في الصلاة للخميني: 94.
- (29) الخلل في الصلاة للخميني: 94.
- (30) الخلل في الصلاة للخميني: 94.
- (31) البقرة: 222.
- (32) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 1 / 247.
- (33) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 1 / 40.
- (34) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 1 / 41.
- (35) كتاب البيع للسيد الخميني: 1 / 31.
- (36) كتاب البيع للسيد الخميني: 1 / 69.
- (37) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 1 / 58.
- (38) المائدة: 6.
- (39) وسائل الشيعة للعاملي: 3 / 360 ح3869.
- (40) المائدة: 6.
- (41) الأحزاب: 4.
- (42) الزمر: 75.
- (43) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 2 / 147.
- (44) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 1 / 42.
- (45) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 1 / 58.
- (46) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 2 / 166.
- (47) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 2 / 166.
- (48) قال الإمام (قدِّس سرُّه): “إن اللغة قد دونت في زمن المعصومين، فإن أول من دونه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عده الشيخ من أصحاب الصادق (عليه السلام)، وبعده ابن دريد صاحب الجمهرة الذي هو من أصحاب الجواد (عليه السلام) وألف ابن السكيت إصلاح المنطق الذي قتله المتوكل لتشيعه وهذا يكشف عن كون التدوين والرجوع إلى معاجم اللغة كان أمرا دائرا”(تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 2 / 166).
- (49) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 2 / 166.
- (50) النساء: 43.
- (51) المائدة: 6.
- (52) المعتبر للحلي: 1 / 273.
- (53) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 2 / 144.
- (54) جواهر الأصول تقرير بحث السيد الخميني للنكرودي: 2 / 120.
- (55) الكهف: 40.
- (56) يعني قول النبيّ (صلَّى الله عليه وآله): «يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً على صعيد واحد».
- (57) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 2 / 146.
- (58) كتاب البيع للسيد الخميني: 3 / 442.
- (59) كتاب البيع للسيد الخميني: 3 / 442.
- (60) المكاسب المحرمة للسيد الخميني: 1 / 214.
- (61) جواهر الأصول تقرير اللنكوردي لبحث السيد الخميني: 2 / 143.
- (62) المكاسب المحرمة للسيد الخميني: 1 / 70.
- (63) المائدة: 6.
- (64) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 2 / 146.
- (65) الحجرات: 12.
- (66) المكاسب المحرمة للسيد الخميني: 1 / 261.
- (67) آل عمران: 45.
- (68) النساء: 164.
- (69) هود: 37.
- (70) مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الآملي للشهرضائي: 2 / 4.
- (71) آل عمران: 7.
- (72) القلم: 1.
- (73) مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الآملي للشهرضائي: 2 / 5.
- (74) تهذيب الأصول تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني: 2 / 166.
- (75) جواهر الأصول تقرير بحث السيد الخميني للنكرودي: 1 / 68.
- (76) جواهر الأصول تقرير بحث السيد الخميني للنكرودي: 1 / 53.
- (77) النساء: 7.
- (78) كتاب البيع للسيد الخميني: 5 / 390.
- (79) المائدة: 3.
- (80) البقرة: 173.
- (81) البقرة: 172- 173.
- (82) المائدة: 4.
- (83) المائدة: 5.
- (84) المكاسب المحرمة للخميني: 1 / 35.
- (85) المائدة: 90.
- (86) المكاسب المحرمة للخميني: 1 / 32.
- (87) المكاسب المحرمة للخميني: 1 / 32.
- (88) المائدة: 91.
- (89) المكاسب المحرمة للخميني: 1 / 32.
- (90) البقرة: 222.
- (91) الكافي للكليني: 6 / 428 ح1.
- (92) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 1 / 245.
- (93) كتاب الطهارة للسيد الخميني: 1 / 245.
- (94) هود: 113.
- (95) هود: 113.
- (96) تفسير مجمع البيان للطبرسي: 5 / 344.
- (97) من لا يحضره الفقيه للصدوق: 4 / 11 ح4968.
- (98) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للصدوق: 2 / 129 ح1.
- (99) الخصال للصدوق: 603 ح9.
- (100) كتاب البيع للسيد الخميني: 2 / 600.
- (101) الأنفال: 41.
- (102) كتاب البيع للسيد الخميني: 2 / 659.
- (103) النساء: 7.
- (104) كتاب البيع للسيد الخميني: 5 / 376.
- (105) كتاب البيع للسيد الخميني: 5 / 376.
- (106) كتاب البيع للخميني: 5 / 42.
- (107) المائدة: 1.
- (108) المائدة: 1.
- (109) المائدة: 1.
- (110) تفسير القمي للقمي: 1 / 160.
- (111) وهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عيد الله (عليه السلام) في قوله: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ قال: «بالعهود»( تفسير القمي للقمي: 1 / 160).
- (112) كاب البيع للسيد الخميني: 4 / 28.
- (113) هداية المسترشدين لمحمد تقي: 3 / 192.
- (114) هداية المسترشدين لمحمد تقي: 3 / 192.
- (115) طه: 5.
- (116) طه: 5.
- (117) كتاب البيع للسيد الخميني: 2 / 382.
- (118) البقرة: 128.
- (119) كتاب البيع للسيد الخميني: 1 / 197.
- (120) الرسائل للسيد الخميني: 2 / 8.
- (121) أنوار الهداية للسيد الخميني: 2 / 14.
- (122) أنوار الهداية للسيد الخميني: 1 / 370.
- (123) البقرة: 128.
- (124) كتاب البيع للسيد الخميني: 1 / 197.
- (125) الرسائل للسيد الخميني: 2 / 8.
- (126) أنوار الهداية للسيد الخميني: 1 / 370.
- (127) مستطرفات السرائر لابن إدريس: 207.
- (128) الحج: 18.
- (129) الكافي للكليني: 5 / 280 ح4.
- (130) البقرة: 185.
- (131) الرسائل للسيد الخميني: 1 / 236.
- (132) كتاب البيع للسيد الخميني: 2 / 382.