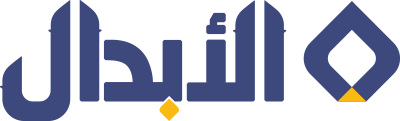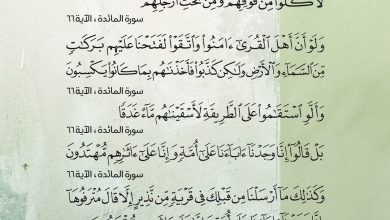ملامح الإبداع في التجربة التفسيرية للشهيد الصدر

المدخل قدّم السيد الشهيد الصدر تجربة جديدة في التفسير تميّزت بخصائص فريدة من نوعها. في هذه التجربة طرح الشهيد الصدر مجموعة من الأفكار تكشف عن عقلية جبّارة وعن إبداع متميّز وفريد. ولا نبالغ إذا قلنا بأن السيد الشهيد من خلال تفسيره الموضوعي لامس كثير من الأسئلة الجـديدة والإثـارات المعاصـرة المطـروحة على السـاحة، في الوقت نفسه عرض السيد الشهيد مجموعة من الأفكار التي لا تتفق مع ما هو موجود في التجارب التفسيرية الأخرى، ومن هذا المنطلق سنحاول عرض أفكار السيد الشهيد في التجربة التفسيرية له، وملامحها العامة، ووجه الإبداع فيها، وكيفية ملامستها للتساؤلات المعاصرة المطروحة على الساحة، مع طرح بعض الإشكالات حول هذه التجربة ومحاولة الإجابة عنها.
طرح السيد الشهيد الصدر مفهوماً خاصاً له عن التفسير مغايرا لما هو سائد من مفهوم التفسير وهو ما سمّاه بتفسير المعنى، بخلاف التفسير السائد الذي يقصد منه إجلاء اللفظ لا المعنى، ولكي نعرف ما الفرق بين تفسير المعنى واللفظ نعرّف كلاّ منهما:
تفسير اللفظ: هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مداليلها لغة، وتفسير المعنى: هو تحديد مصداقه الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك المعنى(1).
فحين نسمع شخصاً يقول: إن دول الاستكبار الكافر تملك أسلحة ضخمة، تارة نتساءل: ما هو معنى الأسلحة؟ ونجيب عن السؤال: إن الأسلحة هي الأشياء التي يستعين بها صاحبها في قهر عدوه، وأخرى نتساءل ما هي نوعية السلاح الذي تمتلكه تلك الدول؟ ونجيب: إنّ سلاحها القنابل الذرية. ففي المرة الأولى فسّرنا اللفظ إذ ذكرنا معناه لغة، وفي المرة الثانية فسرنا المعنى إذ حددنا المصداق الذي ينطبق عليه معنى الجملة ويشير إليه، فنسمي المرحلة الأولى بمرحلة تفسير اللفظ أو التفسير اللغوي وهي مرحلة تحديد المفاهيم، والمرحلة الثانية: مرحلة تفسير المعنى وهي مرحلة تجسيد المفاهيم في صور معينة محددة(2).
والمرحلة الثانية وهي التي سماها السيد الشهيد الصدر تفسير المعنى -وهي مرحلة تحديد المصداق الخارجي- هي الدائرة الأهم التي يشتغل عليها السيد الشهيد في تفسيره الموضوعي، فلم يقتصر جهد السيد الشهيد في تفسيره الموضوعي ببيان معنى اللفظ، بل حاول من خلال تجربته التفسيرية تحديد ما يؤول إليه المعنى أو المصداق الخارجي الذي ينطبق عليه، وهذا المعنى من التفسير هو ما يطلق عليه (التأويل) في الاصطلاح القرآني والروائي؛ فعن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن… ما يعني بقوله لها ظهر وبطن، قال: «ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع، قال الله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} نحن نعلمه»(3). والذي يستظهر من الرواية أن التأويل هو بطن القرآن، واستخدام التأويل هنا بمعنى اسم المفعول لا المصدر، وهذا البطن منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد -بناء على إرجاع الضمير في(منه) على البطن- وهذا يدل بوضوح أن البطن متجدد يجري مجرى الشمس والقمر وهذا لا يتناسب مع حمل البطن على مدلول اللفظ؛ لأن مدلول اللفظ بحسب نظام اللغة وقواعدها ثابت غير متجدد، محدود لا غير متناه.
يقول السيد الشهيد: “المسألة هنا ليست مسألة تفسير لفظ فإن طاقات التفسير اللغوي ليست طاقات لا متناهية، بينما القرآن الكريم دلت الروايات على أنه لا ينفد، وصرح القرآن الكريم بأن كلمات اللّه لا تنفد، القرآن الكريم عطاء لا ينفد بينما التفسير اللغوي ينفد لأن اللغة لها طاقات محدودة، وليس هناك تجدد في المدلول اللغوي، ولو وجد لغة أخرى بعد القرآن لا معنى لأن يفهم القرآن من خلال لغة جديدة أو مصطلحات جديدة أو ألفاظ تحمل مدلولات وضعية استهدفت بعد القرآن”(4).
ولكن ما هي الآلية التي استخدمها السيد الشهيد في الوصول إلى تفسير المعنى؟ طرح السيد الشهيد الصدر مفهوم التفسير الموضوعي كأداة وآلية نتوصل بها إلى تفسير معاني القرآن اللامتناهية وعلى هذا سنحاول أن نتعرف على مفهوم التفسير الموضوعي من خلال كلمات السيد الشهيد نفسه.
تجربة التفسير الموضوعي (التوحيدي) عند الشهيد الصدر
التفسير الموضوعي: هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزيئي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية… ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون(5).
ويمكن لنا أن نبرز ملامح هذا الاتجاه في التفسير ووجه الاختلاف بينه وبين الاتجاه التجزيئي في أمرين اثنين:
1- المفسّر التجزيئي دوره في التفسير على الأغلب سلبي فهو يبدأ أولاً بتناول النص القرآني المحدّد آية مثلا، أو مقطعاً قرآنياً، دون أي افتراضات أو أطروحات مسبقة، ويحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما يسعفه به اللفظ مع ما يتاح له من القرائن المتّصلة والمنفصلة، العمليّة في طابعها العام، عمليّة تفسير نص معين وكأنَّ دور النص فيها دور المتحدِّث ودور المفسِّر هو الإصغاء والتّفهم وهذا ما نسمّيه بالدور السلبي…. وخلافاً لذلك المفسِّر التوحيدي والموضوعي فإنه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة، يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدّمه الفكر الإنساني من حلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة، ومن نقاط فراغ ثم يأخذ النص القرآني، لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور المستمع والمسجِّل فحسب، بل ليطرح بين يدي النص موضوعاً جاهزاً مشرباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية ويبدأ مع النص القرآني حواراً؛ سؤالاً وجوابا، المفسِّر يسأل، والقرآن يجيب، المفسِّر على ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خلال التجارب البشرية الناقصة من خلال أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على الأرض لا بد وأن يكون قد جمع حصيلة ترتبط بذلك الموضوع، ثم ينفصل عن هذه الحصيلة ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم، لا يجلس ساكتاً ليستمع فقط بل يجلس محاوراً، يجلس سائلاً ومستفهماً ومتدبراً، فيبدأ مع النص القرآني حواراً حول هذا الموضوع، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من النص، من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار واتجاهات.
ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائماً بتيّار التجربة البشرية؛ لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن موضوع من مواضيع الحياة(6).
فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة؛ لأنَّ التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيم والمصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع(7).
2- إن التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجزيئي خطوة؛ لأنَّ التفسير التجزيئي يكتفي بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريمة، بينما التفسير الموضوعي يطمح إلى أكثر من ذلك، يتطلع إلى ما هو أوسع من ذلك، يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات التفصيلية يحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآني، وهذا المركب النظري القرآني يحتل في إطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه المناسب، وهذا ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية، يصل إلى نظرية قرآنية عن النبوة، نظرية قرآنية عن المذهب الاقتصادي، نظرية قرآنية عن سنن التاريخ، وهكذا عن السماوات والأرض، فهنا التفسير الموضوعي يتقدم خطوة على التفسير التجزيئي بقصد الحصول على هذا المركب النظري الذي لا بد أن يكون معبِّراً عن موقف قرآني تجاه موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية. هذان فارقان رئيسيان بين التفسير والاتجاه التجزيئي في التفسير، ونحن ذكرنا بأن البحث الفقهي اتجه اتجاهاً موضوعياً بينما التفسير لم يتجه على الأكثر اتجاهاً موضوعياً بل كان اتجاهاً تجزيئيا.
ويمكن أن نخلص إلى أن “اصطلاح الموضوعية هنا على ضوء الأمر الأول، بمعنى أنه يبدأ من الموضوع، من الواقع الخارجي، من الشيء الخارجي ويعود إلى القرآن الكريم، ويعبّر عن التفسير بأنه موضوعي على ضوء الأمر الأول باعتبار أنه يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي إلى القرآن الكريم. وتوحيدي باعتبار أنه يوحّد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على القرآن، ولا بمعنى أنه يُخضع القرآن للتجربة البشرية، بل بمعنى أنه يوحّد بينهما في سياق بحث واحد، لكي يستخرج نتيجة هذا السياق الموحّد من البحث، يستخرج المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي أدخلها في سياق بحثه”(8).
ويمكن أن نخلص إلى أن اصطلاح الموضوعية والتوحيدية على ضوء الأمر الثاني “باعتبار أنَّه يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد. وهو توحيدي باعتبار أنه يوحّد بين هذه الآيات، يوحّد بين مدّلولات هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد، إذن اصطلاح الموضوعية واصطلاح التوحيدية في التفسير ينسجم مع كل من هذين الفارقين بما بيناه”(9).
ملاحظات حول أطروحة التفسير الموضوعي لدى الشهيد الصدر:
طرح السيد الشهيد مفهوم الرجوع إلى الخارج قبل الولوج في التفسير وهذا الطرح قد يراه البعض مناف لما يصرح به القرآن من أنه مصدر الهداية؛ فإنْ كان المفسِّر يستعين بالتجربة الإنسانية لهداية البشر فهذا يعني أن القرآن لوحده غير كاف للهداية، بل لا بد من الاستعانة بشيء آخر وهي التجربة الإنسانية -مظهر من مظاهر العقل- ومن هنا كان هذا الأسلوب المقترح من السيد الشهيد الصدر محل تساؤل.
علّق العلامة الطباطبائي على هذا المنهج بقوله: “ففرقٌ بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات: ماذا يقول القرآن؟ أو يقول: ماذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ فإن القول الأول يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث، وان يتكئ على ما ليس بنظري، والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة وتسليمها وبناء البحث عليها، ومن المعلوم أن هذا النحو من البحث في الكلام ليس بحثا عن معناه في نفسه”(10) وعلق على من يفسر القرآن وهو محمل بالأفكار الفلسفية والعلمية وغيرها “ولازم ذلك (كما أومأنا إليه في أوائل الكلام) أن يكون القرآن الذي يعرف نفسه (بأنَّه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكل شيء) مهدياً إليه بغيره ومستنيراً بغيره ومبينا بغيره، فما هذا الغير! وما شأنه! وبماذا يهدي إليه! وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه! وقد اختلف واشتد الخلاف”(11). ومن ثم ذكر المناهج في تفسير القرآن فقال: “وذلك على أحد وجهين، أحدهما: أن نبحث بحثاً علمياً أو فلسفياً أو غير ذلك عن مسألة من المسائل التي تتعرض له الآية حتى نقف على الحق في المسألة، ثم نأتي بالآية ونحملها عليه، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري، غير أن القرآن لا يرتضيها كما عرفت، وثانيهما: أن نفسّر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: (إنا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية). وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسه، وقال تعالى: (هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان الآية). وقال تعالى: (إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا الآية). وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقاناً ونوراً مبيّناً للنّاس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج! وقال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية). وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه! وأي سبيل أهدى إليه من القرآن”(12).
وكلماته إن لم تكن صريحة في المطلوب فلا أقل من ظهورها في ذلك وإن أمكن المناقشة في بعض الجوانب.
ويمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بأن كون القرآن كتاب هداية بنفسه لا ينافي أن قبليات المفسِّر تؤثر في فهمه إلى النص، فالكل يتفق تقريباً بأن الآيات التي أشارت إلى بعض الموضوعات الطبيعية التي اكتشفت مؤخرا لم تكن لتفهم إلا من خلال النتائج العلميّة الحديثة، لكن هذا لم يصيّر هذه الاكتشافات شريكا للهداية بنظر المفسرين، ولم نر أحداً يقول بأن القرآن غير كاف وحده للهداية لأنه يحتاج إلى العقل الفطري أو البديهي كما صرح العلامة نفسه، ولم يقل أحدٌ بأن احتياج فهم القرآن لعلوم العربية من معجم وبلاغة وصرف وغيرها يصيّر هذه العلوم شريكاً للقرآن في الهداية. فلم يتبادر في ذهن أي أحد بأن هذه العلوم صارت شريكاً مع القرآن في الهداية لكون المفسِّر احتاجها لتفسير وفهم الآيات!!.
ثانيا: تؤكد الدراسات العلمية في مجال الألسنيات وعلم النفس المعرفي أن المفسِّر لا يمكن أن يتخلص من قبلياته المعرفية والنفسية في قراءته للواقع الذي جزء منه هو النص، فلا يمكن للمفسر أن يعزل تجربته النفسية والاجتماعية والمعرفية والخبرات الانفعالية والنزوعات العاطفية التي مر بها على مدى فترة حياته عن فهمه للنص أو لأي رمز أو دال آخر لا أقل على مستوى اللاشعور، وينبغي هنا التأكيد بأن هذا لا يعني بأن النص يفقد دوره كدال أو يكون فارغ المعنى إلا مما يحمِّله المفسِّر على النص كما هي بعض نظريات الهرمنيوطيقا، فالنص لا يعطيك إلا ما بداخلك. هذا غير مقبول لكن ما نريد أن نؤكد عليه بأن الخبرات المعرفية والنفسية وغيرها للمفسّر تؤثر على فهمه للنص ولا يمكن عزلها عزلا تاما. وهذا بنحو من الأنحاء يلتقي مع نظرية العرفاء من أن صفاء النفس ينعكس على فهم القرآن ويصير قلب الإنسان محلا لتجلي المعارف القرآنية، وهذا الكلام في حقيقته توضيح لأثر التجربة الروحية للإنسان على فهمه للنص.
وهناك نقطة مهمة أخرى ألا وهي أن تفسير السيد الشهيد (قدّس سرّه) تفسير للمعنى (تأويل)، ومن الواضح أن معرفة المصاديق وتحديدها لا يمكن إلا من خلال دراسة الواقع الخارجي. وهذا ما يشير إليه المنسوب إلى ابن عباس أن (القرآن يفسره الزمان)؛ فللقرآن أبعاد أخرى تنجلي بمرور الزمان وتعاقب التجارب البشرية ونمو الكفاءات الفكرية. أضف إلى ذلك أن (القرآن يفسر بعضه بعضا)، وهذا لا يتنافى مع كونه نوراً وكلاماً مبينا، لأنه كل لا يتجزأ، وجميع لا تفرد، يشكل بمجموعه النور والكلام المبين(13).
ملاحظات حول مبررات التفسير الموضوعي لدى السيد الشهيد:
رأي الشهيد الحكيم (قدّس سرّه): سجّل الشهيد السيد محمد باقر الحكيم بعض الملاحظات على المبررات التي ساقها السيد الشهيد (قدّس سرّه) لتفضيل المنهج الموضوعي على التجزيئي. فعلق على المبرر الأول وهو كون المفسر في التفسير الموضوعي ينطلق من الواقع الخارجي لكي يصل إلى القرآن:
“أما المرجّح الأول: فإننا لا يمكن أن نعتبر خصوصية ملاحظة الواقع الموضوعي القائم والإثارات التي يثيرها هذا الواقع وتساؤلاته ومحاولة الحصول على الإجابة والمعالجة لهذا الواقع من خلال القرآن، لا يمكننا أن نعتبر هذه الخصوصية ميزة ومرجح لمنهج التفسير الموضوعي على المنهج التجزيئي، وذلك لأن هذا المرجح موجود في منهج التفسير التجزيئي أيضاً. وبمراجعة كتب التفسير لمختلف العصور، تجد أن هذه المعالجة للواقع الموضوعي الخارجي في التفسير قائمة وموجودة غاية ما في الأمر أن مستوى هذه المعالجة قد يختلف باختلاف المفسر والإثارات التي يثيرها الواقع الموضوعي. فعندما وقع الاختلاف والصراع في تفسير العقيدة الإسلامية بين(المعتزلة) و(الأشاعرة) وهو صراع قائم في الواقع الموضوعي لذلك العصر، فإن ذلك الصراع قد انعكس على كتب التفسير في زمانه، وكان المسلمون والباحثون يرجعون إلى القرآن الكريم للحصول على أجوبة للمسائل والمشاكل التي تعترضهم.
ومن الواضح أن المنهج الذي كانوا يثبتونه آنذاك كان هو (المنهج التجزيئي) إذ كانوا يأخذون من القرآن الكريم مقطعاً ويحاولون في كل مقطع منه أن يجيبوا عن التساؤلات المرتبطة به، أو يحلّوا المشكلات التي يعيشها الواقع الموضوعي في ضوء ما يقرره ذلك المقطع… وعلى هذا، فإننا نرى أن هذا المرجّح أمر مشترك وميزة مشتركة يمكن أن تنعكس على كلا المنهجين. ولا ينبغي للفظة (الموضوع) هنا أن تحدد ارتباط مسألة التفاعل مع الواقع الخارج ومحاولة الإجابة عن التساؤلات والإثارات التي يطرحها هذا الواقع من خلال القرآن، بمنهج التفسير (الموضوعي) وحده دون التفسير التجزيئي”(14).
لكن يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام:
أولاً: كون المفسّر ينطلق من الخارج ليتحوّل بعد ذلك إلى القرآن هذا بنفسه كافٍ في صدق عنوان الموضوعي عليه بالنحو الأول، فعلّة تسميته بالموضوعي هو انطلاقه من الموضوع الخارجي، فإن صدق هذا العنوان على المنهج المتبّع في تفسير الآيات على النحو التجزيئي كان ذاك تفسيرًا موضوعياً بهذا النحو؛ فالعلاقة بين التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي ليست علاقة التباين لكي يقال ما يصدق عليه التجزيئي لا يصدق عليه الموضوعي بل التفسير الموضوعي يلتقي مع التفسير التجزيئي، لكنه يتقدمه خطوة كما أشار السيد الشهيد الصدر (قدّس سرّه)، أضف إلى ذلك أن الشهيد الصدر (قدّس سرّه) قد صرح بأن لا تباين حدّي بين التجربتين حيث قال: “وينبغي أن يكون واضحاً أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حدياً على مستوى الواقع العملي والممارسة التاريخية لعملية التفسير… ولكن الاتجاهين على أي حال يظلاّن على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحصيلتهما الفكرية”(15).
ثانياً: إن الانطلاق من الموضوع الخارجي لا كما صوره (قدّس سرّه) من أن المفسّر يعايش مشكلات عصره وتساؤلاته لكي يعرضها بعد ذلك على القرآن، فهذا في حقيقته هو الدور السلبي الذي أشار إليه السيد الشهيد الصدر (قدّس سرّه) وإنْ لم تكن سلبيته مطلقة، بل المقصود منه أن المفسّر يتشبع بالآراء والإشكالات والتساؤلات والنظريات المطروحة والتصورات والتصديقات التي توصل إليها الذهن البشري لكي يعرضها على القرآن فالفرق بين الأول والثاني أن الأول يذهب إلى القرآن خالي الذهن إلا من الأسئلة والمشكلات الموجودة في عصره، بينما الثاني يكون ذهنه مشبع بالتصورات والتصديقات والأفكار والاتجاهات، فيعرضها على القرآن ليرى ماذا يقول القرآن في هذه البضاعة. طبعاً هذا لا يعني أن المفسّر يفرض تصوراته وتصديقاته على القرآن، بل هو يطلب من القرآن رأيه في هذه الأفكار ويكون هنا دور التجربة البشرية متفاعل مع القرآن بنحو من أنحاء العلاقة الجدلية، فالتجربة البشرية تمد المفسر بأدوات لقراءة القرآن، والقرآن يمد التجربة البشرية بتصورات، وتصحيحات لمسارها.
ثالثاً: كلامه (قدّس سرّه) من أن المنهج المتبع من قبل بعض المفسرين التجزيئين هو الانطلاق من الموضوع الخارجي للوصول بعد ذلك للقرآن وضرب مثال لذلك صاحب المنار والميزان ومن ظلال القرآن(16)، هذا الكلام ينافيه تصريح بعضهم كصاحب الميزان (قدّس سرّه) وقد نقلنا كلامه سابقا.
فيما يخص حالة العمق والسطحية في المنهجين:
“فقد ذكر السيد الشهيد الصدر (قدّس سرّه): أن التفسير التجزيئي تفسير لفظي سطحي نسبياً، بينما التفسير الموضوعي تفسير عميق وتفسير للمعنى يتم من خلاله تعرف مصاديق المفاهيم وتطبيقاتها الخارجية، والواقع: أن هذا الأمر غير واضح، إذ يمكن أن يكون كلا التفسيرين عميقين، ولا داعي لافتراض اقتصار التفسير التجزيئي على المعنى اللغوي السطحي واستخلاص المفهوم للآية القرآنية أو المقطع القرآني وحده، وإنما يمكن التعمق والتعرف على كل مداليل تلك الآية حتى المرتبط منها بالمصاديق والتجسيدات الخارجية. ولذا لا يمكن أن تكون هذه الملاحظة -حسب رأينا- ميزة للتفسير الموضوعي على التفسير التجزيئي”(17).
وقد يلاحظ على هذا الكلام بأن التفسير التجزيئي إن كان يهدف فقط لتفسير آية أية دون التوصل إلى النظرية القرآنية، ودون الاستعانة بالتجربة البشرية فلا شك بأن هذا التفسير سيكون تفسيرا لفظيا لا محالة، وان كان يهدف إلى التوصل إلى نظرية قرآنية بالاستعانة بالتجربة البشرية فهو عينه التفسير الموضوعي. وأما الوصول إلى المصاديق الخارجية من خلال تفسير الآيات المتناثرة من دون التوصل إلى جامع ومركب نظري يجمع هذا الشتات متعذر لما ذكره السيد الشهيد من أن المفسر في هذا العصر لا يعيش الارتكاز الذي كان يعيشه المسلمون عصر صدور النص والذي يمكنه من فهم النص وتطبيقاته.
التجربة التفسيرية للشهيد الصدر والإثارات المعاصرة
طرحت في الآونة الأخيرة مجموعة من التساؤلات والإشكاليات تجاه الفكر والعطاء الديني الإسلامي، وهذه التساؤلات والإشكاليات نتيجة مشاكل متنوعة واجهت الفكر الديني، وأعاقت حركته نحو الإبداع والإنتاج. وهذه المشاكل ليست وليدة الساعة بل هي عبارة عن تراكم تاريخي مرت بها الأمة الإسلامية في سياق نشوئها التاريخي. وما يهمنا فعلاً هنا هو كيف عالجت أو لامست تجربة السيد الشهيد الصدر هذه التساؤلات والإشكاليات؟
الإشكاليات المعاصرة كثيرة والأسئلة متعددة ومتنوعة لكن سنحاول هنا عرضها عرضا بسيطا إلى بعض النماذج من هذه التساؤلات والإشكاليات:
1- السلفيّة (التفكير السلفي)(18): نقصد بالتفكير السلفي هو التفكير الذي يعيش زماناً غير زمانه، يعيش الماضي، ولكن بلباس الحاضر فهو دائم الاجترار لموضوعات الماضي، لمشاكل الماضي وقضاياه، لكي ينطلق منها لمعالجة قضايا الحاضر ومشاكله. والاجترار هذا لا يقتصر على المادة والموضوع بل يتجاوزه إلى المنهج والأسلوب؛ فهو يحاول معالجة مشاكله الحاضرة بمنهج تراثي اتبّعه السلف في التعاطي مع الموضوعات المختلفة التي عايشوها والقضايا التي واجهوها.
يقول شحرور: “السلفية كما نفهمها هي دعوة إلى اتباع خطى السلف بغض النظر عن مفهوم الزمان والمكان، أي أن هناك فترة تاريخية مزدهرة مرت على العرب استطاعوا فيها أن يحلوا مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، استطاعوا أن يبنوا دولة قوية منيعة استطاعت تحقيق العدالة بمفهومها الأنسب التاريخي، وبالتالي هؤلاء السلف هم النموذج، ويجب علينا أن نتبع خطاهم ونقلدهم ولا نخرج عن نمطهم. فالسلفي إنسان مقلِّد، إضافة إلى أنه قد أهمل الزمان والمكان واغتال التاريخ وأسقط العقل”(19). يشير شحرور هنا إلى الاجترار السلفي على مستوى المنهج والأسلوب في التعاطي مع الموضوعات والقضايا المعاصرة، فالتفكير السلفي يجعل من الماضي نموذجاً للاقتداء له في التعاطي مع قضايا الحاضر ولحل مشاكله.
ويمكن الإطلالة على السلفية من جهة أخرى كما ذكرنا في البداية، وهي الاجترار على مستوى القضايا والموضوعات حيث تعني “انغلاق العقل داخل دائرة أطروحات وقضايا تبلورت في وضع وحقبة معينين، فأصبحت هي التي تتحكم برؤية العقل للواقع، وتمنعه من تحديد أدواته وطرائقه بالاحتكاك مع التجربة المتغيرة والملاحظة المباشرة، وتجعله لا يعيش الواقع إلا على مستوى القضايا والأفكار المصاغة سابقا”(20).
يصف الدكتور غليون هذه الحالة بأنها: “معاناة من الدرجة الثانية، أو من وراء حجاب (ويكمن خطؤها في نظره) أنها تخضع الواقع إلى تحليل الأنظمة الشكلية والصورية للفكر، وتنتهي إلى قياس الواقع العملي على الواقع النظري”(21).
2- إشكالية الزمكان وثبات وحركة النص(22): إن الحياة الإنسانية في تطور دائم ونمو مستمر، وهذا يقتضي على الدوام تجدد الأفكار والقضايا والمشاكل والوقائع وغيرها، فما دام الزمن في حركة فالإنسان ومشاكله والعلاقات المحيطة به وقضاياه في تغير دائم ومستمر. كل هذا يفرض على الإنسان المسلم التعامل مع هذه الصيغ المتحركة بعقلية مرنة تستوعب المستجدّات والتطورات. ويعلم الجميع أن النص يمثل حالة ثابتة نسبياً وغير متغيرة، وهذا يثير تساؤلاً وهو كيفية استيعاب المتغيرات والمستجدات بهذا النص الثابت وما هي الصيغة المثلى للجمع بين المستجدات والمتغيرات وبين ثبات النص. في الوقت الذي اعتنى بهذه الإثارة مجموعة من طليعة الفقهاء المسلمين(23)، لم يعتن مجموعة من الفقهاء الإسلاميين بهذه المشكلة وإنما تجاوزوها وأغمضوا العين عنها وقد يكون ذلك لاعتقادهم بعدم وجود مشكلة.
يقول الدكتور الترابي: “إن الفقه (التقليدي)… مهما تفنن حملته بالاستنتاجات والاستخراجات، ومهما دققوا في الأنابيش والمراجعات لن يكون كافياً لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بها. ذلك أن قطاعات واسعة من الحياة قد نشأت من جراء التطور المادي، وهي تطرح قضايا جديدة تماماً في طبيعتها لم يتطرق إليها الفقه التقليدي، ولأن علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تماما، ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف عام تحقق مقتضى الدين اليوم ولا توافي المقاصد التي يتوخاها لأن الإمكانات قد تبدلت وأسباب الحياة قد تطورت والنتائج التي تترتب عن إمضاء حكم معيّن بصورته السالفة قد انقلبت انقلاباً تاما”(24).
تعرفنا سريعاً على بعض التساؤلات والإشكاليات المعاصرة التي يواجهها الفكر الإسلامي والتفكير الديني. وسؤالنا هنا كيف عالجت التجربة التفسيرية للشهيد الصدر (قدّس سرّه) هذه الإشكاليات؟ ليست مبالغة القول بأن التجربة التفسيرية للشهيد الصدر هي من التجارب القليلة التي أوجدت حلولا معقولة لهاتين الإشكاليتين، أو أنها لامست هاتين الإشكاليتين دون غيرها من التجارب التفسيرية.
بعدما تعرفنا على هذه التساؤلات والإشكاليات دعونا نتعرف على أنه كيف استطاعت تجربة السيد الشهيد الصدر أن توجد الحلول لهذه الإشكاليات والتساؤلات سابقة الذكر؟ أو لا أقل كيف لامست هذه النظرية هذه التساؤلات والإشكاليات؟
إن مشكلة الإنسان الذي يعيش التفكير السلفي أنه عندما يتوجه لدراسة النصوص الإسلامية يدرسها دراسة تجزيئية لا موضوعية، فيظل حبيس حقبة زمانية معينة، حبيس النص، يظل في حلقة مفرغة على الدوام حيث يكون اهتمامه هو النص، فهو ينطلق من النص لكي يصل بالأخير إلى النص بحسب تعبير السيد الشهيد. بينما الإنسان المسلم في القراءة الموضوعية والتوحيدية للقرآن أو للسنة أو للتاريخ يبدأ من الموضوع الخارجي، يبدأ من المشاكل المعاصرة من القضايا التي يعيشها إنسان اليوم، ويحاول أن يعرض هذه القضايا على القرآن على السنة على التاريخ الإسلامي، لكي يكون له موقف تجاه هذه القضايا المعاصرة، ولا يكتفي بالانطلاق من الموضوع الخارجي فقط، بل هو يحاول أن يعالج النصوص وأن يدرسها كجزء متكامل كوحدة موضوعية، كمفهوم متكامل عن القضايا والمشاكل المعاصرة، لكي يبدع مركبا نظريا يتعدى ظواهر الأحكام التفصيلية إلى نظرية متكاملة عن قضايا العصر. في هذه الصورة يكون الإنسان المسلم في حالة من الإبداع الدائم في حالة من المعاصرة والمواكبة لمستجدات الحياة في حالة حركة دائمة تجاه المبادئ والقيم والمعارف، ويبقى القرآن في حالة قيمومة دائمة على الحياة في عطاء مستمر لا ينقطع أبدا: {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً}(25).
وأما المشكلة الأخرى وهي كيفية استيعاب النص الثابت لمتغيرات الحياة ومستجداتها؛ فكيف يمكن للنص النازل على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منذ 1400 عام أن يعطي حلولا لمشاكل الإنسان المعاصر؟ وكيف يمكن لهذا النص الذي يتكون من مجموعة من الكلمات المحدودة أن يحدد الموقف والحكم من وإلى قضايا غير متناهية وغير محدودة؟!!
يجيبنا السيد الشهيد من خلال نظرته التفسيرية:
إن المعاني والمضامين في التفسير الموضوعي غير متناهية فالإنسان لا ينظر للفظ النص، إنما ينظر للموضوع الخارجي، للمستجدات، للوقائع الحادثة لكي يعرضها على النص القرآني ليستخرج منه موقفا تجاه هذه القضايا، وللوقوف على حقيقة هذا المعنى، وكيف أن معاني القرآن غير متناهية مع أن المدلولات اللفظية من الأمور المتناهية نوضح الآتي.
إنَّ للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا ومحكما ومتشابها كما صرحت بذلك الكثير من الروايات؛ فعن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الرواية، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر وبطن، قال: «ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع، قال الله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) نحن نعلمه»(26). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «إن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تنفني عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به»(27).
وهناك كثير من الروايات التي توضح بأن للقرآن ظاهرا وباطنا وتوضح أن في القرآن علم ما كان ويكون وأن عجائب القرآن لا تنقضي، مما يدل بوضوح على لا محدودية النص.
والذي يهمّنا من هذا هو أن نتعرف على معنى البطن والتأويل، ولو تمعّنا قليلاً في الرواية السابقة المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) لاتضح لنا معنى البطن والتأويل. وقد أشرنا سابقاً بأن تجربة السيد الشهيد التفسيرية هي عبارة عن ضرب من التأويل أو كما أسماه هو (تفسير المعنى).
اختلف العلماء في تحديد معنى التأويل؛ فمنهم من يرى أنه ينتمي إلى الحقل المعرفي (الابستمولوجي)، ومنهم من يرى أنه ينتمي للحقل الوجودي (الانطولوجي):
أنصار الحقل المعرفي:
هذا المذهب ينضوي تحته عدة آراء، ونكتفي بذكر رأي واحد من هذا المذهب، وهو رأي الشيخ محمد هادي معرفة حيث يقول في تعريفه التأويل بأنه “مفهوم عام، منتزع من فحوى الآية الواردة بشأن خاص، حيث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. و قـد عبر عنه بالبطن المنطوي عليه دلالة الآية في واقع المراد، في مقابلة الظهر المدلول عليه بالوضع والاستعمال، حسب ظاهر الكلام قال رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله): «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر و بطن»”(28).
أنصار الحقل الوجودي:
كذلك هذا المذهب ينضوي تحته مجموعة من الأراء المختلفة:
1- رأي الفيض الكاشاني: قال (قدّس سرّه): “وتحقيق القول في المتشابه وتأويله يقتضي الإتيان بكلام مبسوط من جنس اللباب، وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله ألف باب. فنقول وبالله التوفيق: إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحاً، وله صورة وقالبا، وقد تتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة، وإنما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لاتحاد ما بينهما، مثلاً لفظ القلم إنما وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك، بل ولا أن يكون جسما ولا كون النقش محسوساً أو معقولاً، ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب، بل مجرد كونه منقوشاً فيه وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه، فإن كان في الوجود شيء يستطر بواسطته نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم فإن الله تعالى قال: (علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته وحده من دون أن يكون معه ما هو خارج عنه”(29) فالمعنى الباطني هو حقيقة وجوهر الشيء، وقريب منه ما ذكره العلامة الطباطبائي(30).
2- رأي السيد الشهيد الصدر (قدّس سرّه): كما أشرنا سابقاً يرى السيد الشهيد أن معنى التأويل هو ما اصطلح عليه تفسير المعنى، “فتأويل الآيات المتشابهات -كما يقول السيد الشهيد- ليس بمعنى بيان مدلولها وتفسير معانيها اللغوية، بل هو ما تؤول إليه تلك المعاني، لأن كل معنى عام حين يريد العقل أن يحدده ويجسده ويصوره في صورة معينة، فهذه الصورة المعينة هي تأويل ذلك المعنى. وعلى هذا الأساس يكون معنى التأويل في هذه الآية هو ما أطلقنا عليه اسم تفسير المعنى”(31).
والاختلاف بين هذه الآراء غير واضح من حيث التطبيق والنتيجة وإن كان هناك فرق نظري وتصويري لكل من هذه الوجوه والآراء -بالنسبة لي على الأقل- خصوصا إذا راجعتَ تطبيقاتهم وأمثلتهم، فالعلامة مثلاً: مراراً يفسّر بعض الروايات المفسرة للآيات بأنها إما من قبيل الجري والتطبيق، وإما من قبيل البطنون، هذا إن دل على شيء فهو يدل على تداخل معنى التأويل والبطن بالصورة التي طرحها العلامة مع التطبيق والجري الذي هو التأويل والبطن برأي السيد الشهيد الصدر.
وإذا عرفنا هذا يتضح لنا كيف يمكن للألفاظ المحدودة استيعاب الحوادث اللامتناهية والوقائع المستجدة فللقرآن ظاهر وباطن، والظاهر هو مدلول اللفظ بحسب ما تسمح به معطيات اللغة، أما الباطن فهو ما يؤول إليه اللفظ لا المدلول اللفظي للكلمة، فالباطن إنما هو أمر يتعدى اللفظ ليبحث عن المعنى الخارجي للفظ، ولو أن القرآن وقف على المدلولات اللفظية بحسب الوضع والاستعمال اللغوي لما بقي من القرآن شيء، ولمات القرآن في حياتنا، فعن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قـال: «ولـو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية، لما بقي من القرآن شي، ولكن القرآن يجري أوله على آخره، ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها، هم منها من خير أو شر»(32)، فالقرآن يجري في الناس مجرى الشمس والقمر فهو دائم الإشراق ودائم العطاء في حياة الإنسان المسلم، «وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر»(33).
ومن هنا يتضح لنا أن تجربة السيد الشهيد الصدر التفسيرية لم تكن كغيرها من التجارب تهدف لإجلاء المعنى الظاهر للقرآن، بل كان هدفها استنطاق المعنى الباطن، فكانت بحسب تعبير الروايات تأويلاً للآيات لا تفسيراً لها، فهي تبحث عن الموضوعات والمعاني الخارجية التي تؤول إليها مدلولات الآيات لا عن المدلولات الوضعية والاستعمالية للألفاظ. “ولـهـذا الـمعنى عرض عريض، ولعله هو الكافل لشمول القرآن وعمومه لكل الأزمان والأحيان فلولا تلك المفاهيم العامة، المنتزعة من موارد خاصة -وردت الآية بشأنها بالذات- لما بقيت لأكثر الآيات كثير فائدة، سوى تلاوتها وترتيلها ليل نهار”(34).
ولذلك يقول السيد الشهيد: “ومن هنا تبقى للقرآن حينئذ قدرته على القيمومة دائماً، قدرته على العطاء المستجد دائماً، قدرته على الإبداع، لأن المسألة هنا ليست مسألة تفسير لفظ؛ فإنَّ طاقات التفسير اللغوي ليست طاقات لا متناهية بينما القرآن الكريم، دلت الروايات على أنه لا ينفد، وصرح القرآن الكريم بأن كلمات اللّه لا تنفد، القرآن الكريم عطاء لا ينفد بينما التفسير اللغوي ينفد؛ لأن اللغة لها طاقات محدودة، وليس هناك تجدد في المدلول اللغوي، ولو وجدت لغة أخرى بعد القرآن، لا معنى لأنْ يفهم القرآن من خلال لغة جديدة أو مصطلحات جديدة أو ألفاظ تحمل مدلولات وضعيّة استهدفت بعد القرآن.
إذن هذا العطاء الذي لا ينفد للقرآن، هذه المعاني التي لا تنتهي للقرآن التي نص عليها القرآن نفسه، ونصت عليها أحاديث أهل البيت، هذه الحالة من عدم النفاد، تكمن في هذا المنهج، منهج التفسير الموضوعي؛ لأننا نستنطق القرآن، وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء دائنا، لأن في القرآن نظم ما بيننا، ولأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الأرض”(35).
هذه بعض الملامح الإبداعية في التجربة التفسيرية للسيد الشهيد الصدر، وإن كانت هذه التجربة أوسع بكثير مما تناولناه وتعرضنا له، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه، والميسور لا يسقط بالمعسور.
تغمد الله روح شهيدنا الغالي بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الهوامش والمصادر
- (1) المدرسة القرآنية. ص:294.
- (2) م.ن ص:295.
- (3) تفسير الصافي:ج1،ص:30.
- (4) المدرسة القرآنية ص:31.
- (5) م.ن ص:23.
- (6) م.ن ص:28.
- (7) م.ن ص:30.
- (8) م.ن ص:34.
- (9) م.ن ص:35.
- (10) تفسير الميزان، ص7.
- (11) م.ن ص:9.
- (12) م.ن ص:11.
- (13) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج 1: ص:5 – 6.
- (14) تفسير سورة الحمد ص:99.
- (15) المدرسة القرآنية ص:24.
- (16) تفسير سورة الحمد ص:100.
- (17) م.ن ص: 104.
- (18) للسلفية معان متعددة، وليس المقصود هنا كل تلك المعاني، بل بعض المعاني، فتنبه. وراجع في هذا الصدد ما كتبه محمد عابد الجابري وبرهان غليون في أكثر كتبهما.
- (19) الكتاب والقرآن ص:34.
- (20) اغتيال العقل ص:51.
- (21) م.ن ص:51.
- (22) من أراد التفصيل فليراجع كتاب الاجتهاد والحياة حوار على الورق، والعدد الأول والثاني من كتاب الحياة الطيبة.
- (23) في طليعتهم السيد الشهيد الصدر والإمام الخميني والشهيد المطهري وغيرهم من العلماء الطليعيين.
- (24) تجديد أصول الفقه. حسن الترابي ص:7.
- (25) الكهف:109.
- (26) تفسير الصافي:ج1،ص30.
- (27) نهج البلاغة.
- (28) التفسير والمفسرون ج1 ص23.
- (29) تفسير الصافي:ج1،ص32.
- (30) راجع تفسير الآيات المتشابها ت والمحكمات من سورة آل عمران.
- (31) المدرسة القرآنية ص304.
- (32) تفسير العياشي، ج1، ص 10، رقم7 نقلاً عن تفسير ومفسرون.
- (33) تفسير الصافي:ج1،ص30.
- (34) تفسير ومفسرون ج1 ص:24.
- (35) المدرسة القرآنية ص:31.