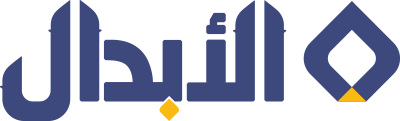بعض واجبات الحاكم كما شرحها ابن ميثم البحراني

مقدمة
- مقدمة
- النموذج الأول: من أوامره لمالك الأشتر
- تقوى الله وطاعته:
- تقديم عبادة الله:
- التحكم بالهوى:
- الرحمة للرعية:
- العفو والصفح:
- ترك الغلظة:
- التحكم في القوة الغضبية:
- نزع الحقد:
- عدم الاغترار بالسلطة:
- النظر لعظمة الله:
- الحذر من التجبر والعجب:
- إنصاف الله والناس:
- حب العدل:
- توزير الأخيار:
- ثمّ أمره في اعتبارهم واختيارهم بأوامر:
- الإحسان للرعية:
- الأخذ عن العلماء:
- حسن اختيار الجند:
- أمّا الأوصاف:
- وأمّا الأوامر:
- الدقة في اختيار القضاة:
- وأمّا الأوامر:
- اختبار المسؤولين قبل نصبهم:
- أمّا الأوصاف:
- وأمّا الأوامر:
- عمارة الأرض:
- الاهتمام بالفقراء:
- وأمّا الأوامر:
- الجلوس لأهل الحاجات:
- عدم تفضيل المقربين:
- دفع الشبهة عن نفسه:
- الرغبة في الصلح:
- الوفاء بالعهد:
- ورغَّب في ذلك بوجهين:
- ترك سفك الدماء:
- معالجة القتل الخطأ:
- ترك المن والتزيُّد والخُلف:
- ترك الاستئثار على الناس:
- النموذج الثاني: ما لا ينبغي للوالي
- النموذج الثالث: من كتاب إلى أصحاب المسالح
- خاتمة:
- الهوامش:
لا يتردّد مطّلع على تاريخ الأمّة الإسلامية في أنّها اختلفت في تحديد الولاة والحكام، وأنّ المذاهب تعدّدت في صفات الحاكم الذي يحكم المسلمين وشروط شرعية حكمه، وللمسلمين من أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) رؤيتهم التي تلقوها عن أئمتهم (عليهم السلام)، وقد فصّل في بيان هذه الرؤية العلماء فكانت مصنفاتهم الخاصة بالمسألة فيها ما يروي الغليل ويشفي العليل، فضلاً عن ما ذكروه في مطاوي الكتب والمؤلفات.
ولعلماء هذه المدرسة في البحرين وفي مختلف العصور جهودهم المباركة في هذا الباب، والمطالع لفهارس مصنفاتهم يتضح له ذلك بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك في أنّهم قد بالغوا في ذلك مما أثمر حضوراً كبيرا للمفهوم -الذي طرحه المعصوم- في نفوس عامة أهل البحرين من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم.
ومع ذلك انبرى بعض من الطائفيين ومن لا معرفة لهم بالتاريخ مشككاً ومدلّساً بجهد محموم للتشويش على هذه العقيدة والرؤية الصافية التي ورثها أبناء البحرين بدماء الأئمة والعلماء، ومن الأفكار التي يحاوَل غرسُها في ذهن المجتمع البحراني فكرة أن الحاكم الذي يتسلط على البلاد بالغلبة والقهر له ولاية إلهية وأنه من أولي الأمر المفروضة طاعتهم، ومع أن هذه الفكرة لا يمكن لها أن تنبت في تربة كتربة البحرين الولائية بامتياز إلا أنّهم يصرون على أنّ المفهوم الحاضر للحاكم في أذهان الناس هو مفهوم غريب عن البحرين وأنه مستورد من إيران أو غيرها.
ولذلك اخترت أن أستحضر من تراث علماء البحرين بعض ما دُوِّن في هذه المسألة ووقع الاختيار على شرح نهج البلاغة للعالم الرباني الشيخ ميثم البحراني(1) (قدِّس سرُّه)، لما لهذا السِّفر من قيمة علمية راقية باعتراف مختلف علماء المسلمين -من كان منصفاً منهم- ولكون الشيخ شمساً ساطعة لا يمكن أن يُنكر انتماؤه للبحرين وأنّه من أعلام علماء شيعة أهل البيت (عليهم السلام) في القرن السابع الهجري، وهي فترة زمنية سابقة لانتشار مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في إيران، مما سيبيّن بجلاء أنّ ما يعتقد به شيعة أهل البيت (عليهم السلام) في البحرين اليوم هو إرث علمي ضارب بجذوره تاريخياً وقد توارثه أهل أوال عبر قرون من الزمن.
والمطالع لما بيّنه الشيخ ميثم في شرحه هذا لا يستطيع أن يفصله عن بيانات أمير المؤمنين (عليه السلام)، فيتم لنا بيان ارتباط الرؤية الإجمالية التي يحملها البحارنة بما أسّسه الأئمة المعصومون من أهل بيت النبي (عليهم السلام)، ومن الواضح أنه في هذه العجالة لا يمكن أن يستقصى كلُ ما ذكره الشيخ في شرح كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) المتعلقة بالحاكم والوالي وإنّما يكتفى بنماذج مختارة مما يساعد في توضيح مدى البون الشاسع بين حال المتسلطين على رقاب أبناء الأمّة والحال الذي رسمه الإسلام للحاكم على المسلمين.
النموذج الأول: من أوامره لمالك الأشتر
عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر من أهم الوثائق التي ورثها المجتمع الإنساني حول إدارة الحكم، وقد أودع فيه كنوزاً ما زالت البشرية تحتاج إليها وأعناق المستضعَفين تشرئب نحوها، وصفه الشريف الرضي (رحمه الله) بقوله: “أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن”(2)، وأجاد الشيخ ميثم (قدِّس سرُّه) في شرح وبيان هذا العهد وذكر فيه ما لا غنى لحاكم -يريد صلاح نفسه ورعيته- عنه، ونحن نذكر بعض ما انتخبناه من درر هذا الشرح والله الموفق.
تقوى الله وطاعته:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وإِيْثَارِ طَاعَتِهِ، واتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ وسُنَنِهِ… وأَنْ يَنْصُرَ اللَّه سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ ويَدِهِ ولِسَانِهِ… وأَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ، ويَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ…»(3).
وقال البحراني (قدِّس سرُّه): “تقوى اللَّه وخشيته، وقد سبق بيان كونها أصلا لكلّ فضيلة”(4). تقدم من الشيخ بيان هذا في عدة مواضع فما أكثر الموارد التي ذكر فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) التقوى ومنها قوله: «فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ، وذَخِيرَةُ مَعَادٍ، وَعِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ، بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَيَنْجُو الْهَارِبُ، وَتُنَالُ الرَّغَائِب»(5)، والأمر بتقوى الله وطاعته هنا إجمالي سيفصله بأوامر متعددة لاحقاً، وعلى كل حال فلا يخفى ما لتقوى الله سبحانه من أثر كبير في سلوك الإنسان، وأنّها أقوى رادع له عن مخالفة القوانين وهي التي تحافظ على انسجام باطن الإنسان وظاهره، فلا يأتي في السر ما يرفضه في العلن؛ لما يستشعره المتّقي من رقابة الله عليه. ولا يمكن أن تُضمن مراعاة الأوامر اللاحقة إلا من المتّقي الحقيقي فغيره تمنعه أغلال الشهوات من طاعة الله سبحانه ولذلك أمر بالعفة عنها، قال الشيخ (قدِّس سرُّه): «أن يكسر من نفسه عند الشهوات. وهو أمر بفضيلة العفّة… [أي] أن يكفّها ويقاومها عند الجمحات. وهو أمر بفضيلة الصبر عن اتّباع الهوى… [وهو بذلك] ينصر اللَّه سبحانه بيده وقلبه ولسانه في جهاد العدوّ وإنكار المنكرات…»(6). لا لحاجة من الله سبحانه وإنّما لما في ذلك من خير للحاكم والأمّة، ولا يخفى على مطالع لتاريخ المسلمين ما حاق بأمّة الإسلام من الضعف والهوان والانسلاخ عن قيم الرسالة المحمدية، حتى قال بعضهم أنه يرى في بلاد الإسلام مسلمين بلا إسلام، قد تفشى فيهم الفساد والظلم واصطلمهم الأعداء وصاروا كغثاء السيل وزبده، حيث زهد حكام المسلمين في التقوى واتبعوا الشهوات وضيعوا كتاب الله.
تقديم عبادة الله:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «واجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وبَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ، وأَجْزَلَ تِلْكَ الأَقْسَامِ، وإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِّيَّةُ، وسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ.
ولْيَكُنْ فِي خَاصَّةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّهِ دِينَكَ: إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ، الَّتِي هِيَ لَهُ خَاصَّةً، فَأَعْطِ اللَّه مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ ونَهَارِكَ، ووَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْرَ مَثْلُومٍ ولَا مَنْقُوصٍ، بَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَغَ…»(7).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): «أن يجعل لنفسه في معاملته للَّه أفضل تلك المواقيت أي الأوقات المفروضة للأفعال، وأجزل أقسام الأفعال الموقّتة، فأفضلها أبعدها عن الشواغل الدنيويّة وأقربها إلى الخلوة باللَّه سبحانه، ونبّه… على أن أصلح الأعمال أخلصها للَّه… [و] أن يكون في خاصّة ما يخلصه للَّه في دينه إقامة فرائضه فيخصّها بمزيد عناية منه ورعاية… [و] أن يعطي اللَّه من بدنه في ليله ونهاره: أي طاعة وعبادة… [و] أن يوفّى ما تقرّب به إلى اللَّه من ذلك…»(8).
روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي؛ أَمْلأْ قَلْبَكَ غِنًى، ولا أَكِلْكَ إِلى طَلَبِكَ، وعَلَيَ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَكَ، وَأَمْلأَ قَلْبَكَ خَوْفاً مِنِّي…»(9). ويتضح منه أهمية أن يخصص الحاكم المسلم وقتاً مختصاً بالعبادة، فإنّ أحد أهم أسباب جور الحكام على الرعايا هو طمعهم وشح أنفسهم، وحيثما تفرغوا للعبادة ملأ الله قلوبهم بالغنى والقناعة؛ فينصرفوا لخدمة رعاياهم وإصلاح أمر ممالكهم، والمراد بالعبادة هنا -كما يظهر بأيسر النظر- العبادات الخاصة المنصوصة من الصلاة والدعاء والمناجاة وقراءة القرآن، وإن كانت عامة أفعال الإنسان تكون عبادة إذا قصد بها وجه الله وسلمت من موانع القبول، وكذلك فإن ما تورثه العبادة من خشية الله خير المعين على التقوى التي تقدم الحديث عنها.
التحكم بالهوى:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَامْلِكْ هَوَاكَ وشُحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ»(10).
هذا الأمر من الأوامر المفصلة بعد ما أجمله سابقا من الأمر بالتقوى، وفيه يأمر الحاكمَ بحفظ نفسه عن أن يهلكها الهوى، قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أن يملك هواه في شهوته وغضبه فلا يتّبعهما، ويشحّ بنفسه عمّا لا يحلّ لها من المحرّمات… تفسير لذلك الشحّ بما يلازمه وهو الإنصاف والوقوف على حدّ العدل في المحبوب فلا تقوده شهوته إلى حدّ الإفراط فيقع في رذيلة الفجور، وفي دفع المكروه فلا يقوده غضبه إلى طرف الإفراط من فضيلة العدل فيقع في رذيلة الظلم والتهوّر. وظاهر أنّ ذلك شحّ بالنفس وبخل بها عن إلقائها في مهاوي الهلاك.”(11)
الهوى من أخطر الأعداء على النفس فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم…»(12)، والروايات في هذا المعنى كثيرة وضرر اتباع الهوى لا يحيق بالنفس فقط بل يتعداها للغير ممن تؤثر خيارات الإنسان في حياتهم ولا شك في أنّ تأثير الحاكم أوسع من تأثير غيره، وحاكم يملكه هواه يفْجُر ويطغى وتاريخ البشرية حافل بالنماذج التي ذبحت فيها إنسانية البشر بسبب أهواء الحكام والولاة.
الرحمة للرعية:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، والْمَحَبَّةَ لَهُمْ، واللُّطْفَ بِهِمْ، ولَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ…»(13).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): «أن يشعر قلبه الرحمة للرعيّة والمحبّة واللطف بهم. وهي فضائل تحت ملكة العفّة: أي اجعل هذه الفضائل شعاراً لقلبك…»(14)، الشِّعار: ما استشعرت به من اللباس تحت الثياب. سمّي به لأنه يلي الجسد دون ما سواه من اللباس(15)، فالمطلوب من الحاكم أن تكون الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم لباس قلبه، وإذا كان هذا حاله فلن يظلمهم ولن يعتدي عليهم وسيراعي مصالحهم وهذا حقهم فلن يكون في الرعية إلا أحد اثنين إما أخ في الدين والعقيدة وإما نظير في الخلق، وحيث يصدر منهم خطأ أو تقصير مقتضٍ للعقوبة -وهذا هو المتوقع إذ ليسوا معصومين- فيكون علاجه بالمحبة واللطف لا بالانتقام والتشفي.
العفو والصفح:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وصَفْحِكَ…»(16).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أن يعفو ويصفح عنهم، وهو فضيلة تحت الشجاعة… وفي أمره بإعطاء العفو مثل الَّذي يجب أن يعطيه اللَّه من عفوه أتمّ ترغيب في العفو وأقوى جاذب إليه، وكذلك قوله: «فإنّك فوقهم، إلى قوله: وابتلاك بهم» تخويف من اللَّه في معرض الأمر بالعفو واللطف…”(17)، تقدم أنّه ليس أحد من الرعية فوق أن يخطئ أو يزل، والمطلوب من الحاكم أن يعفو ويصفح ملاحظاً أنّه أيضاً ليس فوق أن يخطئ وهو طالب عفو الله عن خطئه -وإن كان فوق الحاكم والٍ فهو بحاجة لعفوه عند التقصير أيضاً- والمطلوب أن يترافق ذلك مع العدل والإنصاف لا أن يكون وفق الهوى؛ فقد تقدم الأمر بالتحكم فيه، ولا يخفى أهمية ذلك مع وجود الشواهد العديدة على تحكّم الهوى في حالات عفو الحكام عن المقربين والمتنفذين وتغليظهم العقوبة على المستضعفين، بل قد يشاهد العفو عن المجرمين المفسدين في الأرض بينما يبقى المطالبون بالإصلاح في السجون.
ترك الغلظة:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ…»(18).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “نهاه أن ينصب نفسه لحرب اللَّه. وكنّى بحربه عن الغلظة على عباده وظلمهم ومبارزته تعالى فيهم بالمعصية… وكنّى بعدم اليدين عن عدم القدرة، يقال: ما لي بهذا الأمر يد، إذا كان ممّا لا يطاق…”(19)، الغلْظَةُ، ضِدُّ الرِّقَّةِ في الخَلْق والطَّبْعِ والفِعْلِ والمَنْطِقِ والعَيْشِ ونَحْوِ ذلِكَ… ورَجُلٌ غَلِيظٌ، أَي فَظٌّ، ذُو قَساوَةٍ. ورَجُلٌ غَلِيظُ القَلْبِ، أَي سَيّء الخُلُقِ. وأَمْرٌ غَلِيظٌ: شَدِيدٌ صَعْبٌ(20)، يتذرع الظالم من الحكام بالقوانين ليبطش بالضعفاء والمقهورين فهو شديد غليظ لا يأخذ أحدهم برخصة في الوقت نفسه الذي يغض النظر عن أهل الحظوة عنده ويتساهل في عقوبتهم، وهذا محاربة لله (سبحانه وتعالى) حيث إنّه أمر بالعدل، وليس غريباً عنك أخذ المضطهدين بالتهمة والظن، والعفو عن المجرمين بدعوى غياب البينات والأدلة، كل ذلك غفلة عن نظر الله وإهمالا لوعيده.
التحكم في القوة الغضبية:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ، ولا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ، ولا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً»(21).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “نهاه عن الندم على العفو، وعن التبجّح بعقوبة الغير والتسرّع إلى الغضب الَّذي يجد منه مندوحة. فإنّ ذلك كلَّه من لوازم إعطاء القوّة الغضبيّة قيادها. وقد علمت أنّها شيطان تقود إلى النار”(22)، هنا ثلاثة أمور نهى عنها الإمام (عليه السلام) وقد تعلقت بلجم جماح القوة الغضبية وذلك لأن “الأفعال المنسوبة إلى دفع المضرة كدفاع الإنسان عن نفسه وعرضه وماله ونحو ذلك… هي الصادرة عن المبدأ الغضبي”(23)، أما كيف ارتبطت الأمور الثلاثة بالقوة الغضبية فتفصيله:
أما العفو فهو من فضائل القوة الغضبية وقد ذكر علماء الأخلاق أنه ضد للانتقام وهذا نتيجة للغضب حيث إنّ “قوة الغضب تتوجه عند ثورانها إما إلى دفع المؤذيات إن كان قبل وقوعها، أو إلى التشفّي والانتقام إن كان بعد وقوعها”(24)، والندم على العفو إما لاستعار نار الانتقام وإما لسوء الظن بالمعفو عنه وإما للخوف منه أو من العفو وكلها من رذائل القوة الغضبية.
وأما التبجح بالعقوبة، فالتبجح بالشيء هو الفخر به(25)، والفخر بعض أصناف التكبر وهذا من رذائل القوة الغضبية(26).
وأما التسرع فهو العجلة وهي من رذائل القوة الغضبية كذلك(27)، وهو هنا التسرع إلى الغضب فكأنه صب الزيت على النار.
و«الْبَادِرَةُ: ما يَبْدُرُ من حدة الرجل عند الغضب»(28).
وفي موضع آخر من عهده هذا أيضاً قال الأمير (عليه السلام): «امْلِكْ حَمِيَّةَ أَنْفِكَ، وسَوْرَةَ حَدِّكَ، وسَطْوَةَ يَدِكَ، وغَرْبَ لِسَانِكَ، واحْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ وتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ…»(29).
وهناك قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمره أن يملك حميّة أنفه: أي أنفته ممّا يقع من الأمور المكروهة، وسورة حدّه، وحدّة لسانه وملكه لهذه الأمور إنّما يكون بالاحتراس عن تعدّى قوّته الغضبيّة ووقوفه في فعلها على حاقّ الوسط بحيث لا يعبر فيها إلى حدّ الإفراط فيقع في رذيلة التهوّر ويلزمه في تلك الرذيلة الظلم… [حيث] أمره بالاحتراس من تلك الأمور وأرشده إلى أسبابه وهو كفّ البادرة وتأخير السطوة إلى حين سكون الغضب ليحصل له بذلك الاختيار في الفعل والترك الَّذي عساه مصلحة…”(30).
وكم يؤسف لحال الأمّة الإسلامية وأنت ترى القرارات الانفعالية والعقوبات الانتقامية التي تصدر بدون رويّة وتؤدي إلى جرائم يندى لها جبين البشرية، ويوصم بها الإسلام الذي حكم بالحلم والعفو وساد بهما.
نزع الحقد:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ…»(31).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): «أمره بنزع الحقد وعقد ما عقده في قلبه منه لكونه من الرذائل الموبقة وأن يقطع أسبابه من قبول السعاية وأهل النميمة»(32)
الحقد ثمرة للغضب فـ«الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال، رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا»(33)، والعقدة من قولهم: «عَقَدَ قلبه على شيء: لم ينزع عنه»(34)، ومن المهم أن يحرص الحاكم على نزع الحقد من قلبه طلباً لراحة نفسه، أولاً: حيث إنّ الروايات في كون نفس الحقود معذبة كثيرة، منها ما روي عن الإمام العسكري (عليه السلام): «أَقَلُّ النَّاسِ رَاحَةً الْحَقُود»(35)، وثانياً: أن في ذلك نزعا للحقد من قلوب الرعية نحوه، ويدل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «احْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِك»(36)، وما أحوج أمّة الإسلام لتآلف القلوب خصوصاً بين الحاكم ورعيته فإنّه لا يمكن أن تتقدم البلاد بدون ذلك.
عدم الاغترار بالسلطة:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ…»(37).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “نهاه أن يأمر بما لا ينبغي الأمر به ويخالف الدين، ونهى عن ما عساه يعرض في النفس من وجوب طاعة الخلق لإمرته فإنّ عليهم أن يسمعوا وعليه أن يأمر فإنّ ذلك فساد في القلب والدين،… وهو من وجوه ثلاثة:
أحدها: أنّه إدغال في القلب وصرف له عن دين اللَّه، وهو معنى إفساده.
الثاني: أنّ ذلك منهكة للدين وإضعاف له.
الثالث: إنّه مقرّب من الغِيَر لكون الظلم من أقوى الأسباب المعدّة باجتماع همم الخلق على زواله، وإليه الإشارة بقوله تعالى «إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»(38)…”(39).
وما أسهل اغترار ذوي السلطة بسلطانهم وكم شهدت بلاد المسلمين النكبة تلو النكبة بسبب مُحْدَثي السلطة الذين يصدرون القرارت والأوامر بلا معرفة أو دراسة وبلا مشاورة أهل الخبرة، فتكون النتيجة أن تخسر الأمّة قدراتها ما دامت في سلطانهم لا يرعوون ولا يرتدعون.
النظر لعظمة الله:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وَ إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَة، فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ…»(40).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أرشده إلى دواء داء الأُبّهة والكبر الَّذي عساه يعرض له في سلطانه وولايته، وذلك أن ينظر إلى عظمة اللَّه تعالى فوقه وقدرته على ما لا يملكه من نفسه ولا يستطيعه جلباً لها، أو دفعاً عنها فإنّ ذلك يسكِّن داء الكبر الَّذي يحدث له فيطفيه ويكسر حدّة غضبه ويردّه إليه ما قهرته قوّته الغضبيّة من عقله فغرب عند جماحها…”(41).
بيّن الأمير (عليه السلام) وتبعه الشارح (قدِّس سرُّه) العلاج العلمي للكبر، فالقوة الغضبية عندما تسيطر على النفس وتأخذها للتكبر في جانب الإفراط تعالج علميا بمثل ما ذكر مما يُعرّفها بحجمها الحقيقي.
الحذر من التجبر والعجب:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِيَّاكَ ومُسَامَاةَ اللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ والتَّشَبُّهً بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ…»(42).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “حذّره عن التعظيم والتجبّر، ونفّر عن ذلك بكونهما مساماة وتشبّها به، وبأنّ التكبّر يستلزم أن يذلّ اللَّه صاحبه ويهينه.
وتقدير الاحتجاج: فإنّك إن تجبّرت واختلت يذلَّك اللَّه ويهينك…”(43). والأمثلة على إذلال الله (عزَّ وجل) للطغاة كثيرة في التاريخ وهي بمرأى لمن أراد الاعتبار، هذا في الدنيا وأما في الآخرة فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «الْكِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ؛ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ»(44).
وفي موضع آخر من العهد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإِيَّاكَ والإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ… فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ، لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِين»(45).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “حذّره الإعجاب بنفسه، والثقة بما يعجبه منها، وحبّ الإطراء.
والأخيران سببان لدوام الإعجاب ومادّة له… وقوله: «ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين». يحتمل وجهين: أحدهما: أنّه لمّا كان الإعجاب من الهلكات لم ينفع معه إحسان المحسن فإذا تمكَّن الشيطان من الفرصة وزيّن الإعجاب للإنسان وارتكبه محقّ لذلك ما يكون له من الإحسان.
والثاني: إنّ المعجب بنفسه لا يرى لأحد عنده إحساناً فيكون إعجابه ماحقاً لإحسان من أحسن إليه، ولمّا كان مبدئ الإعجاب هو الشيطان كان الماحق لإحسان المحسن أيضاً هو الشيطان فلذلك نسبه إليه…»(46).
إنصاف الله والناس:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَنْصِفِ اللَّه وأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ…»(47).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمره بإنصاف اللَّه وإنصاف الناس من نفسه وأهل هواه من رعيّته، فإنصاف اللَّه العمل بأوامره والانتهاء عن زواجره مقابلاً بذلك نعمه، وإنصاف الناس العدل فيهم والخروج إليهم من حقوقهم اللازمة لنفسه ولأهل خاصّته…”(48).
«الإِنْصَاف: إعطاء الحق»(49)، ومن حق الله المنعم -على عباده بنعم جلت عن أن تحصى- أن تشكر نعمه، وليس لعاقل أن يظن المقدرة على شكر نعم الله سبحانه فلا أقل من عدم معصية الله بنعمه فإنّ ذلك من قبيح الإثم، ولا يظنَّن أحد أن بالله (عزَّ وجل) حاجة لشكر الشاكرين فـ «مَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ »(50). وسيأتي حديث حول العدل الذي هو إنصاف الناس ويدل على ذلك غير ما تقدم قول الأمير في موضع آخر في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والْإِحْسانِ»(51)، «العدل: الإنصاف، والإحسان: التّفضّل»(52).
حب العدل:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وأَجْمَعُهَا لِرِضَا الرَّعِيَّةِ…»(53).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمره أن يكون أحبّ الأمور إليه أقربها إلى حاقّ الوسط من طرفي الإفراط والتفريط وهو الحقّ، وأعمّها للعدل، وأجمعها لرضاء الرعيّة فإنّ العدل قد يوقع على وجه لا يعمّ العامّة بل يتّبع فيه رضاء الخاصّة، ونبّه على لزوم العدل العامّ للرعيّة وحفظ قلوب العامّة وطلب رضاهم بوجهين: أحدهما: أنّ سخط العامّة لكثرتهم لا يقاومه رضاء الخاصّة لقلَّتهم، بل يجحف به ولا ينتفع برضاهم عند سخط العامّة، وذلك يؤدّي إلى وهن الدين وضعفه أمّا سخط الخاصّة فإنّه مغتفر ومستور عند رضاء العامّة فكان رضاهم أولى.
الثاني: أنّه وصف الخاصّة بصفات مذمومة تستلزم قلَّة الاهتمام بهم بالنسبة إلى العامّة، ووصف العامّة بصفات محمودة توجب العناية بهم…”(54).
لا شك في أنّ إقامة العدل مع المحافظة على رضا العامة والخاصة من خير الأمور إلا أنه مما لا يكاد يكون ممكناً لما يوجد في نفوس البشر من الأثرة وحب الحظوة، فإذا دار الأمر بين تضييع العدل وإقامته فإقامته أولى وهو ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم حذراً من أن ينطبق عليه قول رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُتَسَلِّطٌ لَمْ يَعْدِلْ…»(55)، كما أن العدل يكون ببسط العطاء للجميع وتنفيذ القانون على الكل، إلا أن بعض الحكام قد يجنح بإعطاء الخاصة حقوقهم وتنفيذ القانون عليهم وفي الوقت نفسه يحرم العامة من العطاء ويحيف عليهم حين القضاء وليس هذا من الخير في شيء، وليس بعيداً عنك ما تمارسه بعض السلطات من منع المعارضين لها حقوقهم وإعطاء الحقوق الموالين لها وهذا بما ذكرناه شبيه ولعله هو مراد الشارح بقوله: “فإنّ العدل قد يوقع على وجه لا يعمّ العامّة بل يتّبع فيه رضاء الخاصّة”. والله العالم.
توزير الأخيار:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً… وأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ… مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ…»(56).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “لمّا كان من الأعمال الصالحة اختيار الوزراء والأعوان نبّهه على من لا ينبغي استصلاحه لذلك ليجتنبه ومن ينبغي ليرغب فيه، فمن لا ينبغي هو من كان للأشرار من الولاة قبله وزيراً ومشاركاً لهم في الآثام، ونهاه عن اتّخاذه بطانة وخاصّة له…
وقوله: «ممّن له مثل آرائهم» تميز لمن هو خير الخلف من الأشرار وهم الَّذين ينبغي أن يستعان بهم، وبيان لوجه خيريّتهم بالنسبة إلى الأشرار، وهو أن يكون لهم مثل آرائهم ونفاذهم في الأمور وليس عليهم مثل آصارهم ولم يعاون ظالماً على ظلمه. ثمّ رغَّب في اتّخاذ هؤلاء أعواناً… أمّا أنّهم أخفّ مؤونة فلأنّ لهم رادعاً من أنفسهم عمّا لا ينبغي لهم من مال، أو حال فلا يحتاج في إرضائهم أو ردعهم ممّا لا ينبغي إلى مزيد كلفة بخلاف الأشرار والطامعين فيما لا ينبغي، وبحسب قربهم إلى الحقّ ومجانبتهم للأشرار كانوا أحسن معونة وأثبت عنده قلوباً وأشدّ حنوّاً عليه وعطفاً وأقلّ لغيره إلفاً،… ثمّ ميّز من ينبغي أن يكون أقرب هؤلاء إليه وأقواهم في الاعتماد عليه بأوصاف أخصّ: أحدها: أن يكون أقوَلَهُم بمرّ الحقّ له.
الثاني: أن يكون أقلَّهم مساعدة له فيما يكون منه ويقع من الأمور الَّتي يكرهها اللَّه لأوليائه…
ثمّ أمره في اعتبارهم واختيارهم بأوامر:
أحدها: أن يلازم أهل الورع منهم والأعمال الجميلة وأهل الصدق، وهما فضيلتان تحت العفّة.
الثاني: أن يروضهم ويؤدّبهم بالنهي عن الإطراء له، أو يوجبوا له سروراً بقول ينسبونه فيه إلى فعل ما لم يفعله فيدخلونه في ذمّ قوله تعالى: «ويُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا»…(57).
الثالث: نهاه أن يكون المحسن والمسيء عنده بمنزلة سواء… وسرّه أنّ أكثر فعل الإحسان إنّما يكون طلباً للمجازاة بمثله خصوصاً من الولاة وطلبا لزيادة الرتبة على الغير وزيادة الذكر الجميل مع أنواع من الكلفة في ذلك. فإذا رأى المحسن مساواة منزلته لمنزلة المسيء كان ذلك صارفاً عن الإحسان وداعياً إلى الراحة من تكلَّفه، وكذلك أكثر التاركين للإساءة إنّما يتركون خوفاً من الولاة وإشفاقاً من نقصان الرتبة عن النظر، فإذا رأى المسيء مساواة مرتبته مع مرتبة المحسنين كان التقصير به أولى…”(58).
لا شك في أن أمر أي دولة لا يستقيم بدون وزراء يعينون الحاكم على إدارة شؤون الدولة؛ لذلك عُدَّ اختيارهم ونصبهم من الأمور الصالحة بل اللازمة، ولا يكفي صلاح الحاكم عن صلاح الوزراء، كما أن صلاح الوزراء قد يسد كثيراً من الخلل الذي ينتجه النقص في الحاكم، حيث إنّ الوزراء بنحوٍ ما حكّام في الجوانب التي نُصِّبوا فيها ومطلوب منهم مثل ما يطلب من الحاكم في ما تصدّوا له. وفي نظام الدولة الحديث يتصدّى الوزراء لنصب الوكلاء والمدراء فيجب أن يلاحظوا في أداء ما يوكل لهم ما جاء في هذا العهد مما يتصل بصلاحياتهم وكثير مما يجري على الحاكم يجري على الوزراء.
الإحسان للرعية:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «واعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِم، وتَخْفِيفِهِ الْمَؤُونَاتِ عَلَيْهِمْ…»(59).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “نبّهه على الإحسان إلى رعيّته وتخفيف المؤونات عنهم وترك استكراههم على ما ليس له قبلهم بما يستلزمه ذلك من حسن ظنّه بهم المستلزم لقطع النصب عنه من قبلهم والاستراحة إليهم؛ وذلك أنّ الوالي إذا أحسن إلى رعيّته قويت رغبتهم فيه وأقبلوا بطباعهم على محبّته وطاعته، وذلك يستلزم حسن ظنّه بهم فلا يحتاج معهم إلى كلفة في جمع أهوائهم والاحتراس من شرورهم…”(60).
الروايات في بيان أثر الإحسان الإيجابي في القلوب كثيرة جداً، منها عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا»(61)، وهذا أيضا مما يشهد به الوجدان، والإحسان وإن كان مطلوباً من الجميع إلا أن الحاكم أولى من غيره فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أَحَقُ النَّاسِ بِالْإِحْسَانِ مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَبَسَطَ بِالْقُدْرَةِ يَدَيْهِ»(62).
الأخذ عن العلماء:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ ومُنَاقَشَةَ الْحُكَمَاءِ…»(63).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمره أن يكثر مدارسة العلماء، أي بأحكام الشريعة وقوانين الدين، ومنافثة الحكماء: أي العارفين باللَّه وبأسراره في عباده وبلاده العاملين بالقوانين الحكمية العمليّة التجريبيّة والاعتباريّة، ويتصفّح أنواع الأخبار في تثبّت القواعد والقوانين الَّتي يصلح عليها أمر بلاده، وإقامة ما استقام به الناس قبله منها…”(64).
لا يمكن لأي بلد أن يستقيم أمره بدون قانون ينظم حركة المجتمع، ولا يضع القانون الصالح لتسيير أمور الدولة أهل الجهل والأهواء بل المرجع في وضع القانون هم أهل العلم والمعرفة لا غير، والعلم الحقيقي هو عند الله (عزَّ وجل) فما جاء من عنده سبحانه هو الكفيل بتحقيق صالح البشرية وإيصالها إلى كمالها المنشود وسعادتها المطلوبة، ولذلك لا بد من الأخذ عن أهل المعرفة بالدين الحق والاستفادة من نتاجاتهم العلمية في التخطيط للدولة وإلا فمصير الدولة إلى الخراب والمجتمع إلى الفساد والحضارة إلى الزوال وذلك عند الأخذ باجتهادات أهل التجربة والحدس البعيدين عن نمير الشرع الصافي وغديره العذب، فضلاً عن الأخذ برأي أهل الهوى والجهل ممن لا معرفة عندهم وإنما يصاحَبون للأنس واللهو أو للقرابة والنسب وما شابه من الأسباب التي وفقها تختار السلطات مستشاريها، وليس ذلك يعني إهمال نظر أهل العلم والمعرفة والتخصصات المختلفة التي لا يشك عارف بالمدنية الحديثة في ضرورة الاستفادة منها للتقدم وإنّما المراد أن يكون العمدة في بناء الدولة والمجتمع هو بناء الإنسان وأشرف ما فيه روحه لا جسده، وخير من يؤتمن على روح الإنسان الفقهاء العدول.
ومع ذلك فإنّ لمن يستشار من أصحاب التخصصات والفنون مواصفات أيضا، وقد نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن استشارة البخيل والجبان والحريص(65)، وشرح ذلك الشيخ (قدِّس سرُّه) بقوله: “ونبّه على وجه المفسدة في استشارة كلّ أحد من الثلاثة… وذلك أنّ البخيل لا يشير إلَّا بما يراه مصلحة عنده وهو البخل وما يستلزمه من التخويف بالفقر، وهو يعدل بالمستشير عن الفضل… [و] الجبان لا يشير إلَّا بوجوب حفظ النفس والتخويف من العدوّ وهو المصلحة الَّتي يراها، وكلّ ذلك مضعّف عن الحرب ومقاومة العدوّ… [وأما الحريص فبسبب] أنّ المصلحة عنده جمع المال وحفظه وهو مستلزم للجور عن فضيلة العدل والقصد… [ونفِرُّ عن الصفات الثلاث بسبب] أنّها غرائز: أي أخلاق متفرّقة يحصل للنفس عن أصل واحد ينتهى إليه وهو سوء الظنّ باللَّه.
وبيان ذلك أنّ مبدأ سوء الظنّ باللَّه عدم معرفته تعالى فالجاهل به لا يعرفه من جهة ما هو جواد فيّاض بالخيرات لمن استعدّ بطاعته لها فيسوء ظنّه به، وبأنّه لا يخلف عليه عوض ما يبذله فيمنعه ذلك مع ملاحظة الفقر من البذل وتلزمه رذيلة البخل، وكذا الجبان جاهل به تعالى من جهة لطفه بعباده وعنايته بوجودهم وغير عالم بسرّ قدره فيسوء ظنّه بأنّه لا يحفظه من التلف ويتصوّر الهلاك فيمنعه ذلك عن الإقدام في الحرب ونحوها فيلزمه رذيلة الجبن، وكذلك الحريص يجهله تعالى من الوجهين المذكورين فيسوء ظنّه به ويعتقد أنّه إذا لم يحرص الحرص المذموم لم يوصل إليه تعالى ما يصلح حاله ممّا يسعى فيه ويحرص عليه فيبعثه ذلك على الحرص، وكذلك النفس، فكانت هذه الأخلاق الثلاثة المذمومة راجعة إلى ما ذكره (عليه السلام)”(66).
حسن اختيار الجند:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ ولِرَسُولِهِ…»(67).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “الجند: وأشار إلى تعيين من يصلح لهذه المرتبة بأوصاف، وأمره ونهاه فيهم بأوامر ونواهي”.
أمّا الأوصاف:
فأحدها: من كان أنصح في نفسه للَّه ولرسوله ولإمامه جيباً أي أكثرهم أمانة في العمل بأوامر اللَّه ورسوله وإمامه.
وناصح الجيب كناية عن الأمين.
الثاني: أفضلهم حلماً. ثمّ وصف ذلك الأفضل فقال: ممّن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر فيقبله إذا وجده، ويرأف بالضعفاء فلا يغلظ عليهم، وينبو على الأقوياء: أي يعلو عليهم ويتجنّب الميل إليهم على من دونهم، ممّن لا يثيره العنف: أي لا يكون له عنف فيثيره… وقيل: لا يهيّجه العنف ولا يزعجه إذا فعل، ولا يقعد به الضعف عن إقامة حدود اللَّه وأخذ الحقوق من الظالمين أي لا يكون له ضعف فيقعده عن ذلك.
الثالث: من كان من أهل الأحساب والبيوتات الصالحة والسوابق الحسنة من الأحوال والأفعال والأقوال الخيريّة.
الرابع: من يكون من أهل النجدة والشجاعة.
الخامس: من يكون من أهل السخاء والسماحة.
وأمّا الأوامر:
فأحدها: أن يولّي من الجند من كان بهذه الصفات.
الثاني: أن يلصق بمن ذكر منهم…
الثالث: أن يتفقّد من أمورهم ومصالحهم ما يتفقّده الوالدان، وهو كناية عن نهاية الشفقّة عليهم.
الرابع: نهاه أن يعظم في نفسه شيء يقوّيهم به من مال، أو نفع فيدعوه إلى التقاصر في حقّهم.
الخامس: وأن لا يحتقر لطفاً يتعاهدهم به فيحمله احتقاره على تركه….
السادس: نهاه أن يدع تفقّد الصغير من أمورهم اعتمادا على تفقّد عظيمها….
السابع: أمره أن يكون آثر رؤس جنده عنده من كان بالصفات المذكورة وهو الَّذي يواسي من تحت يده من الجند فيما يحصل له من المعونة، ويفضل عليهم ممّا في يده بما يسعهم ويسع من ورائهم من ضعفاء أهليهم وخلوفهم حتّى يكون بذلك همّهم واحداً فيكونوا بمنزلة رجل واحد في جهاد العدوّ….
الثامن: أمره أن يفسح لهم: أي يجعل لهم من نفسه طمعاً يفتسح به آمالهم فيه…
التاسع: أمره أن يواصل من حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم…
العاشر: أمره أن يعرف لكلّ امرئ ما أبلى وينسبه إليه لأنّه يهزّ الشجاع ويشجّع الجبان.
الحادي عشر: نهاه أن يضمّ بلاء امرئ إلى غيره.
الثاني عشر: وأن يقصر به دون غاية بلائه فيذكر بعضه أو يحقّره.
الثالث عشر: وأن يدعوه شرف امرئ إلى أن يعظم صغير بلائه، أو ضعة امرئ أن يستصغر كثير بلائه فإنّ كلّ ذلك داعية الكسل والفتور عن الجهاد.
الرابع عشر: أمره أن يردّ إلى الله ورسوله ما يضلعه(68) من الخطوب ويشتبه عليه من الأمور محتجّاً بالآية، ثمّ فسّر الردّ إلى اللَّه بالأخذ بمحكم كتابه، والردّ إلى الرسول بالأخذ بسنّته، ووصف السنة بكونها جامعة؛ لأنّ مدارها على وجوب الألفة واجتماع الخلق على طاعة اللَّه وسلوك سلوكه»(69).
يشكل الجهاز العسكري أحد أهم الحصون التي تحمي الدولة وإنّما تكمن قوته في عناصره البشرية لذلك لا بد من العناية من اختيار أفراد هذا الجهاز ليؤدي دوره المطلوب في حماية الأمّة، ولا يخفى على المطالع لتاريخ الأمّة وحاضرها ما جرّه عدم العناية بمواصفات العسكر من ويلات، فمنها سيطرة العسكر على إدارة الدولة بالقهر والغلبة، ومنها ظلمهم للرعية بدل حمايتها وقتل الأبرياء بدل الدفاع عنهم، ولعل أعظمها ضعفهم عن حماية الأمّة في وجه هجمات الأعداء مما أدى إلى تسلط أمم الكفر على أمّة الإسلام، ولكل ذلك وغيره شواهد كثيرة ليس المقام مقام تفصيلها. ولا يخفى أن كل ذلك راجع إلى ضعف الحكام والساسة وفقدهم الأهلية.
الدقة في اختيار القضاة:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ…»(70).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “قضاة العدل وعيّنهم له بأوصاف وأمره فيهم بأوامر: أمّا التعيين فأوجب أن يكون أفضل رعيّته في نفسه، وميّز ذلك الأفضل بصفات: أحدها: أن يكون ممّن لا يضيق به الأمور فيحار فيها حين تورد عليه.
الثاني: وممّن لا يمحكه الخصوم: أي يغلبه على الحقّ باللجاج، وقيل: ذلك كناية عن كونه ممّن يرتضيه الخصوم فلا تلاجّه ويقبل بأوّل قوله.
الثالث: أن لا يتمادى في زلَّته إذا زلّ فإنّ الرجوع إلى الحقّ خير من التمادي في الضلال.
الرابع: أن لا يحصر من الرجوع إلى الحقّ إذا عرفه كما يفعله قضاة السوء حفظاً للجاه وخوفاً من شناعة الغلط. الخامس:
أن لا يشرف نفسه على طمع فإنّ الطمع في الناس داعية الحاجة إليهم والميل عن الحقّ.
السادس: أن لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه؛ لأنّ ذلك مظنّة الغلط.
السابع: أن يكون أوقف الناس عند الشبهات لأنّها مظنّة الوقوع في المآثم.
الثامن: وآخذهم بالحجج.
التاسع: وأقلَّهم تبرّماً بمراجعة الخصم لما يستلزمه التبرّم من تضييع الحقوق.
العاشر: وأصبرهم على تكشّف الأمور.
الحادي عشر: وأصرمهم عند اتّضاح الحقّ فإنّ في التأخير آفات.
الثاني عشر: وممّن لا يحدث له كثرة المدح كبراً.
الثالث عشر: وممّن لا يستميله إلى غير الحقّ إغراء به.
ثمّ حكم بقلَّة من يجتمع فيه هذه الصفات تنبيهاً على أنّ فيها ما هو أولى دون أن يكون شرطاً في القضاء.
وأمّا الأوامر:
فأحدها: أن يختار من كان بالصفات المذكورة.
الثاني: أن يكثر تعاهد قضائه ليقطع طمعه في الانحراف عن الحقّ لو خطر بباله.
الثالث: أن يفسح له في البذل ما يزيل علَّته، وهو كناية عمّا يكفيه ويقلّ معه حاجته إلى الناس فلا يميل إليهم….
الرابع: أن يعطيه من المنزلة عنده ما لا يطمع فيه معها غيره من خاصّته ليأمن بذلك اغتيال الأعداء.
الخامس: أن ينظر في اختيار من كان بهذه الصفات وفيما أمره به نظراً بالغاً ليعمل بأقصاه…”(71).
إنّ منصب القضاء من أهم المناصب وأشدها وقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ (عليه السلام) أنه قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لِشُرَيْحٍ: يَا شُرَيْحُ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ إِلا نَبِيٌّ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍ، أَوْ شَقِيٌ»(72)، والحاكم مسؤول عن اختياره للقضاة -وهو شريكهم في قضائهم- وعن حمايتهم وعن تنفيذ أحكامهم؛ فلذلك وجب أن يتقن اختيار من ينصبه للقضاء، ومن المهم أن يحرص الحاكم على أن ينفذ القانون على الجميع بلا تمييز ولا محاباة، وكثر سخط العامة على الحكام لعدم العدل فيهم وهذا يكون بسبب ظلم الحاكم نفسه، ويكون بسبب من ينصبه من القضاة خصوصاً إن كان نصبه لاعتبارات الهوى الحزبية والقَبليّة والعشائرية وغيرها.
اختبار المسؤولين قبل نصبهم:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً…»(73).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “العمّال وميّزهم أيضاً بأوصاف وأمّره فيهم بأوامر مصلحيّة.
أمّا الأوصاف:
فأحدها: أن يكون العامل من أهل التجربة للأعمال والولايات، على علم بقواعدها.
وبدأ بذلك لأنّه الأصل الأكبر للعمل.
الثاني: أن يكون من أهل الحياء فلا ينتهي في الانفعال إلى حدّ الاستخدام وهو طرف التفريط فيضيّع به الحقوق والمصالح ولا يتجاوزه إلى حدّ القحة فيقع في طرف الإفراط وما يلزمه من الجفاوة ونفرة القلوب عنه.
الثالث: أن يكون من أهل البيوتات الصالحة والقدم السابقة في الإسلام، وهي كناية عن البيوت المتقدّمة في الدين والخير، ولهم في ذلك أصل معرق.
وأشار إلى وجه الحكمة في تولية من كان بهذه الصفات الثلاث… وذلك أنّ الحياء وصلاح البيوت والتقدّم في الإسلام يفيدهم كرم الأخلاق ومحافظة على الأعراض من المطاعن وقلَّة الإشراف والتطَّلع إلى المطامع الدنيّة، والتجربة يفيدهم بلاغة النظر في عواقب الأمور…
وأمّا الأوامر:
فأوّلها: أن ينظر في أمورهم فيستعملهم بعد التجربة والاختبار ولا يولَّيهم محاباة وأثرةً كأن يعطونه شيئاً على الولاية فيولَّيهم ويستأثر بذلك دون مشاورة فيه فإنّهما: أي المحاباة والأثرة – كما هو مصرّح به في بعض النسخ عوض الضمير – جماع من شعب الجور والخيانة، أمّا الجور فللخروج بهما عن واجب العدل المأمور به شرعاً وأمّا الخيانة فلأنّ التحرّي في اختيارهم من الدين وهو أمانة في يد الناصب لهم فكان نصبهم من دون ذلك بمجرّد المحاباة والأثرة خروجاً عن الأمانة ونوعاً من الخيانة.
وثانيها: أن يقصد بالعمل من كان بالصفات المذكورة للعلل المذكورة.
الثالث: أن يسبغ عليهم الأرزاق، وبيّن المصلحة في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ عمومهم بالأرزاق يكون قوّة لهم على استصلاح أنفسهم الَّذي لا بدّ منه.
الثاني: أنّه غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم من مال المسلمين.
الثالث: أنّه يكون حجّة له عليهم إن خالفوا أمره أو ثلموا أمانته. واستعار لفظ الثلم للخيانة….
الرابع: أن يتفقّد أعمالهم ويبعث العيون والجواسيس من أهل الصدق والوفاء عليهم… فإنّ تعهّده لأمورهم مع علمهم بذلك منه يبعثهم على أداء الأمانة فيما ولَّوا من الأعمال، وعلى الرفق بالرعيّة….
الخامس: أن يتحفّظ من خيانة الأعوان من العمّال.
وأرشده… إلى ما ينبغي من تأديبهم وإقامة سنّة اللَّه فيهم… وهذه العقوبة مقدّرة بحسب العرف ورأى الإمام أو من ارتضاه”(74).
ليس المقصود من العمال هو قطاع الموظفين والعاملين من ذوي الدرجات العادية في المؤسسات والشركات وما شابه، بل المراد هو المسؤولون في المناصب الرفيعة من الوكلاء والرؤساء والمدراء، ولهؤلاء أدوار مهمة تقترب من دور الوزراء وقد تقدم في ذلك الكلام.
عمارة الأرض:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ…»(75).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أهل الخراج : وأمره فيهم بأوامر :
أحدها: أن يتفقّد أمر خراجهم ويفعل فيه ما يصلح أهله مما سيشرحه… ونبّه بقوله: «لا صلاح لمن سواهم إلّا بهم» على حصر صلاح الغير فيهم تأكيداً… بقوله: «لأنّ النّاس كلّهم عيال على الخراج وأهله». وهو ظاهر في ذلك الوقت.
الثاني: أن يكون نظره في عمارة الأرض أبلغ من نظره في طلب الخراج واستجلابه… [وإلا فالنتيجة] مفاسد ثلاث أحدها: إخراب البلاد لعدم العمارة، والثاني: إهلاك العباد لتكليفهم ما ليس في وسعهم، والثالث: عدم استقامة أمر الطالب للخراج والوالي على أهله….
الثالث: أمره أن يخفّف عنهم من خراجهم ما يرجو أن يصلح به أمرهم على تقدير أن يشكوا من حالهم ما عساه يلحقهم من قبل أرضهم من ثقل خراج أو علّة سماويّة أو انقطاع نصيب كان لهم من الماء أو تغيّر أرض وفسادها بسبب غرق أو عطش، ثمّ نهاه أن يستثقل بما يخفّف عنهم به المؤونة….
ثم نبّه… على سبب الخراب… وهو مركَّب من ثلاثة أجراء:
أحدها: إشراف نفوس الولاة على الجمع.
والثاني: سوء ظنّ أحدهم أنّه لا يبقى في العمل.
والثالث: عدم انتفاعهم بالعبر لقلَّة التفاتهم إليها، وظاهر أنّ هذه الأمور إذا اجتمعت في الوالي استلزمت جمعه للمال واستقصاءه على الرعيّة واستلزم ذلك إعوازهم وفقرهم فاستلزم ذلك خراب أرضهم وتعطيل عمارتها”(76).
هناك شبه بين ما أمر به صلوات الله عليه في أهل الخراج وما ينبغي أن يحرص عليه الحكام اليوم فيما يتعلق بجبي الضرائب على أبناء الشعب، وكذلك ما يتعلق باستخراج الثروات الطبيعية والاستفادة منها، فيجب على الحاكم أن يحرص على مصلحة أبناء الشعب وتطور إنسان الأمّة وتلبية حاجاته وتوفير البنى التحتية والمرافق الحيوية بما يسهم في تقدّم العباد وازدهار البلاد، لا أن يحرص على جمع أموال الضرائب حتى وإن أضرت بحال المواطنين ويبالغ في استخراج واستثمار الثروات الطبيعية بدون رعاية أن يكون ذلك في سبيل زيادة عزة الإسلام والمسلمين، ومما يؤسف له حقاً أن الوطن الإسلامي يتوفر على أغلب ثروات العالم من المعادن والموارد الطبيعية ولكنه يعيش التأخر الاقتصادي والإعماري وليس هذا إلا بسبب جشع الحكّام وفسادهم ولله المشتكى.
الاهتمام بالفقراء:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ… واحْفَظ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، واجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ… ولَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ… فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ولَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ، وتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ… ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ… وتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ…»(77).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “الطبقة السفلى وميّزهم بأوصاف وأمر فيهم بأوامر ونواهي: أمّا تميّزهم فالعاجزون عن الحيلة والاكتساب والمساكين والمحتاجون وأهل البؤسى والزمنى، وهؤلاء كلَّهم وإن دخل بعضهم في بعض إلَّا أنّه عدّدهم بحسب تعدّد صفاتهم لمزيد العناية بهم كيلا يتغافل عن أحدهم ويتثاقل فيه.
وأمّا الأوامر:
فأحدها: أنّه حذّر من اللَّه فيهم، وأشار إلى وجه الحكمة في ذلك التحذير بقوله : «فإنّ فيهم قانعاً ومعترّاً»….
الثاني: أن يجعل لهم قسماً من بيت ماله ومن صوافي الإسلام في كلّ بلد. وأضاف بيت المال إليه وأراد الَّذي يليه….
الثالث: نهاه أن يشغله عنهم بطر….
الرابع: نهاه أن يشخص همّه عنهم: أي يرفعه حتّى لا يتناولهم.
الخامس: نهاه أن يصعّر خدّه لهم، وهو كناية عن التكبّر عليهم.
السادس: أمره أن يتفقّد أمور من لا يمكنه الوصول إليه منهم لعجزه وحقارته في عيون الأعوان والجند، وأن يفرّغ لهؤلاء ثقة له من أهل الخشية والتواضع وينصبه لهم ليرفع إليه أمورهم.
السابع: أن يعمل فيهم بالإعذار إلى اللَّه سبحانه يوم يلقاه: أي يعمل في حقّهم ما أمره اللَّه به بحيث يعذر إليه: أي يكون ذا عذر عنده إذا سأله عن فعله بهم.
الثامن: أكَّد الأمر بالإعذار إلى اللَّه في تأدية حقّ كلّ واحد من المذكورين إليه.
التاسع: أمره أن يتعهّد الأيتام وذوي الرقّة في السنّ: أي الَّذين بلغوا في الشيخوخة إلى أن رقّ جلدهم وضعف حالهم عن النهوض فلا حيلة لهم، وممّن لا ينصب نفسه للمسألة حياء مع حاجته وفقره”(78).
هذه الفئة من المجتمع التي نزل بها الضر والبلاء لها أهميتها في المجتمع -وفق نظر الإسلام- ولا يقبل أن تكون على هامش اهتمام الولاة بل لا بد من العناية بها لعدة عوامل منها أن أفرادها جزء من عيال الله (عزَّ وجل) ولا يرضى سبحانه بإهمالهم بل شدد الأمر برعايتهم والقيام بحاجاتهم، إضافة إلى أن عدم القيام بحاجاتهم سيفتح الباب لكثير من الانحرافات الضارة بالمجتمع، وذلك ما نشاهده اليوم في مختلف المجتمعات البشرية حيث يتفشى في مثل هذه الفئات الجهل وتنتشر الجريمة!!
مع أن هذه الفئات يمكن أن تكون منتجة وفعالة في رقي المجتمع لو عولجت حاجاتها بشكل صحيح، ونحن لا نلغي دور التكافل الاجتماعي -في معالجة هذه الحاجات- فهو دور مهم جداً إلا أن الحاكم والدولة هما المسؤول الأول عن رعاية المواطنين وتوفير الضمان الاجتماعي الذي يجعل المواطن المنتج اليوم مطمئناً على مستقبله لو قدر الله أن يصاب بمانع يمنعه عن العطاء.
الجلوس لأهل الحاجات:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «واجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ، وتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وشُرَطِكَ…»(79).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أن يجعل لذوي الحاجات نصيباً من نفسه يفرّغ لهم فيه بدنه عن كلّ شاغل ويجلس لهم مجلساً عامّاً في الأسبوع أو دونه أو فوقه حسب ما يمكن”(80).
ليس المراد بذوي الحاجات هنا المتملّقين من النفعيين وأشباههم الذين لا تنقضي طلباتهم ومن لهم في كل يوم حاجة ولا تخلو منهم مجالس الحكام والمسؤولين، وإنما المراد أهل الحاجة من عامة الناس الذين تقوم بهم البلاد وقد تمنع من قضاء حوائجهم بعض الموانع هنا أو هناك وقد تكون حوائجهم مالية أو إدارية وقد تكون حاجتهم شكوى من تقصير مسؤول أو فساده، وقد يكونوا من الفقراء والمحتاجين أو من أفراد الطبقة الوسطى وهؤلاء لا طريق لهم للحاكم والمسؤولين إلا أن يُجلس لهم في مجلس عام يُفتح لهم ويُستقبلون فيه ليعرضوا حوائجهم.
وحيث كان المجلس فقد تكون معه موانع تمنع من أن يؤتي أكله ولرفعها قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أن يتواضع فيه للَّه. ورغَّبه في التواضع بنسبته إلى اللَّه باعتبار أنّه خالقه الَّذي من شأنه أن يكون له التواضع”(81).
فإذا كان الغرض من المجلس لأهل الحاجات هو الاطلاع على حوائجهم وسماع شكاياتهم وقضاء ما يمكن قضاؤه لهم فلا بد من أن يكون المجلس باعثاً على أنسهم وانطلاق ألسنتهم ليتحقق الغرض منه، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون الحاكم متواضعاً فيه ليقبل عليه الناس بدون تكلف.
ولرفع مانع آخر -قد يكون أقوى في المانعية- قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أن يقعد عنهم جنده وأعوانه، وأبان وجه المصلحة في ذلك بقوله: «حتّى يكلِّمك متكلِّمهم غير متتعتع…”(82)، فإن أصحاب الحاجات إن احتملوا أن يصيبهم غضب الحاكم أو حاشيته ترددوا في طرحها، وإذا كانت عندهم شكوى من متنفذ وذي سلطة أو وجاهة فلن يطرحوها إلا إن كانوا آمنين، وحيث إن سماع حوائجهم وشكاويهم واجب وجب كل ما كان مقدمة له.
عدم تفضيل المقربين:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولَا تُقْطِعَنَّ لأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وحَامَّتِكَ قَطِيعَةً…»(83).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “من الأمور المصلحيّة المتعلَّقة بخاصّته أن يحسم مؤونتهم عن الرعيّة… وأشار إلى وجه ذلك بذكر ما فيهم من الاستئثار على الرعيّة بالمنافع والتطاول عليهم بالأذى وقلَّة الإنصاف… فإنّ إقطاع أحدهم قطيعة وطمعه في اقتناء ضيعة تضرّ بمن يليها من الناس في ماء أو عمل مشترك يحمل مؤونته على الناس كعمارة ونحوها هي أسباب الأحوال المذكورة من وجوه المؤونة وقطع تلك الأحوال بقطع أسبابها. ثمّ نفّره عن أسباب المؤونة على الناس بما يلزم تلك الأسباب من المفسدة في حقّه وهي كون مهنأ ذلك لهم دونه وعيبه عليه في الدنيا والآخرة…”(84).
أقرباء الحاكم وعشيرته وأصحابه وحاشيته من أهم العوامل في فساد الحكم؛ لما تدخله أهواؤهم من الضر على عامة الناس، وقد عرفت البشرية ويلات النظام الإقطاعي وهو نظام إن زال ظاهراً فهو ما زال نافذاً بصور وأشكال متنوعة وجديدة، ولا يقتصر وجوده على الأنظمة الملكية المطلقة بل تنوع بتنوع الأنظمة فهو موجود في النظام الملكي الدستوري بشكل، وموجود في الأنظمة الجمهورية بشكل آخر وهلم جراً، وما لم يكبح الحاكم جماح هذه الفئة فالويل لها وله إذ إنّ العامة وإن طال صبرها إلا أنه لا يدوم، فجشع هؤلاءِ وتوسعهم في الاستحواذ على الامتيازات لا بد من أن ينتج نقطة الغليان والثورة.
فالسبيل هو بإحقاق الحق ولذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ والْبَعِيدِ…»(85).
وفي بيانه قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أن يلزم الحقّ من يلزمه الحقّ من القريب والبعيد ويكون في ذلك الإلزام صابراً لما عساه يلحق أقاربه من مرّ الحقّ، محتسباً له: أي مدخله في حساب ما يتقرّب به إلى اللَّه تعالى ويعدّه خالصاً لوجهه، واقعا ذلك الإلزام من قرابته وخواصّه حيث اتّفق وقوعه بمقتضى الشريعة…”(86).
دفع الشبهة عن نفسه:
مهما كان الحاكم عادلاً منصفاً مجتهداً في خدمة الرعية وإصلاح البلاد فإنّ البلد لن يخلو من أهل الفساد ممن يشوه الحقائق وينشر الإشاعات، الأمر الذي سيؤدي إلى سوء ظن الرعية به، وقد عالج أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا الوضع فقال: «وإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ…»(87).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمره على تقدير أن تظنّ الرعيّة فيه حيفاً أن يصحر لهم عذره فيما ظنّوا فيه الحيف ويعدل عنه ظنونهم بإظهاره… فإنّ في إظهار عذرك لهم أن تصير ذا عذر تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحقّ من معرفتهم أنّ فعلك حقّ لا حيف فيه…”(88).
ولا يراد من هذا أن يخدع الحاكم رعيته بالأعذار الكاذبة؛ كما ينتشر بين ساسة اليوم حيث يوظفون المختصين في الإعلام لخداع الجمهور وضمان استمرار الظلم والطغيان، بل المراد أن تتضح الأمور للعامة فلا يترك المجال للأعداء وعملائهم الذين يريدون ببلاد المسلمين السوء.
الرغبة في الصلح:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ ولِلَّهِ فِيهِ رِضًا… ولَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ…»(89).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “نهاه أن يدفع صلحا دعاه إليه عدوّه إذا كان صلحاً يرضى اللَّه ونبّه على وجوه المصلحة فيه… [ثم] بالغ في تحذيره من العدوّ بعد صلحه وأمره أن يأخذ بالحزم ويتّهم في الصلح حسن ظنّه الَّذي عساه ينشأ عن صلحه…”(90).
نطرح هذا البعد لأهميته حيث إن أغلب حكام المسلمين يلهثون للصلح مع الكيان الصهيوني الغاصب ويتكالبون للتعاون مع الاستكبار العالمي الكاذب، فالصلح مطلوب ومهم إذا كان مما يرضي الله (سبحانه وتعالى)، وليس مما يرضي الله أن تُذل رقابُ أبناء الأمّة للصهيونية العالمية وأن تتحكم في مقدرات المسلمين قوى الجاهلية المعاصرة، ثم أنه لو فرض أن الدراسات العلمية الموضوعية أنتجت أهمية الصلح مع هؤلاء فلا يصح أن يحسن بهم الظن ويفتح الباب لهم لتغيير هوية أبناء الأمّة وفكرها وثقافتها، بل لا بد من اتهام كل فكرة ومنتج بل كل ما يأتي منهم، ولا يعني هذا رفض ما فيه صلاح وخير من العلوم والتقنيات الحديثة المهمة والمفيدة لأمّة الإسلام؛ فالمؤمنون أولى بخير الدنيا وصلاحها، فاللازم على حكام الأمّة أن يتّقوا الله (جلَّ جلاله) ويتركوا ما هم فيه من الارتهان للكفر والطغيان العالمي وأن يحفظوا للأمّة عزّتها وكرامتها.
الوفاء بالعهد:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّة، فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وارْعَ ذِمَّتَكَ بِالأَمَانَةِ… ولَا تُعَوِّلَنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكِيدِ والتَّوْثِقَةِ…»(91).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمره على تقدير أن يعقد بينه وبين عدوّه عهداً أن يحوطه بالوفاء ويرعى ذمّته بالأمانة ويجعل نفسه جنّة دون ما أعطى: أي يحفظ ذلك بنفسه ولو أدّى إلى ضررها، واستعار لفظ اللبس لإدخاله في أمان الذمّة ملاحظة لشبهها بالقميص ونحوه…
ورغَّب في ذلك بوجهين:
أحدهما: أنّ الناس أشدّ اجتماعاً على ذلك من غيره من فرائض اللَّه الواجبة عليهم مع تفرّق أهوائهم وتشتّت آرائهم.
الثاني: أنّ المشركين لزموا ذلك فيما بينهم واستثقلوا الغدر لما فيه من سوء العاقبة… ثمّ أكَّد ذلك بالنهى عن الغدر في العهد ونقض الذمّة وخداع العدوّ بمعاهدته ثمّ الغدر به… [و] نهاه أن يعتمد على لحن القول في الأيمان والعهود بعد أن يؤكَّدها ويتوثّق من غيره فيها أو يتوثّق غيره منه فيها…”(92).
يعطي الحاكم المسلم عهوداً لأعدائه، والمفترض أن يكون هؤلاء من خارج الأمّة إلا أنّ تمزق المسلمين وتفرقهم أشتاتا جعل كل فرقة ترى في غيرها عدواً وهذا ليس من الإسلام في شيء، والحاكم -حيث إنه عادة المالك للقوة والقادر على القهر- قد يتوسل للتغلب على أعدائه بمعاهدتهم ثم الغدر بهم، وقد أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالوفاء بالعهد إذا تم الالتزام به، هذا مع الأعداء ومن باب أولى أن يلتزم الحكام بما وعدواً به شعوبهم قبل وصلولهم إلى السلطة أو بعده، وهناك من الحكام من يطلق وعوداً تحتمل أكثر من وجه، فيؤكد على معنى منها ويعطي عليه المواثيق، ثم يعدل عند العمل لغيره، وقد نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن هذا الفعل، كما نهى عن تنازل الحاكم أمام غيره فيما لو مارسوا معه خداعاً من هذا النوع أيضاً فلا يقبل بخلاف ما اتفق عليه وأخذ عليه المواثيق.
ترك سفك الدماء:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِيَّاكَ والدِّمَاءَ وسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا… فَلا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ… ولا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ ولا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ…»(93).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “حذّره من الدخول في الدماء وسفكها بغير حقّ وهو كناية عن القتل… فإنّ سفك الدماء بغير حقّ أدنى الأشياء لحلول نقمة اللَّه، وأعظمها في لحوق التبعة منه، وأولاها بزوال النعمة وانقطاع مدّة الدولة والعمر، وظاهر أنّها أقوى المعدّات للأمور الثلاثة لما يستلزمه من تطابق همم الخلق ودواعيهم على زوال القاتل واستنزال غضب اللَّه عليه لكون القتل أعظم المصائب المنفور عنها… [ ولهذا ] نهاه أن يقوّى سلطانه ودولته بسفك الدم الحرام… [ و] نهاه عن قتل العمد حراماً ونفّر عنه بأمرين: أحدهما: أنّه لا عذر فيه عند اللَّه ولا عنده. الثاني: أنّ فيه قود البدن…”(94).
من أكبر الانحرافات التي ابتليت بها هذه الأمّة هو ظن الحكام أنّ لهم الحق في دماء الرعية وأعراضها، وأن تقتنع فئات واسعة من الأمّة بهذه الفكرة الجاهلية، وإنّ تبجيل ما فعله طواغيت في التاريخ الإسلامي كالحجاج وأمثاله في الكتب والإعلام هو خير دليل على مقبولية الفكرة، في حين أنّ الله (عزَّ وجل) حرّم سفك الدم والاستثناء من ذلك موارد محدودة بينتها الشريعة الغراء. فاللازم على أبناء الأمّة أن يمنعوا الحكام من سفك الدماء وأن لا يتهاونوا في طلب القصاص من القتلة، فليس لقاتل النفس المحترمة عذر عند الله، وينبغي هنا الحذر مما يطرحه الغرب من أنّ القصاص اعتداء على حق الحياة فالقاتل وقد هتك حق حياة المقتول فلا حق له، والمطلوب هو المحاكمة العادلة والتزام ما أمر الله (سبحانه وتعالى) به.
معالجة القتل الخطأ:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَأٍ… فَلا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ…»(95).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “نهاه أن يرتكب رذيلة الكبر عند من يبتلى بقتل خطأ، أو إفراط سوطه، أو يده عليه في عقوبة فيأخذه عزّة الملك والكبر على أولياء المقتول فلا يؤدّى إليهم حقّهم…”(96).
بعد أن يتقي الحاكم وجهازه التنفيذي سفك الدم الحرام ويكون له رادع عن القتل بالهوى أو التهمة، فلو مات بسببه بريء خطأً، عندها لا عيب في الاعتراف بالخطأ والإقرار به وبالتالي تعويض أهل المقتول بالدية الشرعية، ولا يخفى أن مثل هذا متصور فيما لو كانت الحاكمية للقوانين الشرعية التي يكون فيها الحد والتعزير بالضرب الذي قد يفضي خطأً إلى الموت، أما والأنظمة الحاكمة اليوم تتبرأ من أحكام الشرع وتأخذ بالقوانين الغربية -التي ترفض أي نوع من أنواع العقوبة البدنية- فما يتصور حدوثه من قتل هو بسبق النية والقصد وعليه فعلى الحكام محاكمة المتهم بالقتل والقصاص من القتلة، والمؤسف له أن الأنظمة تغطي على المنتسبين إليها عند اعتدائهم على الأرواح وهذا ما يشعل في نفوس الجماهير الغضب حيث يرون أن حياتهم لا تقدّر ولا تُحترم.
ترك المن والتزيُّد والخُلف:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإِيَّاكَ والْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ، أَوِ التَّزَيُّدَ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعودَكَ بِخُلْفِكَ…»(97).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “حذّره رذائل ثلاثة:
أحدها: المنّ على الرعيّة بإحسانه إليهم.
الثانية: التزيّد فيما فعله في حقّهم وهو أن ينسب إلى نفسه من الإحسان إليهم أزيد ممّا فعل.
الثالثة: أن يخلف موعوده لهم.
ثمّ نفّر عن المنّ بقوله: «فإنّ المنّ يبطل الإحسان»، وذلك إشارة إلى قوله تعالى: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ والأَذى»(98)، وعن التزيّد بقوله : «فإنّ التزيّد يذهب بنور الحقّ». وأراد بالحقّ هنا الإحسان إليهم، أو الصدق في ذكره في موضع يحتاج إليه فإنّ على ذلك نوراً عقليّا ترتاح إليه النفوس وتلتذّ به، ولمّا كان التزيّد نوعاً من الكذب وهو رذيلة عظيمة لا جرم كان ممّا يذهب نور ذلك الحقّ ويطفيه فلا يكون له وقع في نفوس الخلق، ونفّر عن الخلف بقوله: «يوجب المقت عند اللَّه والناس»: أمّا عند الناس فظاهر وأمّا عند اللَّه فلقوله تعالى: «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله»(99)…”(100).
المطلوب من حاكم المسلمين خدمة الرعية، وليست خدمته لهم كأي خدمة بل هي خدمة من نوع خاص، خدمة على طريق الله سبحانه تأخذ بالمجتمع -عبر تطبيق شرع الله سبحانه- إلى الكمال المطلوب له، هذه الخدمة الخاصة معها سلطة خاصة وتحتاج معايير خاصة، الحاكم خادم يملك سلطة وقوة ولا مكان للمن على الرعية بل كل ما يصدر من الحاكم من الإحسان فهو من واجباته التي يقتضيها منصبه، وسيكون له جزاؤه الحسن عند الله (سبحانه وتعالى).
كما أنه من القبيح المبالغة في ذكر الإنجازات -فضلاً عن اختلاقها كذباً- بتضخيم الأرقام وتزوير الإحصاءات، وكذلك أن تطلق الوعود الفارغة التي يعلم بأنها لن تنفذ، وللأسف فهذان الأمران مما لا يكاد يخلو منه حاكم أو سياسي إلا من هداه الله بالإيمان والتقوى.
ترك الاستئثار على الناس:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وإِيَّاكَ والاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ، والتَّغَابِيَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ…»(101).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “حذّره من الاستئثار بما يجب تساوى الناس فيه كالَّذي يستحسن من مال المسلمين ونحوه… وعن التغافل عمّا يجب العلم والعناية به من حقوق الناس المأخوذة ظلماً ممّا قد وضح للعيون إهمالك له… وأراد ما يستأثر به من حقوق الناس ويتغافل عنها…”(102).
النموذج الثاني: ما لا ينبغي للوالي
من كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة 130 من النهج: «وقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ والدِّمَاءِ والْمَغَانِمِ والأَحْكَامِ، وإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ، الْبَخِيلُ، فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ، ولَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ، ولَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ، ولَا الْخَائِفُ لِلدُّوَلِ، فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ، ولَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ، فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ، ويَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ، ولَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الأُمَّةَ»(103).
فهذه صفات ست لا يجوز أن تكون في الحاكم ونحن نعددها مع بيان ما أفاده الشيخ ابن ميثم (قدِّس سرُّه) في شرحها:
البخل:
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “أمّا البخيل فلشدّة حرصه على ما في أيدي الناس من الرعيّة وقد عرفت ما يستلزمه من نفارهم عنه وعدم انتظام الأحوال به”(104).
روي عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «الْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ»(105)، وقد تقدم عند شرح نهي أمير المؤمنين لمالك الأشتر عن استشارة البخيل أن مرجع بخل البخيل لسوء ظنه بالله (جلَّ وعلا) فلذلك هو بعيد من الله (سبحانه وتعالى) وقد بين الشارح (قدِّس سرُّه) سبب بعده عن الناس حيث إنّ بخله يمنعه من الإحسان إليهم، بل يتوغّل ليعتدي على حقوقهم ومعاشهم، وللأسف فإن سيرة مثل هؤلاء تشهد عليها خزائنهم وحساباتهم البنكية المتخمة في حين تعيش الشعوب الفقر والفاقة وعدم توفر أسباب العيش الكريم.
وقد أدّى بخل الحكام إلى غياب عوامل القوة والمنعة أمام الأعداء، فلم يعد لأمّة الإسلام العظيمة -والتي أغناها الله بموارد طبيعية كثيرة- هيبة عند غيرها، والساحة العالمية تشهد على إهانة الإسلام ونبيه (صلَّى الله عليه وآله) بدون رادع في الوقت نفسه الذي يمنع التشكيك في أكاذيب الصهيونية أو كشف جرائمها.
الجهل:
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “وأمّا الجاهل فلأنّه لجهله بقوانين الدين وتدبير أمور العالم ضالّ وضلاله يستلزم ضلال من اقتدى به وذلك ضدّ مقصود الشارع”(106).
روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجاهل لا يعرف تقصيره ولا يقبل من النّصيح له»(107)، وعنه (عليه السلام) كذلك: «إِنَّ الْجَاهِلَ مَنْ عَدَّ نَفْسَهُ بِمَا جَهِلَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ عَالِماً وبِرَأْيِهِ مُكْتَفِياً فَمَا يَزَالُ لِلْعُلَمَاءِ مُبَاعِداً وعَلَيْهِمُ زَارِياً ولِمَنْ خَالَفَهُ مُخَطِّئاً ولِمَا لَمْ يَعْرِفْ مِنَ الْأُمُورِ مُضَلِّلًا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَمْ يَعْرِفْهُ أَنْكَرَهُ وكَذَّبَ بِهِ وقَالَ بِجَهَالَتِهِ مَا أَعْرِفُ هَذَا ومَا أَرَاهُ كَانَ ومَا أَظُنُّ أَنْ يَكُونَ وأَنَّى كَانَ وذَلِكَ لِثِقَتِهِ بِرَأْيِهِ وقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِجَهَالَتِهِ فَمَا يَنْفَكُّ بِمَا يَرَى مِمَّا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ رَأْيَهُ مِمَّا لَا يَعْرِفُ لِلْجَهْلِ مُسْتَفِيداً ولِلْحَقِّ مُنْكِراً وفِي الْجَهَالَةِ مُتَحَيِّراً وعَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ مُسْتَكْبِرا»(108)، وفي هذا كفاية لبيان قبح أن يكون الحاكم جاهلاً.
الجفاء:
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “وأمّا الجافي فلأنّ جفاءه يستلزم النفرة والانقطاع عنه وذلك ضدّ الألفة والاجتماع المطلوب للشارع”(109)، “الجَفَاء: نقيض الصلة”(110). وقد تقدم من واجبات الحاكم ما لا يتحقق إن كان جافياً، كما لا يخفى عظم الحاجة اليوم إلى تواصل وتآلف أبناء الأمّة والتواصل بين الحاكم والمحكوم في زمن تداعت فيه الأمم على الأمّة الإسلامية كتداعي الأكلة على قصعتها، فغدت الأمّة نهباً للاعتداءات العسكرية والثقافية والاقتصادية وإنّ مِن أهم ما يدفع عنها كل أنواع العدوان هو التواصل لحل المشاكل وسد الثغرات وتبديل نقاط الضعف إلى مواطن قوة.
الخوف من للدول:
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “وأمّا الخائف من الدول فيخصّص بعنايته من يخافه دون غيره وذلك ظلم لا ينتظم معه نظام العالم”(111).
“الخوف وهو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال مشكوك الوقوع… ثم الخوف على نوعين: (أحدهما) مذموم بجميع أقسامه، وهو الذي لم يكن مِن الله ولا من صفاته المقتضية للهيبة والرعب، ولا من معاصي العبد وجناياته، بل يكون لغير ذلك من الأمور… وهذا النوع من رذائل قوة الغضب من طرف التفريط، ومن نتائج الجبن. و(ثانيهما) محمود وهو الذي يكون من الله ومن عظمته ومن خطأ العبد وجنايته، وهو من فضائل القوة الغضبية، إذ العاقلة تأمر به وتحسنه، فهو حاصل من انقيادها لها”(112)، ولا يخفى أنّ المراد هنا هو الأول المذموم لأن الدوّل جمع مفرده الدَّوْلَةُ، وذُكر في معناها: انْقِلابُ الزَّمانِ أو العُقْبَةُ في المالِ -وفسّرت العُقْبَةِ بالنَّوْبةِ والبَدَلِ- أو الدولة في المِلْك والسُّنَن التي تغيَّر وتُبدَّلُ وقيلَ انْتِقالُ النّعْمةِ من قَوْمٍ إلى قَوْمٍ أو الاسْتِيلاءُ والغَلَبَةُ(113)، وحيث إن أكثر ما يخافه الحكام اليوم هو الاستكبار العالمي وسطوته فهم لرضاه مبادرون غير ملتفتين لكرامة الأمّة وعزتها، ولو طلبوا رضا الله (جلَّ جلاله) لنصرهم وأعزهم، وقد يقال إنّهم يخافون -فيما لو بذلوا للأمّة ما ينهض بها- الانقلاب عليهم وتسلط غيرهم على كراسيهم ولذلك يسلبون من الأمّة عوامل قوتها ويحيطون بعنايتهم من يتوقعون أنه ناصرهم، وقد تقدم أنّ الحاكم إذا عدل وأحسن فإن الرعية لا تبتغي عنه بدلا.
الارتشاء في الحكم:
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “وأمّا المرتشي في الحكم فلظلمه وذهابه بالحقوق والوقوف فيها على الحيف دون المقاطع الحقّة، فترى أحد هؤلاء إذا أراد فصل قضيّة دافع بها طويلا وصعّب الحقّ وعرّض بغموضه وأشار بالصلح بين الخصمين مع ظهور الحقّ لأحدهما وكانت غايته من ذلك تخويف صاحب الحقّ من فواته ليجنح إلى الاصلاح والرضى ببعض حقّه مع أنّه قد يأخذ منه رشوة أيضاً، وربّما كانت في المقدار كرشوة المبطل منهما. ولهم في ذلك حيل يعرفها من عاناهم…”(114).
التعطيل للسُنة:
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “وأمّا المعطَّل للسنّة فلتضييعه قوانين الشريعة وإهمالها المستلزم لفساد النظام في الدنيا والهلاك الدائم في الأخرى”(115).
النموذج الثالث: من كتاب إلى أصحاب المسالح
من كتاب لأمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أمراءه على الجيوش: « فَإِنَّ حَقّاً عَلَى الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ، ولا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ، وأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ، وعَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ.
أَلَا وإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلّا فِي حَرْبٍ، ولا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ، ولا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ، ولا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ. وأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً…»(116).
قال الشيخ (قدِّس سرُّه): “اعلم أنّه قدّم هاهنا ما يجب على الوالي المطلق لرعيّته بوجه كليّ كما هو عادة الخطيب، ثمّ ثنّى ببيان ما يجب عليه لهم تفصيلاً لذلك الكلَّيّ…
أمّا الأوّل [ما يجب بنحو عام وكلي]:… وأشار فيه إلى أمرين:
أحدهما: أن لا يغيّره عنهم ما اختصّ به من الفضل والطَول؛ لأنّ تغيّره عنهم خروج عن شرائط الولاية.
الثاني: أن تزيده تلك النعمة من اللَّه دنّواً من عباده عطفاً على إخوانه؛ لأنّ ذلك من تمام شكر النعمة.
وأمّا الثاني [ما يجب تفصيلاً]: فاشترط على نفسه لهم خمسة أمور:
أحدها: أن لا يحتجز دونهم سرّاً في الأمور المصلحيّة إلَّا في الحرب.
ويحتمل ترك مشورتهم هناك أمرين:
أحدهما: أنّ أكثرهم ربّما لا يختار الحرب فلو توقّف على المشورة فيه لما استقام أمره بها. ولذلك كان عليه السّلام كثيرا ما يحملهم على الجهاد ويتضجّر من تثاقلهم عليه، وهم له كارهون،…
الثاني: أن يكتم ذلك خوف انتشاره إلى العدوّ فيكون سبب استعداده وتأهّبه للحرب…
الثاني: أنّه لا يطوي دونهم أمراً إلَّا في حكم. استعار لفظ الطيّ لكتمان الأمر: أي لا يخفى عنكم أمرا إلَّا أن يكون حكماً من أحكام اللَّه فإني أقضيه دونكم من غير مراقبة ومشاورة فيه كالحدود وغيرها.
الثالث: أن لا يؤخّر لهم حقّاً عن محلَّه كالعطاء وساير الحقوق اللازمة له ولا يقف به دون مقطعه كالأحكام المتعلَّقة بالمتخاصمين المحتاجة إلى الفصل.
الرابع: أن يسوى بينهم في الحقّ.
والأوّلان مقتضى فضيلة الحكمة، والثالث والرابع مقتضى فضيلة العدل”(117).
خاتمة:
ليس لأيّ شخصٍ تَسلَّط على رقاب المسلمين بالقوة والقهر أن يطالبهم بالطاعة العمياء، ويفرض عليهم ما يشاء من الآراء، وليس له أن يتصرف بالعباد والبلاد كيف يريد وحسب ما يشاء، بل الحاكم في نظر الإسلام عبدٌ كلّفه الله (عزَّ وجلَّ) برعاية مصلحة الأمّة والأخذ بالمجتمع نحو ما فيه رضا الله (سبحانه وتعالى)، فالحاكم عليه واجبات لا بدّ من أن يفي بها وأن يؤديها، أولها تقوى الله (سبحانه وتعالى) والحكم بالعدل وفق شرع الله (عزَّ وجل).
ولا شك في أن للحاكم حقوقاً على أبناء الأمّة يعينه وفاؤهم بها على أداء تكاليفه على أتم وجه، فالحقوق والواجبات أمور متبادلة بين الحاكم والمحكوم وأينما أدى كل من الطرفين ما عليه للطرف الآخر كان التقدم والرقي والعكس صحيح.
ولو بُحث في التاريخ الإنساني عن حاكم أفضل من أمير المؤمنين (عليه السلام) -بعد الرسول المصطفى (صلَّى الله عليه وآله)- فلن يوجد؛ ولذلك كان أخذ الحكام بوصاياه خيراً لهم ولشعوبهم، ومن نعم الله (جلَّ جلاله) على أهل البحرين أن غرس هذه الوصايا في وجدانهم كجزء لا ينفصل عن التراث الإيماني العظيم الواصل من أهل بيت الطهارة (عليهم السلام)، ويجب عليهم من باب شكر المنعم أن يحافظوا عليها وأن يتمسكوا بها، فلا يفرطوا فيها أو يستبدلوها بالغث والهزيل من أطروحات الشرق والغرب البعيدة عن الهدي الإلهي المنير.
وبعد هذه الإطلالة السريعة على بعض ما أُثِر عن الشيخ ميثم البحراني (قدِّس سرُّه) في شرحه لنهج البلاغة يتضح البون الشاسع بين ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم وما عليه حكام المسلمين اليوم، وأنّ ما يطلبه أبناء الأمّة الإسلامية اليوم من تغيير أو إصلاح للأنظمة الحاكمة هو ما يفرضه عليهم تاريخهم وثقافتهم الإسلامية العريقة، وأن إهمال هذا الإرث وزهدهم فيه هو انسلاخ عن هويتهم المحمدية.
وأسأل الله (سبحانه وتعالى) أن يمنّ على بلادنا وعموم بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار وأن يبعد عن أمّة محمد (صلَّى الله عليه وآله) الشر والضر، إنه رحيم كريم.
الهوامش:
- (1) لعلّ أفضل ترجمة محققة للشيخ ميثم البحراني هو المقال الذي كتبه أستاذنا الشيخ فاضل الزاكي –حفظه الله- بعنوان «العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني» ونشر في قسمين في رسالة القلم العددين 10 و11 فراجع.
- (2) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص168، الطبعة الأولى 1427هـ أنوار الهدى-قم.
- (3) المصدر نفسه، ج5، ص168.
- (4) المصدر نفسه، ج5، ص169.
- (5) المصدر نفسه، ج4، ص115.
- (6) المصدر نفسه، ج5، ص169.
- (7) المصدر نفسه، ج5، ص211-212.
- (8) المصدر نفسه، ج5، ص217-218.
- (9) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، ج3، ص214، الطبعة: الأولى، 1429 هـ، دار الحديث – قم.
- (10) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص170.
- (11) المصدر نفسه، ج5، ص175.
- (12) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، ج4، ص34، الطبعة: الأولى، 1429 هـ، دار الحديث – قم.
- (13) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص170.
- (14) المصدر نفسه، ج5، ص175.
- (15) كتاب العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ج1، ص250، الطبعة الثانية 1409 هـ، نشر الهجرة – قم.
- (16) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص170.
- (17) المصدر نفسه، ج5، ص176.
- (18) المصدر نفسه، ج5، ص171.
- (19) المصدر نفسه، ج5، ص176.
- (20) تاج العروس، مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد، ج10، ص477-478، الطبعة الأولى 1414هـ، دار الفكر – بيروت.
- (21) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص171.
- (22) المصدر نفسه، ج5، ص176.
- (23) الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، محمد حسين، ج1، ص371، الطبعة الثانية 1412 هـ إسماعيليان – قم.
- (24) جامع السعادات، النراقي، محمد مهدي، ج1، ص276، الطبعة السابعة 1428هـ إسماعيليان – قم.
- (25) لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، ج2، ص406، الطبعة الثالثة 1414هـ دار صادر – بيروت.
- (26) جامع السعادات، النراقي، محمد مهدي، ج1، ص328 وص345، الطبعة السابعة 1428هـ إسماعيليان – قم.
- (27) المصدر نفسه، ج1، ص266.
- (28) كتاب العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ج8، ص34، الطبعة الثانية 1409 هـ، نشر الهجرة – قم.
- (29) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص215.
- (30) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص226.
- (31) المصدر نفسه، ج5، ص172.
- (32) المصدر نفسه، ج5، ص180.
- (33) جامع السعادات، النراقي، محمد مهدي، ج1، ص298، الطبعة السابعة 1428هـ إسماعيليان – قم.
- (34) كتاب العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ج1، ص140، الطبعة الثانية 1409 هـ، نشر الهجرة – قم.
- (35) تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، ص488، الطبعة الثانية 1404هـ، جماعة المدرسين – قم.
- (36) نهج البلاغة (لصبحي صالح)، الشريف الرضي، محمد بن حسين، ص501، الطبعة الأولى 1414هـ، الهجرة – قم.
- (37) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص171.
- (38) سورة الرعد:11.
- (39) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص177.
- (40) المصدر نفسه، ج5، ص171.
- (41) المصدر نفسه، ج5، ص177.
- (42) المصدر نفسه، ج5، ص171.
- (43) المصدر نفسه، ج5، ص177.
- (44) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، ج3، ص754، الطبعة: الأولى، 1429 هـ، دار الحديث – قم.
- (45) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص215.
- (46) المصدر نفسه، ج5، ص224.
- (47) المصدر نفسه، ج5، ص171. (48) المصدر نفسه، ج5، ص178.
- (49) لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، ج9، ص332، الطبعة الثالثة 1414هـ دار صادر – بيروت.
- (50) النمل:40.
- (51) النحل:90.
- (52) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص428.
- (53) المصدر نفسه، ج5، ص172. (54) المصدر نفسه، ج5، ص178.
- (55) عيون أخبار الرضا، ابن بابويه، محمد بن علي، ج2، ص28، الطبعة الأولى 1420هـ، نشر جهان – طهران.
- (56) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص173.
- (57) آل عمران:188.
- (58) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص182-184.
- (59) المصدر نفسه، ج5، ص173.
- (60) المصدر نفسه، ج5، ص184.
- (61) تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، ص37، الطبعة الثانية 1404هـ، جماعة المدرسين – قم.
- (62) عيون الحكم والمواعظ، الليثي الواسطي، علي بن محمد، ص127، الطبعة الأولى 1418هـ، دار الحديث – قم.
- (63) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص174.
- (64) المصدر نفسه، ج5، ص184.
- (65) المصدر نفسه، ج5، ص172.
- (66) المصدر نفسه، ج5، ص181-182.
- (67) المصدر نفسه، ج5، ص186.
- (68) أي يثقله: النهاية، ابن الأثير الجزري، مبارك بن محمد، ج3، ص96، الطبعة الرابعة 1409 هـ مؤسسة إسماعيليان – قم.
- (69) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص195.
- (70) المصدر نفسه، ج5، ص188.
- (71) المصدر نفسه، ج5، ص199.
- (72) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، ج14، ص638، الطبعة: الأولى، 1429 هـ، دار الحديث – قم.
- (73) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص188.
- (74) المصدر نفسه، ج5، ص201.
- (75) المصدر نفسه، ج5، ص189.
- (76) المصدر نفسه، ج5، ص203-204.
- (77) المصدر نفسه، ج5، ص191.
- (78) المصدر نفسه، ج5، ص208-209.
- (79) المصدر نفسه، ج5، ص211.
- (80) المصدر نفسه، ج5، ص216.
- (81) المصدر نفسه، ج5، ص216.
- (82) المصدر نفسه، ج5، ص216.
- (83) المصدر نفسه، ج5، ص213.
- (84) المصدر نفسه، ج5، ص219.
- (85) المصدر نفسه، ج5، ص213.
- (86) المصدر نفسه، ج5، ص220. (
- 87) المصدر نفسه، ج5، ص213.
- (88) المصدر نفسه، ج5، ص220.
- (89) المصدر نفسه، ج5، ص213.
- (90) المصدر نفسه، ج5، ص221.
- (91) المصدر نفسه، ج5، ص213-214.
- (92) المصدر نفسه، ج5، ص221.
- (93) المصدر نفسه، ج5، ص214.
- (94) المصدر نفسه، ج5، ص223.
- (95) المصدر نفسه، ج5، ص214.
- (96) المصدر نفسه، ج5، ص224.
- (97) المصدر نفسه، ج5، ص215.
- (98) سورة البقرة: 264.
- (99) سورة الصف:3.
- (100) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج5، ص224.
- (101) المصدر نفسه، ج5، ص215.
- (102) المصدر نفسه، ج5، ص226.
- (103) المصدر نفسه، ج3، ص188.
- (104) المصدر نفسه، ج3، ص190.
- (105) مستدرك الوسائل، النوري، حسين بن محمد تقي، ج7، ص13، الطبعة الأولى 1408هـ، مؤسسة آل البيت – قم.
- (106) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج3، ص190.
- (107) غرر الحكم ودرر الكلم، التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ص97، الطبعة الثانية 1410هـ، دار الكتاب الإسلامي – قم.
- (108) تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، ص73-74، الطبعة الثانية 1404هـ، جماعة المدرسين – قم.
- (109) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج3، ص190.
- (110) كتاب العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ج6، ص190، الطبعة الثانية 1409 هـ، نشر الهجرة – قم.
- (111) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج3، ص190.
- (112) جامع السعادات، النراقي، محمد مهدي، ج1، ص207، الطبعة السابعة 1428هـ إسماعيليان – قم.
- (113) تاج العروس، مرتضي الزبيدي، محمد بن محمد، ج14، ص245، الطبعة الأولى 1414هـ، دار الفكر – بيروت.
- (114) شرح نهج البلاغة، بن ميثم البحراني، ج3، ص190.
- (115) المصدر نفسه، ج3، ص191.
- (116) المصدر نفسه، ج5، ص160.
- (117) المصدر نفسه، ج5، ص160.