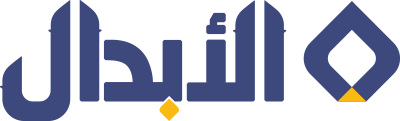الولاية والبراءة

- الولاية امتداد للمحور الإلهي
- ضرورة توحيد الولاء
- الله تعالى وحده مصدر الولاية والحاكمية والسلطان
- دور الولاية وأهميتها في حياة الأُمّة
- الإنسان بين محوري «الولاية» و«الطاغوت»
- ربط الإنسان بالله وتعبيده لله تعالى
- خصائص الصراع بين محوري «الولاية» و«الطاغوت»
- واقعة الطف محك «الولاء» و«البراءة»
- أقرأ ايضاً:
- المصادر والمراجع
ولما كانت رسالة هذا الدين رسالة عالمية، وكانت مهمة الأُمّة هي إبلاغ هذه الرسالة إلى البشرية جميعاً، وتحرير الإنسان من الطاغوت، وتعبيده لله الواحد، كان لابُدّ لهذا الدين أن يكون ذو طبيعة حركية وجهادية، وهذا يتطلب من الأُمّة حالتين أساسيتين في الداخل والخارج، وهما:
1 ـ التماسك والترابط والتواصل من الداخل
فقال تعالى: {وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}[1].
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}[2].
وفي الحديث:
- عن رسول الله “ص”: <مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سائر الجسد بالسهر والحمى>.
- وعنه “ص”: <المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً>[3].
- وعن الإمام الصادق “ع”: <تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله>[4].
2 ـ المفاصلة الكاملة مع أعداء الله ورسوله الذين يتربصون بهذا الدين سوءاً.
يقول تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ}[5].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[6].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[7].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ}[8].
وهذه هي حالة البراءة من أعداء الله تعالى وأعداء الرسول “ص” وتحريم موالاتهم ومودتهم والتحبب إليهم.
ويتطلب هذا الترابط القوي من الداخل، وهذه المفاصلة التامة من الخارج، وجود قيادة مركزية تتولى قيادة مسيرة الأُمّة لمواجهة التحديات واجتياز العقبات، تعمل على ربط هذه الأُمّة بعضها ببعض في كتلة مرصوصة واحدة من الداخل، وفصلها عن أعدائها الذين يريدون بها سوءاً من الخارج[9] ثم تقوم بتوجيه هذه الكتلة المجتمعة باتجاه تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدعوة على وجه الأرض كلها.
وهذه القيادة التي لابُدّ من وجودها في كيان هذه الأُمّة، والتي تمتلك من الأُمّة الطاعة والنصرة والحب (العناصر الثلاثة للولاء)، هي التي يصطلح عليها القرآن الكريم بإسم الإمام أو ولي الأمر.
الولاية امتداد للمحور الإلهي
إلاّ أن هذا المحور الذي يستقطب الطاعة والتأييد والنصر والحب من الأُمّة لا يعتبر محوراً آخر في قبال المحور الرباني للولاية في هذا الكون، ولن يكون محوراً جديداً غير هذا المحور الإلهي؛ فإنّ أي محور آخر للولاية في قبال المحور الإلهي هو طاغوت تجب مكافحته ومحاربته.
فيكون الولي ـ إذن ـ امتداداً لهذا المحور الرباني، وتجب طاعته ونصره وحبه امتداداً لوجوب طاعة الله ونصره وحبه.
وليس محوراً جديداً، والولاية من أهم مقولات التوحيد، ولايمكن أن تتعدد محاور الولاء أبداً.
والولاء إمّا أن يكون أو لا يكون.
فإذا كان الولاء لله فلابُدّ وأن يكون بوجهه الايجابي والسلبي (الذي هو رفض الولاء لغير الله) معاً، ولا تقل قيمة الوجه السلبي عن قيمة الوجه الايجابي.
ولا يتم الولاء لله تعالى إِلاّ برفض أي ولاء آخر إلى جانب ولاء الله فضلا عن أن يكون من دونه.
ضرورة توحيد الولاء
وبناءً على ما تقدم فإنّ مسألة توحيد الولاء من أهم خصائص الولاء، وقد سبق أن أشرنا إلى أن أكثر مصاديق الشرك في القرآن الكريم هو الشرك في الولاء وليس الشرك في الخالق.
قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً}[10].
يضرب الله سبحانه لنا مثلا في «التوحيد» و«الشرك» برجلين:
أحدهما: يتنازعه شركاء متشاكسون، لكل واحد منهم ولاية عليه وسلطان، فهؤلاء الشركاء مختلفون فيما بينهم، وهو موزع بينهم.
والآخر: قد أسلم أمره إلى رجل واحد فقط {وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ}، يطيعه في كل شيء، وينقاد له في كل أمر، ويتقبل ولايته وحاكميته في كل شأن بلا منازع، وهكذا الأمر بالنسبة للتوحيد والشرك.
فالموحدون من الناس كالرجل الثاني الذي أسلم أمره لواحد، فهو في راحة من أمره.
والمشركون من الناس كالرجل الأول الذي يتنازعه شركاء متشاكسون.
وقال تعالى عن لسان يوسف “ع”: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}[11].
إن صاحبي يوسف “ع” في السجن لم يكونا ينكران الله الواحد القهار، وإنما كانا يشركان أرباباً متفرقين مع الله في الولاية والحاكمية على حياتهم، فأنكر يوسف “ع” عليهم أنهم لم يسلّموا أمورهم كلها لله الواحد القهار.
ويقول أميرالمؤمنين “ع” في أسباب البعثة: <بعث الله محمداً “ص” ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن عهود عباده إلى عهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته>[12].
الله تعالى وحده مصدر الولاية والحاكمية والسلطان
فالولاية ـ إذن ـ محور ثابت، لا يتعدد، ولا يتجزأ، ولا يتغير، وهي لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يمنح هذه الولاية إلى من يشاء من عباده، والى من يرتضي من الناس.
فلن تكون ثمة ولاية ـ إذن ـ في قبال ولاية الله.
ولن تكون هناك أي ولاية ـ أبداً ـ بغير إذن الله، ولا حاكمية من دون أمره[13].
فإنّ الولاية المشروعة في حياة الأُمّة، لما كانت امتداداً لولاية الله، فإنّها لابُدّ وان تكون بإذن الله وأمره.
وما لم يأذن الله لأَحد من الناس بأن يلي أمر عباده لن يكون له الحق في أن يتولى شيئاً من أمور الأُمّة.
وبمراجعة القرآن الكريم نجد هذه الحقيقة واضحة فيما يحكي الله تعالى لنا من تنصيب عباد لـه أولياءاً وأئمةً وخلفاء على الناس، لم تتم لهم إمامة ولا ولاية على الأُمّة لولا أن الله تعالى قد خصّهم بذلك وأناط إليهم هذا الأمر.
ففي قصة إبراهيم “ع”، يقول تعالى: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي؟ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[14].
والإمامة ـ هنا ـ بمعنى الولاية، فقد جعله الله تعالى إماماً بعد أن كان نبياً.
وفي قصة داود “ع”، يقول تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}[15].
والخلافة هنا بقرينة قوله تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} هي الولاية والحاكمية.
يقول تعالى عن ذرية إبراهيم “ع” لما نجّاه الله تعالى من القوم الظالمين: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}[16].
ولا نريد ـ هنا ـ أن نسهب في هذا القول، فله مجاله الخاص في البحث، وإنّما نريد ـ فقط ـ أن نشير إشارة سريعة إلى أن مصدر الحاكمية والسلطان في حياة الإنسان هو الله تعالى، وليس الأُمّة ـ كما تذهب الاتجاهات الديمقراطية إلى ذلك ـ، وليس لأحد من دون إذن الله تعالى أن يتولى أمراً من أمور المسلمين، كما أن الله تعالى لم يفوّض الناس هذه الصلاحية في اختيار من يرونه أهلا للولاية والإمامة.
فالأصل في الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى مصدر السلطة والحاكمية في حياة الناس، وليس هناك في النصوص الشرعية ما يشير إلى أن الله عزّوجلّ قد فوّض الأُمّةَ هذا الأمر.
فولاية الله تعالى ـ في حياة الناس لا يقتصر أمرها ـ إذن ـ على نفوذ الأحكام الشرعية المحددة من قبل الله تعالى في حق عباده، وإنما تعني الممارسة الفعلية للحاكمية، والأمر والنهي في حياة الإنسان من خلال أُولئك الذين اتخذهم الله أولياء لـه، وجعلهم أئمة للبشر وخلفاء على الناس.
دور الولاية وأهميتها في حياة الأُمّة
هناك طائفة واسعة من النصوص الإسلامية التي وردت في أهمية الولاية وقيمتها في حياة الأُمّة، وموقعها من هذا الدين الحنيف، ونذكر نماذج منها:
- عن أبي جعفر “ع” أنه قال: <بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية>[17].
- وعن عجلان بن صالح قال: <قلت لأبي عبد الله “ع” أوقفني على حدود الإيمان، فقال “ع”: شهادة أن لا اله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله، وصلاة الخمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وولاية ولينا، وعداوة عدونا، والدخول مع الصادقين>[18].
- وعن أبي جعفر “ع” أنه قال: <بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، قال زرارة (راوي الحديث) فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال “ع”: الولاية أفضل، لأنه مفتاحهن، و الوالي هو الدليل عليهن… ثم قال “ع”: ذروة الأمر، وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عزّوجلّ يقول: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}[19]. أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله، فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان لـه على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان… ثم قال “ع”: أُولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته>[20].
ويتوقف الإنسان للتأمل في هذا الحديث طويلا، فمن قام ليله وصام نهاره… ولم يعرف ولاية ولي الله ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان؛ وذلك لان جوهر الدين ليس عبارة عن مجموعة تعليمات من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات، وإنما هو الارتباط بالله ورسوله وأوليائه.
وعن طريق هذا الارتباط يتم للإنسان المؤمن تحديد معالم دينه.
وقد أمر رسول الله “ص” أمته من بعده بالارتباط بأهل بيته “ع” بعد كتاب الله لتحديد معالم دينهم.
يقول رسول الله “ص”: «ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين; أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال “ص”: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي»[21].
وعن طريق هذا الارتباط يتم تنظيم المجتمع، وتحريك الأُمّة، وتوجيهها، وقيادتها باتجاه تحرير الإنسان من عبودية الهوى والطاغوت، وتعبيده لله الواحد الأحد وترسيخ الدعوة إلى الله على وجه الأرض.
فمسألة الولاية ـ إذن ـ مسألة أساسية في هذا الدين، ولا يستطيع هذا الدين أن يؤدي دوره الأساسي في ربط الإنسان بالله تعالى، وفي قيادة الإنسان إلى تحقيق أهداف هذا الدين في الحياة، وتعبيد الإنسان لله، وإزالة الحواجز التي يزرعها الطاغوت في طريق هذه الدعوة من دون «الولاية».
وهذه الحقيقة تقرر حتمية الصراع بين محوري «الولاية» و«الطاغوت»، بشكل دائم في تاريخ الإنسان.
الإنسان بين محوري «الولاية» و«الطاغوت»
إن هذين المحورين يعملان باتجاهين متعاكسين في حياة الإنسان، وكل منهما يعمل لاستقطاب ولاء الإنسان ويحاول فصل الإنسان عن المحور الآخر.
إذن، رسالة الولاء لله تعالى هي:
ـ استقطاب ولاء الأُمّة حول محور الولاية، وإنقاذ الأُمّة من التشتت والضياع والاختلاف.
ـ توجيه الأُمّة وتوحيد حركتها باتجاه إسقاط محور الطاغوت وتحرير الإنسان من عبودية الطاغوت والهوى.
ـ إسقاط الطاغوت وإزالة العقبات من أمام طريق الإنسان إلى الله تعالى.
ربط الإنسان بالله وتعبيده لله تعالى
وفي قبال هذا المحور الرباني، يعمل محور الطاغوت على استقطاب ولاء الناس، ويحاول وضع الحواجز والعقبات في طريق الناس إلى الله تعالى، ويسعى لاستعباد الإنسان وإخراجه من النور إلى الظلمات.
والى هذا الصراع بين محوري «الولاية» و«الطاغوت» تشير الآية الكريمة: {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[22].
ولما كانت هذه المهمة التي يتولى أمرها الطاغوت، لا تتحقق إلاّ من خلال استضعاف الإنسان وإذلاله فإنّ الطاغوت يتبع أساليب كثيرة في استضعاف الإنسان، وسلب ثقته بنفسه وتضليله وعند ذلك ـ فقط ـ يتيسر للطاغوت أن يكسب ولاء الإنسان وطاعته وانقياده.
يقول تعالى عن فرعون: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ}[23].
ومهما يكن من أمر فإنّ الصراع بين هذين المحورين: محور الولاية ومحور الطاغوت، هو من كبريات قضايا التاريخ ومن أهم العوامل المحركة لعجلة التاريخ.
ومن خلال فهم هذا الصراع نستطيع أن نفهم الكثير من أحداث التاريخ وقضاياه الكبرى ومنعطفاته وثوابته ومتغيراته.
خصائص الصراع بين محوري «الولاية» و«الطاغوت»
ومن خصائص هذا الصراع التاريخي، والمعركة الممتدة بين محوري الولاية والطاغوت (الحق والباطل):
1 ـ إن المعركة عقائدية في جوهرها:
يتمثل في صراع عقائدي حول «التوحيد» و«الشرك».
وقد ورد أكثر موارد «الشرك» و«التوحيد» في القرآن الكريم، في التوحيد والشرك في الولاء.
2 ـ إنها معركة حضارية بين حضارتين:
لكل منهما خصائصها التي تميزها عن الأخرى، وهما «الحضارة الربانية» و«الحضارة الجاهلية».
إِذن الانتماء إلى أي من المحورين ليس ـ فقط ـ انتماءاً سياسياً إلى محاور القوة والسيادة، وإِنما هو ـ أيضاً ـ انتماء حضاري تستتبعه خصائص ومميزات حضارية في أسلوب التفكير والأخلاق والعمل والعلاقة مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين ومع الأشياء.
فالصراع بين هذين المحورين ـ إذن ـ بمعنى الصراع بين حضارتين بكل دقة.
3 ـ إنها معركة سياسية على مراكز القوى:
من المال والقوة العسكرية ووسائل التوجيه والثقافة والإعلام.
فلاشكّ في أن كلا من هذين المحورين يعمل للاستيلاء على مراكز القوى في المجتمع، ويعمل لاستخدام هذه المراكز لتمكين محوره وخطه.
4 ـ إنها معركة حتمية:
تدخل ضمن حتميات التاريخ الكبرى، ولايمكن للإنسان أن يتخلص منها أو يتجنب آثارها بأي حال من الأحوال.
حيث أَنّ طبيعة تقاطع تلك المحاور والخطوط تستدعي حتمية هذه المعركة في كل زمان ومكان.
ولذا، فإنّ أي عصر من العصور لم يخل من هذا الصراع… فهو قائم بين المحورين منذ أن خلق الله تعالى الإنسان ـ بهذه التركيبة الخاصة ـ على وجه الأرض، وحتى يومنا الحاضر.
وقد قرر القرآن الكريم حتمية هذا الصراع بين المحورين بشكل جازم، حيث قال تعالى:
{الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}[24].
5 ـ إنها معركة مصيرية قد تطول وتدوم:
حيث أَنّ كل محور من المحورين يعمل على استئصال المحور الآخر من على وجه الأرض، وإِنهائه وتصفية مراكزه ومواقعه ووجوده بشكل عام.
فهي ليست معركة من أجل أرض أو ماء، وهي ليست معركة من أجل حدود برية أو بحرية، وهي ليست معركة من أجل آبار من النفط أو معدن ذهب أو فضة، وإنما هي معركة من أجل الوجود والكيان، ولا يرضى كل من الطرفين إلاّ بتصفية الطرف الآخر تصفية كاملة.
قال تعالى: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}[25].
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}[26].
فهذه المعركة تستمر حتى الاستئصال الكامل للكفر والجاهلية، والقضاء المبرم على الفتنة من على وجه الأرض، وإنهاء حالة التمرد على الله ورسوله إنهاء تاماً.
ولذلك فإنّ هذه المعركة معركة شرسة وحرب ضارية لايعرف التاريخ نظيراً لها في الشراسة والقسوة والحدّية.
والتفكير في اللقاء والتفاهم والحلول النصفية مع الكفر والطاغوت، هو تفكير فيه كثير من الفجاجة والضعف والهزيمة النفسية التي تؤدي إلى الخسران، إذ إن الهزيمة النفسية هي بداية كل هزيمة ميدانية، وبداية الهزيمة النفسية هي التفكير في إمكان اللقاء والتفاهم مع الطاغوت وإنهاء الصراع معه، والجلوس معه على موائد الصلح.
إن المعركة مع الطاغوت ـ إِذن ـ معركة وجود وليست معركة حدود، حتى يمكن التفاهم والتصافي والتعايش بسلام وتطبيع العلاقات.
6 ـ إنها تتطلب موقفا من الأُمّة المؤمنة:
وأن تكون مواقفها واضحة وجدية وحاسمة في مسألة إعلان «الولاء» و«البراءة»، إعلان الولاء لله ولرسوله ولأولياء أمور المسلمين، وإعلان البراءة من أعداء الله ورسوله وأوليائه.
فلابُدّ ـ إذن ـ من موقف.
ولابُدّ وأن يكون الموقف واضحاً وحدياً ومعلناً.
فإنّ المعركة مع أئمة الكفر جدٌ لا هزل فيها و لا مراء.
وإنها لقائمة لا انتظار لها.
وإنها لضارية لا تردد فيها أو استرخاء.
فلا يكفي أن يضمر الإنسان الحب لله ولرسوله ولأوليائه، من دون أن يكون له موقف، ومن دون أن يعرف الناس عنه ذلك.
ولايكفي أن يكون قلب الإنسان مع الله ورسوله وأوليائه، ويكون سيفه وحرابه عليهم[27].
ولا يكفي أن يعطي المرء لله ورسوله وأوليائه بعضاً من نفسه وماله، ليعطي البعض الآخر منها للطاغوت.
ولا يكفي أن يعطي نفسه كلها لله تعالى، ولكنه يجامل الطاغوت أو يحتفظ لنفسه ببعض جسور العودة.
ذلك، لان الولاء كل لا يتجزأ وحقيقة وليس مجاز، وجدّ وليس بهزل.
فإمّا أن يكون كله لله تعالى، وإمّا أن لا يكون لله منه نصيب {فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.
فالولاء ـ إذن ـ يتطلب الموقف المحدد الثابت، والإِشهار بالموقف في مسألة (الانتماء) و(الانفصال)، وفي الحب والبغض، وفي المودة والمعاداة، وفي التولي والتبرّي، وفي السلم والحرب.
7 ـ إن (الولاء) و(البراءة) وجهان لحقيقة واحدة:
في هذه الصراع التاريخي وما تتطلبه من مواقف.
فلا ينفع «ولاء» من دون «براءة»، ولا يؤدي الولاء دوره الفاعل والمؤثر في حياة الأُمّة مالم يقترن بالبراءة من أعداء الله ورسوله وأوليائه.
فالموقف هنا لا يتكون من «الولاء» وحده، وإنما له وجهان: وجه ايجابي ووجه سالب، سلم وحرب، رحمة وقسوة، انتماء وانفصال، حب وبغض.
وما لم يجتمع هذان الوجهان في موقف الإنسان، فإنّ الموقف لن يكون موقفاً حقيقياً، متكاملا وإنما يكون شعبة من شعب النفاق وطوراً من أطوار المجاملة السياسية واللعب على الحبال.
قال تعالى: {أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ}[28].
8 ـ إن محور الطاغوت خط وحضارة وامتداد واحد:
كما أن محور الولاية مركز واحد، وخط واحد، وامتداد واحد على طول التاريخ. ونحن لا نفرق في الولاء بين أنبياء الله وأوليائه، القريب منهم من عصرنا والبعيد منهم عن عصرنا، فكلهم يحملون رسالة الله، ويبلغون دين الله، آتاهم الله من لدنه النبوة والإمامة والولاية على عباده. نواليهم جميعاً ونؤمن بما أنزل الله إليهم، ولانفرق بين أحد منهم، فإذا اختلفوا في بعض تفاصيل الشريعة بحكم اختلاف ظروف التنزيل نعمل بشريعة خاتم الأنبياء
قال تعالى: {قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}[29].
وقال سبحانه: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}[30].
وكما نوالي أولياء الله جميعاً، يجب أن نتبرأ من أعدائهم جميعاً.
وكما أن الولاء أمر واحد، فإنّ البراءة أمر واحد أيضاً.
فيجب أن نتبرأ من فرعون ونمرود، كما نتبرأ من أبي جهل ويزيد، وكما نتبرأ من طغاة عصرنا وجلاوزته.
فإنّ المعركة بين محوري (الحق) و(الباطل)، و(الهدى) و(الضلال)، و(أُولي الأمر) و(الطاغوت)، هي معركة حضارية، ولكل من الجبهتين جذورها الحضارية في أعماق الهدى أو الضلال، والمعركة في جوهرها معركة واحدة في كل مراحلها التاريخية، والولاء ولاء واحد والبراءة براءة واحدة، في كل مراحل الصراع.
واقعة الطف محك «الولاء» و«البراءة»
بالرغم من مرور أكثر من ألف وثلاثمائة سنة على هذه الوقعة المفجعة… لا تزال تملك تأثيراً فوق العادة على النفوس والقلوب والعقول، وتفرض نفسها على كل من آتاه الله بصيرة ووعياً في دينه.
ولا تزال الأجيال تتلقى قضية كربلاء بحرارة وحماس، وتتفاعل معها في الإيجاب والسلب، في الولاء والبراءة، فما هو السر الكامن في هذه الوقعة؟
وما الذي جعل منها مرآة للولاء والبراءة، عبر هذا التاريخ الطويل؟
إن وقعة الطف تتميز بالوضوح الكامل الذي لايبقي شكاً لأحد في طرفي هذه المعركة.
فلم يكن بين المسلمين يومئذ من يتردد لحظة واحدة ـ وهو يقف على ساحة الصراع بين أبي عبد الله الحسين “ع” ويزيد بن معاوية ـ في الحكم بأن الحسين “ع” على هدى وأن يزيد على ضلال.
فمن وقف مع الحسين “ع” وقف عن بيّنة، ومن وقف مع يزيد وقف عن علم; وقليل من مشاهد الصراع بين الحق والباطل، تمتلك كل هذا الوضوح الذي تمتلكه وقعة الطف.
فقد وقف الإمام الحسين “ع” يوم عاشوراء بين الصَّفَين مخاطباً جيش ابن زياد: >قائلا أيها الناس انسبوني من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟. ألست ابن بنت نبيكم؟ وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدّق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أو لم يبلغكم قول رسول الله “ص” لي ولأخي: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإِن صدقتموني بما أقول وهو الحق، فوالله ما تعمّدت الكذب منذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، ويضرّ به من اختلقه، وان كذبتموني فإنّ فيكم من إن سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبرونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟
فقال الشمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول.
فقال لـه حبيب بن مظاهر: والله إني أراك تعبد الله على سبعين حرفاً، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك>[31].
وعندما حاول الوليد ـ عامل يزيد على المدينة ـ أن يجبر الإمام الحسين “ع” على البيعة ليزيد، قال الإمام “ع”: <أيها الأمير إِنا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله>[32].
لقد كانت الجبهتان المتصارعتان في كربلاء متميزتين في انتمائهما لله وللطاغوت، ولم يكن الأمر يخفى على أحد.
فقد مضى أصحاب الحسين “ع” ليلة العاشر ولهم دوي كدوّي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد[33].
| سمة العبيد من الخشوع عليهم | لله إن ضمتهم الأسحار | |
| وإذا ترجّلت الضحى شهدت لهم | بيض القواضب أنهم أحرار[34] |
تقول فاطمة بنت الحسين “ع”: <وأمّا عمتي زينب فإنّها لم تزل قائمة في تلك الليلة في محرابها تستغيث إلى ربها، والله فما هدأت لنا عين ولا سكنت لنا رنة>[35].
هكذا كان الأمر في معسكر الحسين “ع”، شوق إلى لقاء الله، وإقبال على الله، وإعراض عن الدنيا و زخرفها، وانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى، حتى أن بعضهم كان يداعب أصحابه ويمازحه في ليلة العاشر، فقد هازل برير عبد الرحمن الأنصاري عليهما الرحمة، فقال له عبد الرحمن: ما هذه ساعة باطل، فقال برير: لقد علم قومي ما أحببت الباطل كهلا ولا شاباً، ولكني مستبشر بما نحن لاقون، والله ما بيننا وبين الحور العين إلاّ أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم، ولوددت أنهم مالوا علينا الساعة[36].
وأمّا الطرف الآخر في هذه المعركة (معسكر يزيد) فقد كان همّه هو ما يصيبه من الذهب والفضة والإِمارة والجائزة، في قتال ابن بنت رسول الله “ص”.
فقد تولى عمر بن سعد أمر قتال ابن بنت رسول الله “ص” طمعاً في إمارة الري.
يقول اليافعي: ووعد الأمير المذكور (عمر بن سعد) أن يملّكه مدينة الري، فباع الفاسق الرشد بالغي[37].
وفيه يقول:
| أأترك ملك الري والري بغيتي | أو أرجع مأثوماً بقتل حسين |
ويقول الخطيب الخوارزمي:
وحزّ رأس الحسين بعض الفجرة الفاسقين، وحمله إلى ابن زياد، ودخل به عليه وهو يقول:
| أوقر ركابي فضة وذهبا | إِني قتلت الملك المحجّبا[38] | |
| قتلت خير الناس أُماً وأبا | وخيرهم إذ يذكرون النسبا |
فغضب ابن زياد من قوله وقال: إذا علمت أنه كذلك فلم قتلته؟ والله لا نِلْتَ مني خيراً أبداً ولألحقتك به[39].
ويتبجح الأخنس بن مرثد الحضرمي من رضهم للأجساد الطاهرة بعد استشهادهم، وهو يعلم أنه يعصي الله تعالى في طاعة أميره، فيقول ـ كما يروي الخوارزمي ـ:
| نحن رضضنا الظهر بعد الصدر | بكل يعبوب شديد الأسر | |
| حتى عصينا الله رب الأمر | بصنعنا مع الحسين الطهر[40] |
فلم يكن في الأمر ـ بالنسبة لكلا المعسكرين ـ أي خفاء، وجميع الذين حضروا المعركة أو شاهدوها، أو وقفوا عليها من قريب أو بعيد، كانوا يعرفون الحق والباطل فيها، وإنما تخلّف من تخلف إيثاراً للعافية ولم يشهر أحد فيها السيف على ابن بنت رسول الله “ص” عن لُبْس أو جهل بل عن وضوح وعلم ودراية بأنه يحارب الله ورسوله وأوليائه بقتال الحسين “ع”.
إن وقعة الطف لا تبقي مجالاً لأحد في التردد والتأمل، فهي المواجهة البيّنة بين الحق والباطل، بين جند الله وجند الشيطان، بين الهدى والضلال.
فلابُدّ من موقف محدد وواضح في هذه القضية.
فإن لم يكن هذا الموقف موقف الولاء لجند الله والبراءة من أعدائهم، فإنّه سيكون ـ لامحالة ـ موقف الرضى بفعل يزيد وجنده، وهو الموقف الذي يستحق عليه صاحبه اللعن والطرد من رحمة الله.
«فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به»[41].
فمن خذل الحسين “ع” ولم يقف معه يوم استنصر المسلمين، لابُدّ وأن يكون راضياً بفعل يزيد. ولو لم يكن كذلك لما أبطأ عن نصرة الإمام “ع”.
فالموقف المتفرّج من هذا الصراع يعتبر من الخذلان والموقف السلبي الذي يستحق عليه صاحبه اللعن والطرد من رحمة الله الواسعة.
وموقف الحسين “ع” وأصحابه يومئذ كان امتداداً لمواقف الأنبياء وأنصارهم في التاريخ. والولاء للحسين “ع” ولاء لكل أولياء الله تعالى في التاريخ، و البراءة من أعداء الحسين “ع” براءة من كل أعداء الله في التاريخ، وطريقة، السلام على الإمام الحسين “ع” في زيارة وارث، تشير إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة، تأمّلوا جيداً في هذا النص الذي يسلّط الأضواء على الأعماق الحضارية لمعركة الطف:
«السلام عليك ياوارث ادم صفوة الله، السلام عليك ياوارث نوح نبي الله، السلام عليك ياوارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك ياوارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك ياوارث محمد حبيب الله، السلام عليك ياوارث أميرالمؤمنين ولي الله».
إِنَّ هذه الصفوة من أولياء الله إِمتداد لهذه المسيرة المباركة العريقة في التاريخ.
كما إِن الذين أعلنوا الحرب عليهم كانوا امتداداً لأعداء الله ولمسيرة الطغيان والعصيان في التاريخ وكان همّهم إحباط دعوة الأنبياء، وكأَنهم كُتْلة واحدة في مقابل جبهة الأنبياء، وصدق الله تعالى حيث يقول: {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}[42] ويقول تعالى عن جبهة التوحيد: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}[43].
إن الإحساس بوحدة الولاء ووحدة البراءة يعمق وحدة المحور في حياة الأُمّة.
وان الشعور بوحدة المحور للأمة المسلمة يعمق الشعور بأن الأُمّة المسلمة على امتداد التاريخ ـ منذ ادم “ع” إلى اليوم الحاضر ـ هي أُسرة واحدة، تلتف حول محور واحد، وتحارب في جبهة واحدة، ومن أجل قضية واحدة، وتشترك في الحب والبغض والسلم والحرب، فقضيتها نفس القضية، ومهمتها على وجه الأرض واحدة، وخطها واحد، وحضارتها واحدة، وإيمانها واحد.
وعندما يتعمق الإحساس بوحدة الولاء ووحدة البراءة، ووحدة الحب ووحدة البغض، ووحدة الطاعة ووحدة العداء، ووحدة الإيمان، ووحدة الرفض، فسوف يتعمق الإحساس بوحدة الأُسرة المؤمنة في التاريخ وعلى وجه الأرض، فيشعر الإنسان المؤمن بأن الولاء لله ولرسوله ولأوليائه قد طوى به الزمان والمكان، ليجعل من هذه الأُمّة المسلمة كلها كتلة واحدة، تتحدى في مشاعرها وأحاسيسها وإيمانها وحربها وسلمها ورسالتها الكفر والشرك كله، ويشعر بالتحام قوي يربط بين أعضاء هذه الأُسرة العظيمة، رغم الفترات الزمنية والمسافات المكانية المتباعدة، وبذلك فإنّ الشعور بوحدة المصير سوف يقوى في نفسه ويتعمق، فيمنحه إحساساً بالقوة والاعتزاز بالله.
فهو ليس وحده في هذه المعركة الضاريةَ، وإنما هو امة مؤمنة عريقة في التاريخ، وممتدة على كل وجه الأرض، تستعين بالله الواحد القهار في إِرساء قواعد هذه الدعوة وتعبيد الناس لله تعالى، وتحكيم هذا الدين في حياة الناس، وإزالة كافة العقبات عن طريق الدعوة هذا.
إن هذا الإحساس بمعية الله ومعية المؤمنين سيزيل الشعور بالوحشة والإِنفِراد عن نفوس الدعاة إلى الله في خضّم الصراع مع الطاغوت ومواجهة شوكته وجبروته وكبريائه.
لقد كان إبراهيم “ع” وحده أمة، قانتاً لله في مواجهة نمرود.
قال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[44].
أقرأ ايضاً:
المصادر والمراجع
- [1] ـ الأنفال: 72.
- [2] ـ التوبة: 71.
- [3] ـ أخرجهما مسلم في صحيحه 8: 20 ـ ط. دار الفكر.
- [4] ـ بحار الأنوار 74: 399.
- [5] ـ آل عمران: 28.
- [6] ـ النساء: 144.
- [7] ـ المائدة: 51.
- [8] ـ التوبة: 23.
- [9] ـ راجع بحث (الولاية) بقلم ولي أمر المسلمين سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.
- [10] ـ الزمر: 29.
- [11] ـ يوسف: 39.
- [12] ـ الوافي 3: 22.
- [13] ـ تعتبر ولاية الفقيه كما نفهم من الروايات والنصوص الشرعية ـ منصب النيابة عن «ولي الأمر»، وليس هو نفس منصب «ولاية الأمر».
- حيث أن «ولي الأمر» في عصرنا الحالي هو الإمام الحجة#، وأما الفقهاء فهم نوابه في ولاية الأمر، وبذلك فإنّ الأمر بالنسبة للولي الفقيه ومسألة انتخابه واختياره من قبل الأُمّة ـ بعد إحراز توفر الشروط فيه ـ لا يكون نقضاً للأصل الذي ذكرناه هنا.
- [14] ـ البقرة: 124.
- [15] ـ سورة ص: 26.
- [16] ـ الأنبياء: 72 ـ 73.
- [17] ـ أصول الكافي 2: 18، بحار الأنوار 68: 329.
- [18] ـ أصول الكافي 2: 8، بحار الأنوار 68: 330.
- [19] ـ النساء: 80.
- [20] ـ أصول الكافي 2: 18، بحار الأنوار 68: 332 ـ 333.
- [21] ـ أخرج هذا الحديث أئمة الحديث بطرق كثيرة، وقد دوّن طرقها العلامة اللّكهنوي مير حامد حسين في عدة مجلدات من كتابه القيم العبقات. منها مثلا صحيح مسلم 7: 122.
- [22] ـ البقرة: 257.
- [23] ـ الزخرف: 54.
- [24] ـ النساء:76.
- [25] ـ البقرة: 120.
- [26] ـ الأنفال: 39 ـ 40.
- [27] ـ التقى الإمام الحسين× في مسيره إلى العراق بمنزل الصفاح بالفرزدق بن غالب (الشاعر) فسأله عن خبر الناس خلفه، فقال الفرزدق: قلوبهم معك والسيوف مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء. فقال الحسين×: صدقت، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء وكل يوم هو في شأن إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. الطبري 6: 218، وابن الأثير 4: 16.
- [28] ـ الفتح: 29.
- [29] ـ البقرة: 136.
- [30] ـ البقرة: 285.
- [31] ـ تاريخ الطبري 6: 243.
- [32] ـ مقتل الحسين للمرحوم السيد عبد الرزاق المقرم:127 ط.النجف.
- [33] ـ المصدر السابق: 238.
- [34] ـ ديوان السيد حيدر الحلي 1: 35 من قصيدة يرثي بها الحسين×.
- [35] ـ مثير الأحزان: 56.
- [36] ـ تاريخ الطبري 6: 241.
- [37] ـ مرآة الجنان لليافعي 1: 132.
- [38] ـ في بعض الروايات: (السيد المهذبا) بدلا من (الملك المحجبا).
- [39] ـ المصدر السابق: 238.
- [40] ـ مقتل الحسين لخطيب خوارزم 2: 39.
- [41] ـ زيارة وارث.
- [42] ـ الأنفال: 73.
- [43] ـ التوبة: 71.
- [44] ـ النحل: 120.