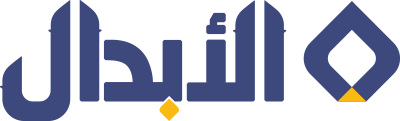الكمال الإنساني والتقرّب إلى الله

- القرب والبعد من الله تعالى:
- قيمة التقرب إلى الله في حياة الإنسان:
- أنحاء القرب:
- مرقاة الذكر:
- طيف العلاقة بالله:
- مِرقاة الصفات:
- صفات الجمال والجلال:
- القرب بالصفات:
- حركة الإنسان التكاملية القهرية:
- حركة الإنسان التكاملية الإرادية:
- السقوط الإرادي للإنسان:
- ميكانيكية الحركة التكاملية في الإنسان:
- دراسة تحليلية لآية من سورة التغابن:
- العقبات:
- الابتلاء:
- الوعي والإرادة:
- حالات العروج والسقوط:
- الخسران والفلاح:
- القرب إلى الله والبعد عنه:
- الإقبال والإعراض:
- الهوامش والمصادر
القرب والبعد من الله تعالى:
القرب والبعد من الله تعالى
التقرب إلى الله، ليس من قبيل القرب المكاني أو القرب الزماني، فإنّ الله تعالى يحيط بالمكان والزمان، ولا يحويه مكان ولا زمان حتى يمكن أن يتقرب الإنسان منه على فاصل مكاني أو زماني خاص، وإنما المقصود بالقرب مقولة اُخرى من (القرب) وهي (القرب المعنوي).
فإنّ في القرب المكاني أو الزماني ـ دائماً ـ تقارناً بين النقطتين المتقاربتين، فإذا كان (أ) قريباً من (ب) كان (ب) كذلك قريباً من (أ)، ومن غير الممكن أن يكون (أ) قريباً من (ب) و(ب) بعيداً عن (أ). وهذا التقارن يجري في القرب المكاني والزماني على نحو سواء.
وأمّا في القرب المعنوي فان الأمر يختلف، فقد يكون أمر قريباً من أمر آخر، والآخر بعيداً عنه، وليس بالضرورة أن يكون بينهما تقارن; وقرب الإنسان من الله وبعده عنه تعالى من هذا القبيل، فإن الله قريب من عباده، من دون شك، ولكن العبد قد يكون بعيداً عن الله; يقول تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}[1].
ويقول تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}[2].
ويقول تعالى:
{وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}[3]. ومع ذلك فقد يكون الإنسان بعيداً عن الله.
وفيما يأتي اذكر بعض الأمثلة على هذا الاختلاف في القرب والبعد بين الله تعالى وعباده.
قد يكون القرب بمعنى العلم والمعرفة والإحاطة; والبعد بمعنى الجهالة… والله تعالى قريب من عباده، عالم بهم، مطلع على سرائرهم، محيط بهم، والعبد بعيد عن الله غير عارف به.
وقد يكون القرب بمعنى الذكر; والبعد بمعنى الغفلة أو النسيان; والله تعالى ذاكرٌ لعباده، بينما عباده ينسونه ولا يذكرونه.
وقد يكون القرب بمعنى الحب والرأفة والشفقة، فنجد الله تعالى قريباً يحبّهم ويرأف بهم، ويشفق عليهم، بينما عباده يعرضون عنه وينأون ويصدّون عن ذكره، والله تعالى قريب من عباده لا يحجبه عنهم شيء: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} بينما تحجبنا نحن السيئات والذنوب عن الله، وتبعدنا عنه تبارك وتعالى.
إذن القرب والبعد من الله تعالى من مقولة اُخرى غير القرب والبعد (الزمكاني) في مساحة الزمان والمكان.
قيمة التقرب إلى الله في حياة الإنسان:
التقرب إلى الله تعالى غاية وقوام كل عبادة وعمل في الإسلام ومن دونه لا عبادة هناك، بل هو الغاية من خلق الإنسان، فإنما خلق الله تعالى الناس ليعبدوه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ}[4].
وهو روح هذا الدين وثمرة حياة الإنسان الذي يتكامل به في حركته التكاملية الصاعدة إلى الله; فان قيمة الإنسان وعمله في مقدار قربه من الله.
إن (الإخلاص) و(الرياء) لا يمسان مادة العمل، ومادة العمل سواء في الحالتين، ولكن الإخلاص يصعِّد العمل إلى الله. فإذا أراد الإنسان بنفس العمل التظاهر للناس (والرياء)، ولم يقصد به وجه الله، يبقى العمل حيث هو، ولا يصعد إلى الله أبداً، بل يهبط العمل بصاحبه إلى الحضيض; فإن الرياء نحو من أنحاء الشرك بالله; قال تعالى:{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[5]. والشرك من أخطر أنواع السقوط في حياة الإنسان.
أنحاء القرب:
للإنسان مِرقاتان وطريقان في التقرب الله تعالى:
أحدهما: هو القرب بالصفات (مرقاة الصفات)، ونريد به سعي الإنسان إلى اكتساب صفات الجمال الإلهية بقدر ما يتسع لذلك وعاء نفسه، وكلما أكتسب الإنسان شيئاً أكثر من صفات الجمال الإلهية حقق قرباً أكثر إلى الله.
ويختلف الناس في القرب والبعد من الله بقدر ما يكتسبون من صفات الله الجمالية، فمثلا أن الله كريم، فإذا استطاع الإنسان أن يتخلص من حالة الشحّ والبخل في نفسه، ويكتسب هذه الصفة الإلهية من صفات الجمال كان أقرب إلى الله تعالى من البخيل الذي تتمكن من نفسه حالة الشح والبخل.
وتبقى بعد ذلك الفاصلة اللامتناهية بين الكرم في الإنسان (الممكن) والكرم عند الله (الواجب)، فإن الكرم في الحالة الأُولى محدود وممكن ومخلوق، والكرم في الحالة الثانية مطلق وواجب، وكذلك العلم والعفو والعدل، وهذا هو معنى القرب بالصفات على نحو الإجمال.
والآخر: القرب بالذكر (مرقاة الذكر) وهو انفتاح الإنسان على الله تعالى وارتباطه وتعلقه به، بعد الإيمان بالبارئ ومعرفته اللذين يُعدان أساس كل ارتباط به وتقرب إليه عزّوجلّ.
مرقاة الذكر:
انّ في كل ذكر لله انشداداً وارتباطاً وتعلقاً به تعالى، كما أنّ في كل علاقة وارتباط بالله تعالى ذكراً له، وهما معنيان متلازمان إن لم يكونا مترادفين، وكلما يكثر ذكر الإنسان لله، ويرسخ الذكر في قلبه يزداد انشداداً به، وانفتاحاً عليه، والانشداد والانفتاح والتعلق من أوضح معاني (القرب)، قال تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ}[6].
فالاعتصام بالله نحو من العلاقة والارتباط بالله والقرب; قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ} [7].
والاستغفار نحو من العلاقة والارتباط بالله والقرب إليه: {وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[8].
وخشية الله نحو من العلاقة بالله والقرب إليه: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي}[9].
وتقوى الله نحو من العلاقة بالله والتقرب إليه: {اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ}[10].
ومعرفة الله نحو من العلاقة بالله والتقرب إليه {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}[11].
والحب نحو من الذكر، يتضمن انشداداً إلى الله وانفتاحاً عليه، وهما بمعنى القرب، والرجاء والخوف، والدعاء والتضرع والخشوع و… كل منها علاقة وارتباط بالله يفتح باباً جديداً على العبد للتقرب إليه تعالى.
فإذا إِعتصم الإنسان بالله تعالى كان قريباً منه، بطبيعة الحال، كما انه لو ترك الاعتصام بالله كان بعيداً من الله، ولو استغفر الإنسان الله واعتذر إليه تعالى كان قريباً منه، وان عصاه ولم يستغفر ولم يعتذر كان بعيداً منه تعالى بطبيعة الحال. وإذا كان الإنسان يخاف الله ويخشاه ويتقيه كان قريباً منه، وإذا كان لا يهاب الله ولا يخشاه ويعصيه ولا يتقيه تعالى كان بعيداً منه تعالى بالضرورة.
وإذا كان يحبّ الله كان قريباً منه، وان كان يبغض الله ويعاديه ـ والعياذ بالله ـ كان بعيداً منه بالضرورة، فإِنَّ الإنسان قريب ممن يحبه وبعيد ممن يكرَهه ويعاديه، وهو من البديهيات في العلاقات وإذا كان الإنسان يعرف الله كان قريباً منه، وإذا كان يجهل الله كان بعيداً منه تعالى، فان الإنسان قريب ممن يعرفه، وبعيد عمن يجهله.
والمقابلة هنا في هذه الأمثلة، بين حالة القرب والبعد في الحالتين توضح بشكل دقيق علاقة القرب بالذكر، والحالات التي ذكرتها في هذه الأمثلة من الاعتصام، والاستغفار، والخشية، والخوف، والتقوى، والحب، والمعرفة… كلها ألوان وأنحاء من الذكر… وفي هذه المقابلة بين القرب والبعد يتضح أن (الذكر) مرقاة للقرب إلى الله، وان الغفلة والجهل والعصيان، والعداء… تبعد الإنسان عن الله.
طيف العلاقة بالله:
والعلاقة بالله تعالى طيف متعدد الألوان، منها الإيمان والمعرفة والاعتصام به والولاية والأمل والرجاء والخوف والخشية، والخشوع والخضوع وحسن الظن بالله وغير ذلك مما يعتبر طيفاً متناسقاً للعلاقة والارتباط به سبحانه ويفتح للعبد على الله باباً من أبواب السلوك ويقربه إليه تعالى درجة.
ولقد حثّ الإسلام على توجيه الإنسان للعروج إلى الله تعالى من خلال (الذكر). وهذه هي المرقاة الثانية للعروج إلى الله تعالى، والتقرب منه.
مِرقاة الصفات:
صفات الجمال والجلال:
لله تعالى نوعان من الصفات هما صفات الجمال والجلال. صفات الجمال: هي الصفات الثبوتية التي تتصف بها الذات الإلهية المقدسة مثل العلم والعدل، والرحمة، والكرم، واللطف والقدرة. وصفات الجلال هي الصفات السلبية والتنزيهية للذات الإلهية، مثل تنزيه الله تعالى عن الشريك وتنزيهه عن الحاجة والضعف والفقر.
والنحو الثاني من الصفات يخص ذات الله تعالى وحده، ولا يشاركه فيه شيء من خلقه، ولا شأن لخلقه في شيء منه.
أمّا النحو الأوّل وهو صفات الجمال فإنّ الله تعالى قد وهب عباده الكثير منها; فرزقهم العلم والحلم والقوة والعدل والعفو واللطف والرحمة والحكمة والكرم.
إلاّ أنّ هذه الصفات في الذات الإلهية مطلقة وغير محدودة وواجبة، لا يمكن أن تنعدم أو تنقص أو تتغيّر أو تتحدد، وفي الإنسان محدودة وممكنة، يمكن أن توجد، ويمكن ألاّ توجد، ويمكن أن تنعدم، ويمكن أن تكثر أو تقل.
القرب بالصفات:
واكتساب هذه الطائفة من الصفات والتحلي بها يقرّب الإنسان إلى الله تعالى، وكلما يزداد حظّ الإنسان من هذه الصفات الجمالية يزداد حظه من القرب إلى الله تعالى.
إنّ مسألة القرب والبعد ليست مسألة (زمانية أو مكانية) بالتأكيد، ولا علاقة لها بالزمان والمكان… ولابُدّ من افتراض معنى آخر للقرب والبعد غير الزمان والمكان.
ولاشكّ أن التقارب بمعنى السنخية والتشابه في الصفات بين العبد وربّه هو من أصدق وأوضح مصاديق القرب، كما أنّ التخالف والتضاد في الصفات من ابرز مصاديق البعد، وهذه حقيقة وبديهة لا يمكن التشكيك فيها، فإن العالم قريب من العالم والجاهل بعيد عنه، والشجاع قريب من الشجاع والجبان بعيد عنه، والكريم قريب من الكريم والبخيل بعيد عنه.
والناس يختلفون في درجات القرب من الله تعالى على قدر اختلاف حظوظهم من صفات الله الجمالية. وإِمارة ذلك أن الإنسان كلما يزداد حظه من صفات الله الجمالية يزداد كمالا ونضجاً وبالتالي قرباً إلى الله تعالى.
وكلما يزداد حظُّ الإنسان من هذه الصفات يزداد حباً لله وذكراً وخشوعاً له تعالى وانفتاحاً عليه، وهو من ثمرات القرب إلى الله تعالى، وفي نفس الوقت من أسباب القرب ومفاتحه.
كيف يرتقي الإنسان بهذه المِرقاة إلى الله عزّوجلّ؟
وكيف يحقق هذا النحو من القرب إليه تعالى؟
وما هي مفاتيح هذا القرب؟
هذا ما نحاول أن نتحدث عنه إن شاء الله.
حركة الإنسان التكاملية القهرية:
قانون التكامل قانون عام في الكون لا يشذ عنه شيء، وخلاصة هذا القانون: أنّ كلّ مخلوق ينطوي على درجات من الكمال غير حاصلة بالفعل، وقد جرت سُنَّة الله تعالى في الكون على أن هذه المراحل من الكمال تبرز وتظهر بالتدريج، وبهذه الحركة يتحول الكائن من القوة إلى الفعل; فإن الكمالات التي يستبطنها الكائن هي كمالات موجودة بالقوة غير حاصلة بالفعل. ونقصد من كلمة الموجودة بالقوة: هو استعداد الكائن لهذه الكمالات دون الوجود الفعلي. وحركة الكائن هي التحول التدريجي من القوة إلى الفعل، بمعنى أن الكفاءات والإمكانات المخبوءة بالقوة والاستعداد في الكائن تتحول بالتدريج من القوة إلى الفعل، وتبرز وتظهر بصورة تدريجية حتى يكتمل نضجه ويأخذ حظه الذي آتاه الله تعالى من الكمال.
إنّ نواة التمرة ـ مثلا ـ تنطوي على استعداد كامن لتكون نخلة فارعة مثمرة، وهذا الاستعداد يبرز ويظهر للوجود ويتحول إلى حقيقة فعليّة بالتدريج ضمن حركة تكاملية طويلة وشاقة لهذه النواة.
وان الخلية التناسلية الواحدة (التي تتركب من نواة الحيوان المنوي للرجل ونواة البويضة للأنثى) تستبطن بالقوة والاستعداد كل المواهب والكفاءات والقدرات والخصائص التي يحملها الفرد، هذه الكفاءات والخصائص والقدرات موجودة فيها وقائمة بها ولكن بالقوة وتظهر بالتدريج وتتحول من القوة إلى الفعل في الكون.
حركة الإنسان التكاملية الإرادية:
وهذه الحركة التكاملية عامة وشاملة، والإنسان ـ كأي كائن آخر ـ يخضع لهذه الحركة التكاملية الجوهرية، والى جنب هذه الحركة حركتان اُخريان إراديتان للإنسان; إحداهما: باتجاه الكمال والعروج إلى الله تعالى، والاُخرى: باتجاه الخسران والسقوط.
أمّا الحركة التكاملية الصاعدة، فهي التي تُؤهِّل الإنسان لخلافة الله تعالى على وجه الأرض: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}[12]، وتمكنه من حمل الأمانة الإلهية; قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}[13].
والعاملان الأساسيان في هذه الحركة: الإرادة والوعي، وهذا العاملان هما اللذان يؤهّلان الإنسان لهذه الحركة التي يتميز بها دون كثير من خلق الله.
وهذه الحركة كالحركة الأُولى تماماً يتحول فيها الإنسان بصورة مستمرة وتدريجية من القوة إلى الفعل، وتبرز وتظهر خلال هذه الحركة المواهب والإمكانات التي أودعها الله تعالى في الإنسان، واحدة بعد أخرى.
فقد أودع الله تعالى في الإنسان كنوزاً من المواهب والكفاءات والطاقات والقيم والوعي والخصال الفاضلة: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}[14] و{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[15].
وهذه الكنوز من المواهب والقيم لا تبرز مرة واحدة، وإنما تظهر ضمن حركة تدريجية تتحول فيها هذه الكفاءات والمواهب من القوة إلى الفعل، ولا تختلف هذه الحركة التكاملية عن تلك في شيء إلاّ في أن هذه الحركة تتم بإِرادة الإنسان ووعيه وتلك الحركة تتم من دون إرادة ووعي، وهذه الحركة تتم في مساحة القيم الأخلاقية والوعي والإيمان والإخلاص وتلك الحركة تتم في مساحة النمو الفسلجي والحياتي للإنسان.
ويتم هذا التكامل عبر طريق طويل شاق وعسير، وعبر كفاح طويل للأهواء والغرائز الكامنة في النفس، وسوف نتحدث إن شاء الله عن ميكانيكية هذه الحركة.
السقوط الإرادي للإنسان:
والحركة الأخرى بإِتجاه السقوط. وهذه الحركة كسابقتها بإرادة الإنسان غير أنّها تكون باتجاه السقوط والخسران; يقول تعالى: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ}[16].
وهذا الخسر الذي تشير إليه سورة العصر هو إِنتكاسة الإنسان وسقوطه إلى أسفل سافلين.
قال تعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}[17].
وهذه الحركة الإرادية تتم باختيار الإنسان وإرادته كما ذكرنا، غير أنّها باتجاه الاستجابة للغرائز، والسقوط إلى أسفل سافلين، والعامل الأساسي في هذه الحركة: الهوى.
ميكانيكية الحركة التكاملية في الإنسان:
مهمة هذه الحركة تحقيق القيم التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان، كالإيمان، واليقين، والإخلاص، والخشوع، والشكر، والرفق، والرحمة، والعدل، والجود، والشجاعة، والعفّة، والغيرة و… وهذه القيم لها جذور في عمق النفس، تبرز، وتظهر، وتقوى، وتتعمق ضمن الحركة التكاملية للإنسان بصورة تدريجية.
وتمر هذه الحركة في كل قيمة من هذه القيم عبر نقطة سلبية، وما لم يتجاوز الإنسان تلك النقطة السلبية لا يمكن أن يكتسب ويحقق تلك القيمة.
وحركة الإنسان وكماله ونموه ونضجه هي معاناته في تجاوز هذه النقاط السلبية الكامنة في نفسه، وما لم يتجاوز الإنسان هذه النقاط السلبية لا يستطيع أن يحقق النقاط الايجابية في حياته.
دراسة تحليلية لآية من سورة التغابن:
لنضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم; قال تعالى: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[18]، هذه الآية الكريمة تتضمن ثلاث نقاط:
الأُولى: أنّ الشح مغروس في النفس، والنفس البشرية تنطوي على هذه الحالة ونقيضها بشكل متكافئ; قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}[19].
فالفجور والتقوى كلاهما مغروسان في النفس البشرية، حاصلان فيها.
الثانية: أنّ حالة الشح حالة كامنة في نفس الإنسان بالقوة، بمعنى الاستعداد للشح، كما أودع الله تعالى في نفس الإنسان استعداداً للعطاء، وآية سورة التغابن واضحة في هذا المعنى إذ قال تعالى: {وَمَن يُوقَ} والوقاية من المرض تختلف عن علاجه ومكافحته; فإن العلاج والمكافحة لمواجهة حالة مرضية قائمة، وأمّا الوقاية فللمنع، والحيلولة دون حصولها.
إذن فالتكليف بالوقاية يتضمن معنىً نفسياً دقيقاً، وهو أنّ حالاتِ الشح والفجور كامنة في نفس الإنسان بالقوة، وليست حاصلة بالفعل، فإذا أخذ الإنسان بأسباب الوقاية منها قضى عليها وإذا لم يأخذ بأسباب الوقاية تبدأ هذه الحالات بالظهور والنمو.
الثالثة: أنّ الإنسان لا يستطيع أن يحقق ويفعّل في نفسه القيم والمواهب والفضائل التي أودعها الله تعالى في نفسه، إلاّ عبر تجاوز هذه النقاط السلبية، فلا يستطيع أن يفعّل حالة العطاء إلاّ إذا تغلّب على حالة الشح في نفسه ويقي نفسه منها; ولا يستطيع أن يفعّل حالة الكظم في نفسه إلاّ إذا تغلّب على حالة الغضب والانفعال; ولا يستطيع أن يفعّل في نفسه حالة الشجاعة إلاّ إذا تغلّب في نفسه على الخوف والجبن; وهكذا لا يتمكن الإنسان أن يفعّل في نفسه ما أودع الله تعالى فيه من القيم والمواهب إلاّ بالتغلّب على النقاط النقيضة لها والكامنة في نفسه، بالوقاية منها.
والآية المباركة من سورة التغابن واضحة في هذه النقطة ايضاً، فإن الله تعالى يقول: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
فالفلاح لا يتحقق في حياة الإنسان إلاّ عبر تجاوز (الشح) والوقاية منه.
العقبات:
العقبات
إنّ النقاط السلبية الكامنة في نفس الإنسان هي العقبات التي تحول بين الإنسان وبين العروج إلى الله. ولا يتم للإنسان إحراز هذه القيم والمواهب الإلهية وتفعيلها في نفسه من دون أن يقي الإنسان نفسه من هذه النقاط التي يعبّر عنها القرآن بـ(الفجور) ولا يستطيع أن ينال التقوى إلا إذا تجاوز الفجور والهوى فهي إذن عقبة: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ}[20].
ولكل قيمة وموهبة وفضيلة أودعها الله تعالى في النفس عقبة خاصة بها; وبناءً على ذلك فالعلم قيمة وعقبته الجهل، والرأفة والرحمة قيمة وفضيلة وعقبتها الغلظة، والرقة فضيلة وعقبتها القسوة، والكظم فضيلة وقيمة وعقبته الغضب والانفعال، والحلم فضيلة وعقبته الطيش، والحبّ قيمة وفضيلة وعقبته النفور والبغضاء، والعفو قيمة وفضيلة وعقبته حب الانتقام، والجود والعطاء قيمة وفضيلة وعقبته الشح والبخل، والتوحيد قيمة كبرى في حياة الإنسان وعقبته الشرك. واليقين قيمة وعقبته الشك، والتواضع قيمة وعقبته الكبرياء، والشجاعة قيمة وعقبتها الخوف والجبن، والإِيثار قيمة وعقبته الإِثرة وحبّ الذات، وما لم يتجاوز الإنسان هذه العقبات لا يستطيع أن يفعّل ويحقق في نفسه تلك القيم والمواهب والفضائل.
الابتلاء:
والله تعالى يبتلي عباده بهذه العقبات، ومعاناة الإنسان الصعبة ليست في ممارسته هذه القيم وإِنما هي في تجاوز العقبات; فليست معاناة الإنسان في العطاء والجود بقدر ما هي في الوقاية من الشح والبخل، وليست معاناة الإنسان في العفو بقدر ما هي في الوقاية من حب الانتقام; فإذا تحرّر الإنسان من الشح وحب الانتقام والطيش والجهل والشك والغضب… فقد تمكن من العطاء والعفو والحلم والعلم والإيمان والكظم.
إنّ الإنسان بفطرته ينزع إلى العروج إلى الله، والى تحقيق القيم والمواهب والفضائل التي أودعها الله تعالى في نفسه، ولكن هذه العقبات تحجزه وتعيقه، كما يميل المنطاد إلى الصعود في الجو لو لا الحبال التي تشده إلى الأرض; فهذه العقبات حبال تشد الإنسان إلى الأسفل، وتعيقه عن العروج إلى الله تعالى، وما لم يتحرر منها لا يتمكّن من رحلة الإيمان والقيم.
وابتلاء الإنسان الصعب في هذه الحياة الدنيا في التحرر من العقبات، وعناء الإنسان وكدحه في هذه الرحلة ليس في الحركة إلى الله تعالى بقدر ما هو في التحرر من العقبات.
والقرآن يشير إلى هذا الكدح والعناء في حياة الإنسان إشارات واضحة قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ}[21]. وقال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ}[22]، والكبد: الجهد والعناء والكدح.
الوعي والإرادة:
وأداة الإنسان في التحرر من هذه العقبات هي (الوعي) و(الإرادة).
و(الوعي) هو البصيرة والمعرفة التي تمكّنه من تشخيص العقبات ودورها في سقوط الإنسان وهلاكه.
و(الإرادة) تمكنه من تجاوز هذه العقبات، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
وليس للحيوان معاناة كمعاناة الإنسان، وذلك لان الحيوان لا وعي ولا بصيرة، ولا إرادة له ليميز بين العقبة والغاية، ويميز بين السقوط والعروج، فهو يجري تبعاً للغريزة.
حالات العروج والسقوط:
وعروج الإنسان في الابتلاء بالعقبات والتحرر منها، وسقوطه في الاستسلام لها. والإنسان في هذا الابتلاء يصعد تارة، وينزل اُخرى، ويتحرّر مرة من عقبات الهوى فيعرج إلى الله، ويستسلم للعقبات مرة اُخرى فينزل باتجاه السقوط.
ولكن كلما ازداد حظّه في التحرر من هذه العقبات، وتكرر في حياته الانفلات من عقبات الهوى ازدادت سيطرته على أهوائه وشهواته، وتمكن منها; وانقادت له غرائزه وشهواته، وتوسعت دائرة (العصمة) و(الحصانة) في حياته وقلّت الذنوب، وازداد شوقاً وحباً إلى الله واُنساً به ونزوعاً للاستجابة لهتافه ودعوته تعالى.
وعلى العكس كلما تكررت في حياة الإنسان حالات الاستجابة لعقبات الهوى والنزول والإِسفاف ازدادت سيطرة الهوى والشهوات عليه، وتمكنت منه أهواؤه أكثر فأكثر، وضعفت في نفسه جاذبية الشوق إلى الله والاُنس به وذكره، وجاذبية القيم والمواهب المودعة في نفسه بالفطرة.
وبتعبير آخر: انّ الاستجابة المتكررة لعقبات الهوى، تُعَرِّضُ الإنسان للإسفاف، وتسلب حرّية الإنسان، وتجعله في قبضة الهوى وأسره. وعلى العكس كلما تكرر في حياة الإنسان الانفلات من قبضة الهوى تأكدت قدرة الإنسان على التحرر من أهوائه وشهواته وتأكّدت سيطرته على نفسه، وازداد ذكراً لله، وحباً له وشوقاً إليه.
وهذه معادلة ثابتة في نصوص الكتاب والسنّة، وفي ما نختبره ونعرفه من أنفسنا.
والتحرّر من الهوى في هذه المعادلة يساوي العبودية لله، والوقوع في أسر الهوى يساوي الخروج من دائرة عبودية الله والدخول في دائرة عبودية الشيطان.
الخسران والفلاح:
والحالة الأُولى خسران، لأَنَّ في كل استجابة للهوى خسراناً في حياة الإنسان، يخسر فيها الاستجابة لدعوة الله تعالى. فإذا تكررت منه الاستجابة للعقبات والأهواء خسر القيم التي تقابلها هذه العقبات نهائياً، وجفّ معين الفطرة في نفسه، وفقد المواهب والقيم التي أودعها الله تعالى في نفسه، وهذه الحالة هي حالة الانغلاق الكامل للقلوب، وحالة الختم: قال تعالى: {خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ}[23]، وفي هذه الحالة لا تستقبل القلوب من رحمة الله تعالى شيئاً، وتنغلق على كل خير ورحمة، انغلاقاً مطلقاً. ومن ثمّ لا تعطي ولا تنفق شيئاً; فإنَّ من لا يأخذ لا يعطي.
وعندئذ يخسر الإنسان كلّ ما أودع الله تعالى في نفسه من المواهب والقيم، ويخسر كلّ ما ينزل الله على قلوب عباده من النور والرحمة، وهذا هو الخسران الأكبر في حياة الإنسان.
وفي مقابل هذا الخسران (الفلاح) فإِذا تمكّن الإنسان من أَن يتجاوز عقبات الهوى وينتصر عليها فإنه سوف يفلح في تحقيق وتفعيل كل ما أودع الله تعالى في نفسه من كنوز الفطرة، ويفلح في الانفتاح على رحمة الله تعالى.
وإذا فتح الإنسان منافذ قلبه على رحمة الله تعالى استقبل من الرحمة الإلهية ما يتسع له قلبه. وهذه الحالة هي حالة الكمال والنضج والانفتاح في نفس الإنسان.
القرب إلى الله والبعد عنه:
وبين حالتي الصعود والسقوط تتفاوت درجات قرب العبد وبعده عن الله تعالى; فإن الإنسان إذا تمكن من تذليل عقبات الهوى في طريقه إلى الله، وتحرّر من سلطان الهوى تمكّن من تفعيل وتحقيق كنوز القيم في نفسه. وهذه القيم هي بعض صفات جمال الله تعالى.
فيحمل الإنسان عندئذ من صفات جمال الله ما يتسع له وعاء قلبه من الرحمة، والعلم، والكرم، والحلم، والعفو، إلاّ ما يختص الله تعالى به من صفات الجمال، فتكون صفات العبد من سنخ صفات الله مع فارق المحدود واللامحدود والممكن والواجب، فإن هذه الصفات في العبد محدودة وفي الله تعالى مطلقة لا حدّ لها، إلا أنّ هذه السنخية في الصفات كيفما تكون تقرب العبد إلى الله، وكلما تكون صفات العبد أشبه بصفات الله تعالى يكون العبد أقرب إلى الله تعالى.
وهذه من القضايا التي قياساتها معها، فالعالم أقرب إلى العالم من الجاهل، والحليم أقرب إلى الحليم من الطائش، والكريم اقرب إلى الكريم من البخيل، والشريف أقرب إلى الشريف من الساقط، والأمين أقرب إلى الأمين من الخائن.
وعليه فكلما كانت صفات الإنسان أشبه بصفات جمال الله تعالى وأقرب إلى صفات الله تعالى كان صاحبها اقرب إلى الله، وعلى العكس كلما يسقط الإنسان في الاستجابة للهوى كان أبعد عن الله تعالى، لأن السقوط في الأهواء يفقد الإنسان هذه القيم، وكلّما خسر الإنسان قيمة من هذه القيم ابتعد بمقدارها عن الله.
وإذا أكسب الهوى الإنسان أضداد هذه القيم كالجهل والشح والغلظة والقسوة والكذب والغضب والخيانة تحوّل إلى عدو لله تعالى، وكان أبعد شيء عن الله تعالى.
وهذه القضية كسابقتها قياساتها معها; فالخائن بعيد عن الأمين، والكاذب بعيد عن الصادق، والجاهل بعيد عن العالم، والساقط بعيد عن الشريف.
الإقبال والإعراض:
والحالة الأُولى (القرب بالصفات) تجذب الإنسان إلى الله تعالى جذباً قوياً، وكلّما تكون صفات الإنسان أشبه بصفات الله وجماله يخضع قلب الإنسان للجاذبية الإلهية أقوى وأكثر.
وتتبلور هذه الجاذبية في نفس العبد بصورة الحب الإلهي والشوق إلى الله والاُنس بالله، وذكر الله والإقبال عليه.
وعلى العكس كلّما يكون العبد أبعد شبهاً عن الله في الصفات يكون ابعد عن قبول الجاذبية الإلهية; فلا يجذبه جمال الله تعالى وجلاله، ولا يدخل في قلبه حب الله تعالى والشوق إليه والأُنس به وذكره إلاّ بمقدار ما يحمل من صفات الله، فإذا أكسبه الهوى أخلاق أعداء الله وجد الإنسان في نفسه إعراضاً وصدوداً عن الله.
والإعراض والصدود عن الله لهما علاقة مباشرة بما يكتسبه الإنسان من أخلاق أعداء الله. ورد في بعض الروايات أن أهل الجحيم تمر عليهم فترة يخفّ عنهم العذاب فجأة، فيسألون خزنة جهنّم عن سرّ تخفيف العذاب عنهم، فيقال لهم لقد مرّ اليوم على مقربة من هذا المكان أحد الأنبياء، فخفّف الله عنهم العذاب، فيسأل الكفّار خزنة جهنم أن يبعدوا عنهم النبي، ولا يقرّبونه منهم، فإن عذاب جهنم أهون عليهم من قرب الأنبياء.
وحالتا البعد والإعراض عن الله تحجبان الإنسان عن الله، فلا يدخل في قلبه إذا حجبته الأهواء نور أو هدى أو رحمة من الله، كذلك حالتا القرب والإقبال تكسبان الإنسان انفتاحاً على الله وتفتحان قلب الإنسان على رحمته ونوره، وإذا وفق الله عبداً وفتح قلبه على رحمته، فقد آتاه الحكمة والهدى والبصيرة واليقين بدون حساب.
أقرأ ايضاً:
الهوامش والمصادر
- [1] ـ الحديد: 4.
- [2] ـ ق: 16.
- [3] ـ الأنفال: 24.
- [4] ـ الذاريات: 56.
- [5] ـ لقمان: 13.
- [6] ـ البقرة: 152.
- [7] ـ المائدة: 175.
- [8] ـ البقرة: 199.
- [9] ـ البقرة: 150.
- [10] ـ الأحزاب: 1.
- [11] ـ فاطر: 28.
- [12] ـ البقرة: 30.
- [13] ـ الأحزاب: 72.
- [14] ـ الإسراء: 70.
- [15] ـ المؤمنون: 14.
- [16] ـ العصر: 1ـ2.
- [17] ـ التين: 1ـ 6.
- [18] ـ التغابن: 16.
- [19] ـ الشمس: 7 ـ 8.
- [20] ـ البلد: 12.
- [21] ـ الانشقاق: 6.
- [22] ـ البلد: 4.
- [23] ـ البقرة: 7.