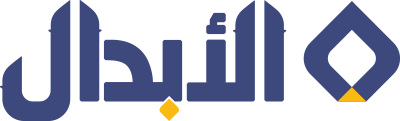مع العبد الصالح ذي النون (ع) في رحلة العودة إلى الله – سبحانك

- صفات الجمال وصفات الجلال
- التسبيح لله
- الإعتراض المكتوم في العلاقة بالله
- القضية الأولى:
- القضية الثانية:
- التخفُّف من المسؤولية يتضمَّن اعتراضاً مكتوماً
- العلاقة بالله في منهج التربية الإسلامية
- تعميق الشّعور بالإثم والظلم في منهج التربية الإسلامية
- المراحل الأربعة في آية ذي النون
- الإعتراض والإعتراف
- الهوامش والمصادر
وهذا هو الشوط الثاني من رحلة العودة إلى الله في آية (ذا النون)
صفات الجمال وصفات الجلال
لله تعالى نحوان من الصّفات هما: صفات الجمال وصفات الجلال:
وصفات الجمال هي «صفات الله الحسنى الثبوتية» «الايجابية» كالعلم، والسّلطان، والحلم، والعفو، والجود، والحكمة; وصفات الجلال هي صفات الله الحسنى الّتي تنفي عن الله النقص، والعجز، والجهل، والشّح، والقصور، والفقر، والحاجة، والضّعف.
ولله تعالى الجمال المطلق والجلال المطلق. والإطلاق هنا في كل من الجلال والجمال بمعناه الحقيقي. فهو سبحانه وتعالى، جميل ولا ينقصه من الجمال شيء واجد لكل كمال وجمال، وهو سبحانه جليل، ولا ينقصه من الجلال شيء، ليس في ذاته نقص أو قصور، أو ضعف أو عجز أو فقر، وجهل. وصفات الجلال هي نفي القصور والعجز والجهل والفقر… عن ذات الله تعالى.
التسبيح لله
التسبيح هو تنزيه الله تعالى من كل نقص وعجز وجهل.
وتنزيه الله تعالى عن كل ما يتصوره الإنسان من عجز وفقر. فإن الذات الإلهية واجبة في مقابل «الإمكان»، وغنية في مقابل «الفقر»، ومطلقة في مقابل «المحدود»… بالضرورة.
وكل صفة تنافي هذا الوجوب والإطلاق والغنى منفيَّة عن الذات الإلهية بالضرورة. فهو سبحانه منزَّه عن كل نقص، وقصور، وعجز، وجهل، وفقر، وظلم بالضرورة.
والتسبيح على نحوين، أولهما تسبيح وتنزيه في العقيدة، بمعنى الإعتقاد بتنزيه الله تعالى عن القصور والعجز، وثانيهما تسبيح في مجال السلوك والعلاقة بالله. بمعنى التعامل معه تعالى من منطلق الإيمان: بأن كل ما يفعله الإنسان من خير من الله، وكل ما يفعله من شر هو من نفسه. وكل جميل في علاقة الإنسان بالله هو من الله، وكل قبيح وسوء في هذه العلاقة هو من الإنسان.
في دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع): «أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك». وقبيح ما عندنا هو السّيئات. وجميل ما عند الله هو العفو والمغفرة. وجميل ما عند الله يذهب بقبيح ما عندنا.
وهذا نحو من «التسبيح» في «العلاقة بالله» في مقابل التسبيح في «العقيدة».
الإعتراض المكتوم في العلاقة بالله
الإعتراض المكتوم في العلاقة بالله
ولدى كثير من الناس نحو من الإعتراض المكتوم على الله. وهذا الإعتراض تارة في ما يصيب الإنسان من الإبتلاء بالنقص في الأنفس والأموال. وتارة في ما يرتكب الناس من الذنوب والمعاصي، فيعتقد الإنسان أن ما يصدر عنه من الذنوب والمعاصي لا يكون إلاّ بقضاء من الله وقدره.
وما كان بقضاء وقدر لا يكون تحت إختيار الإنسان وأمره، فلا يكون الإنسان مسؤولا عنه، فإن الإنسان لا يكون مسؤولا إلاّ عما يكون تحت اختياره وأمره، وما كان بقضاء من الله وقدره يدخل في دائرة الحتميات ويخرج عن دائرة إختيار الإنسان.
وهاتان قضيتان تؤديان مجتمعين إلى سلب مسؤولية الإنسان عما يصدر عنه من الأفعال.
القضية الأولى: إن كل شيء، في هذا الكون، يوجد بقضاء وقدر، وأفعال الإنسان لا تشذ عن هذه القاعدة الفلسفية العامة. فهي إذن تدخل في دائرة الحتميات الكونية.
والقضية الثانية: إن كل ما يتم بقضاء وقدر، فهو بالضرورة لا يكون تحت إختيار الإنسان وإرادته وسلطانه.
والنتيجة أن الإنسان لا يتحمل أيَّة مسؤولية تجاه أفعاله، وهذه القضيّة تستبطن اعتراضاً مكتوماً على الله تعالى فيما يصيب الإنسان من الشّر في الدنيا والآخرة.
وإذا أمعنّا النظر، نجد أن القضية الأولى منهما صحيحة والقضية الثانية باطلة. وبذلك فلا ننتهي إلى النتيجة المذكورة. وإليك تفصيل كل من هاتين القضيتين.
القضية الأولى:
القضية الأولى ومفادها أن كل ما يصدر عن الإنسان لابد من أن يتحقق بقضاء وقدر، وهذا أمر صحيح وقطعي، من دون ريب.
فإذا أحرق الإنسان مدينة أو دمرها في الحرب يتم ذلك بقضاء وقدر. وإذا أنشأ الإنسان مدينة أو عمَّرها فإن ذلك لا يكون إلاّ بقضاء وقدر. وإذا قتل انساناً كان قتله بقضاء وقدر، وإذا أحياه، أَحْياه بقضاء وقدر. فقانون العلِّيَّة يحكم هذا الكون، و لا يخرج عن حكم هذا القانون شيء في هذا الكون، فلا تتم الحروب، ولا يتم البناء، ولا يتم القتل، ولا يتم الإحياء إلاّ بقانون العليّة.
وقانون العليّة يضمن دائماً حتمية المعلول عند وجود علة، وإمتناع وجود المعلول من دون وجود علّته.
فالخراب، والعمران، والقتل، والإحياء، لا يمكن أن يتم أي منها من دون وجود علَّته. ويستحيل أن لا يتحقق مع وجود علَّته. فكل من هذه الأمور يجب بوجود علَّته، ولا يتحقق من دون وجود علَّته.
والمعلول يجب عند وجود علته وهذا هو القضاء، وهو بمعنى حتمية الوجود. وكما تقتضي العلَّة حتمية المعلول كذلك تقتضي «تقدير» المعلول.
إِنَّ إشعال عود الثقاب يقتضي حتمية الحرارة، كما أنّ الانفجار الذَرّي يقتضي الحرارة، ولكن الانفجار النووي يقتضي الحرارة بـ «قدر معيَّن» وعود الثقاب يقتضي الحرارة بـ «مقدار آخر».
واختلاف المقدارين باختلاف حجم العلتين بموجب قانون المسانخة بين العِلّة والمعلول.
إذِنْ العِلَّة كما تقتضي وجود المعلول بصورة حتمية، كذلك تقتضي أن يكون المعلول من سنخها من حيث الكم والكيف. فلا يجوز أن تكون ثمرة شجرة التُفّاح الحنطة، ولا يجوز أن تكون التفاحة ثمرة لسنابل القمح. ولا يجوز أن يكون الإنجماد نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة ولا يجوز أن يكون الإنصهار نتيجة لإنخفاض درجة الحرارة… بموجب قانون السّنخية بين العِلّة والمعلول.
وبموجب قانون السنخية تختلف درجة الحرارة الحاصلة من إشعال عود ثقاب عن الحرارة الحاصلة من الإنفجار النووي; لاختلاف العلة.
إذن يجب وجود المعلول عند وجود علته، وهذا هو «القضاء». ويجب أن يكون المعلول من سنخ علته، في الكم والكيف وهذا هو «القدر».
إن «حتمية» الحرارة بإشعال عود الثقاب «قضاء» و«درجة الحرارة» الّتي يبعثها عود الثقاب المشتعل «قدر».
والقضاء والقدر قانون عام في هذا الكون لا يشذ منه شيء، وكل شيء يجري في هذا الكون يجري بقضاء وقدر.
ولا يشذ عن ذلك ما يصدر عن الإنسان من عمل صالح أو قبيح فإنّ أفعال الإنسان كأي شيء في هذا الكون تتحقق وتجب بوجود علتها، ولا تتحقق من دون علتها. إذا وجدت العِلَّة وجد المعلول بالضرورة ومن سنخ العلة كمّاً وكيفاً. وهذه هي القضية الأولى الّتي قلنا عنها أنها قطعية لا شك فيها.
القضية الثانية:
أما القضية الثانية فأمرها مختلف عن القضية الأولى اختلافاً كبيراً فأن إرادة الإنسان واختياره جزء من العلة التامّة الّتي تستوجب وجود المعلول، فلا يتحقق المعلول من دون إرادة الإنسان، ويجب بوجود الإرادة، إلاّ أن هذه الحتمية في جانب المعلول لا تنافي أن يكون هذا الفعل واقعاً تحت اختيار الإنسان ومسؤوليته، لموضع الإرادة والإختيار في جانب العلة.
صحيح أن الفعل، بعد أن يختاره الإنسان ويقدم عليه يجب إلاّ أن إرادة الإنسان واختياره لما كانت جزءاً من العلة التامّة الّتي تستوجب المعلول، وكان أمر الإرادة والإختيار بيد الإنسان، فلا محالة يكون الإنسان مختاراً في إيجاد الفعل وعدمه قبل العمل، ويكون الفعل تحت سلطان إرادته، ويكون الإنسان في النتيجة مسؤولا عن فعله.
لأنّ الإرادة جزء من العلة: وأمر الإرادة بيد الإنسان، وإذا كانت العلة تحت سلطان الإنسان كان المعلول كذلك بالضرورة.
وقد ورد في «دعاء كميل» في توجيه هذا الإعتراض الَّذي يساور النفس البشرية:
«إلهي ومولاي اجريتَ عليّ حكماً اتبعتُ فيه هوى نفسي، ولم أحترسْ فيهِ من تزيين عدوي، فغرَّني بما أهوى، وأسعدهُ على ذلك القضاءُ، فتجاوزتُ بما جرى عليَّ في ذلكَ بعضَ حدودكَ، وخالفتُ بعض أوامركَ. فلكَ الحمدُ عليَّ في جميع ذلك، ولا حُجةَ لي فيما جَرى عليَّ فيهِ قضاؤك، والزَمَني حُكمك وبلاؤكَ».
وذلك لأن هذا الَّذي جرى فيه القضاء على الإنسان من السّيئات والذنوب،وألزمه الله تعالى بحكمه وبلائه جرى بإرادة الإنسان واختياره ولا حجة للإنسان على الله فيما جرى فيه القضاء الإلهي، بناءً على ذلك.
فلم يَرَ الإنسان ولا يرى من الله غير الجميل «فلك الحمد عليّ في جميع ذلك».
ولن يكون، ولا يكون، للعبد حجَّة على الله في ما جرى عليه من قضاء الله وحكمه وبلائه: «ولا حجة لي فيما جرى عليَّ فيه قضاؤك».
يقول تعالى: {فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}[1].
ويقول تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ}[2].
التخفُّف من المسؤولية يتضمَّن اعتراضاً مكتوماً
…ولكن الإنسان يحاول أن يتخفف من المسؤولية في ما يرتكب من الذنوب والمعاصي، ويجعل من ابتلاء الله تعالى لعباده سبباً للتنصل من المسؤولية.
وهذا الإتجاه، من الرأي، يتضمن اعتراضاً مكتوماً على الله; حيث يرى الإنسان أن ابتلاءه بالذنوب والمعاصي أمر من ناحية الله تعالى
وهذا الإعتراض المكتوم موجود بشكل أو بآخر عند كثير من الناس، ويتفاعل هذا الإعتراض في نفس الإنسان حتى يتشبّع ذهنه بالإعتراض على الله تعالى من حيث يريد أو لا يريد.
ومن هذا المدخل يدخل الإنسان في علاقة سلبية مع الله تعالى، ويدخل الشّيطان في علاقة العبد بالله تعالى.
وأخطر ما يكون أمر الشّيطان وتدخّله في حياة الإنسان أن يدخل دائرة علاقته بالله تعالى فيفسد هذه العلاقة، ويسمها بالسلبية وعدم الرضا والإعتراض، ويجعل أساسها الإعتراض والشكّ و الريب.
إنّ الشّيطان قد يدخل في علاقة الإنسان بنفسه فيفسدها، وقد يدخل في علاقة الإنسان بإخوانه وأهله فيفسدها، وقد يدخل في علاقة الإنسان بنعم الله تعالى فيفسدها، وقد يدخل قلب الإنسان فيفسده، وقد يدخل عقل الإنسان فيفسده، إلاّ أن أخطر ما يكون فيه أمر الشّيطان تدخّله في علاقة الإنسان بالله، فإن قيمة الإنسان تتمثل في علاقته بالله تعالى فإذا أفسد الشّيطان عليه هذه العلاقة لا ينفعه بعد ذلك شيء.
و«الإعتراض» على الله أحسن المداخل الّتي يفضلها الشّيطان للنفوذ إلى علاقة الإنسان بربه.
العلاقة بالله في منهج التربية الإسلامية
العلاقة بالله في منهج التربية الإسلامية
وفي منهج التربية الإسلامية يتجرَّد «العبد» في «علاقته» بـ «الله» من كل إحساس وشعور بالإعتراض على الله، من الإعتراض المكتوم والسّافر.
وتقوم العلاقة على أساس الإعتراف لله تعالى بالذنب والظلم والتقصير، واتهام النفس، والإيمان بأن لله الحجة البالغة في كل سوء أو ظلم أو ذنب صدر من العبد.
{قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}[3].
{لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ}[4].
إن العلاقة المتبادلة بين الله تعالى وعبده نازلة وصاعدة: نازلة من الله على عبده، وصاعدة من العبد إلى الله.
فكلُّ ما يكون في حياة الإنسان من خير ورحمة وهدى ونور، ينزل من لدن الله تعالى على عبده في هذه العلاقة، وكلّ ما يكون في حياة الإنسان، من سوء وشر وظلم وإثم، يصعد من العبد إلى الله. ورحم الله العبد العارف الَّذي كان يقول: «أللّهم إني أستغفرك من كل ما يصعد مني إليك وأحمدك على كل ما يتنزّل منك إليّ».
تعميق الشّعور بالإثم والظلم في منهج التربية الإسلامية
والإعتراض على الله و«التنصل» من مسؤولية الإنسان عما يصدر عنه من الظّلم والإثم… يخدع الإنسان عن نفسه، ويحجبه عن ذنوبه وسيئاته، ويسلب عنه الشّعور بالظلم والإثم، وبالتالي يسلب عنه حالة الإعتراف بالذنب بين يدي الله وحالة الإستغفار، فإن الإعتراض على الله حجاب يحجب الإنسان عن «الإعتراف» و«الإستغفار»، وبالتالي يحجبه عن رحمة الله تعالى ومغفرته.
ومن بؤس الإنسان وشقائه أن يَحْرِمَ نفسه من أن يتعرض لرحمة الله تعالى ومغفرته من باب من أوسع أبواب الرحمة والمغفرة الإلهية.
وبعكس ذلك، الشّعور بالظلم والذنب يعدّ العبد للإستغفار، ويضع الإنسان في واحد من أفضل مواضع رحمة الله.
فإن الإحساس بالذنب أساس الإعتراف بين يدي الله تعالى بالظلم والتقصير، والإعتراف بين يدي الله بالظلم أساس الإستغفار، والإستغفار من منازل رحمة الله وأبواب مغفرته وفضله.
فلابد للإنسان أن يشعر بمسؤوليته في الذنوب والمعاصي، حتى يعترف لله ـ صادقاً ـ بالظلم، ويقف بين يدي الله تعالى بـ «ذل المعصية»، ولابد من أن يعترف لله بذنوبه ومعاصيه وظلمه وإثمه، ويرفع إلى الله ذلّه وصغاره حتّى يتمكن من أن يستغفر الله تعالى صادقاً.
والإستغفار، كما قلنا، من أبواب رحمة الله، ومنازل مغفرته وفضله، وما لم يستغفر الإنسان ربه، صادقاً، فلن يفتح له هذا الباب.
فليس الإستغفار من «مقولة الكلام»، وإن كان الكلام يعبر عنه، وإنما هو من مقولة «الأحوال النفسية».
وما لم تتحقق حالة الإستغفار لدى الإنسان لن يفتح عليه هذا الباب، ولن تنزل عليه الرحمة والمغفرة الإلهية الّتي تنزل على الذين يضعون أنفسهم في منازل رحمة الله.
فهذه مجموعة معادلات قطعية لا يمكن الفصل بين بعضها وبعض.
المراحل الأربعة في آية ذي النون
والتسبيح، في كلام العبد الصّالح ذي النون، في بطن الحوت، يتضمن معنى نفي الإعتراض على الله. فهو (ع) في بطن الحوت ينفي عن الله تعالى كل ظلم، وينزّهه.
وهذا التسبيح يتضمن نفي الإعتراض عن الله، وتنزيهه تعالى من أن يلحقه إعتراض، وهذه هي الفقرة الأولى من كلمة العبد الصّالح ذي النون {سُبْحَانَكَ}.
وبعدها تأتي مباشرة فقرة (الإعتراف) بالذنب والظّلم: {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}. ويأتي الإعتراف والإقرار بالظلم بين يدي الله تعالى نتيجة لنفي الإعتراض على الله، وهذه هي الفقرة الثانية من كلام ذي النون في بطن الحوت {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}.
والفقرة الثالثة، من الآية الكريمة بعد الفقرتين السّابقتين، هي {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ}، وتأتي نتيجة للفقرتين السّابقتين، فإن الإعتراف بالظلم في كلام العبد الصّالح «استغفار»، والإستغفار من منازل رحمة الله تعالى كما ذكرنا.
ولما وضع العبد الصّالح ذو النون نفسه في موضع الإعتراف والإستغفار نزلت عليه الرحمة والمغفرة من لدن الله تعالى مباشرة {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ}. وهذه هي الفقرة الثالثة في الآية الكريمة.
والفقرة الرابعة هي فقرة «التعميم»، {وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ}.
فإن الَّذي حدث لذي النون (ع) في بطن الحوت سنّةَ وقانون، وسنن الله تعالى لن تخص عبداً دون عبد، وكل من تعرَّض لما تعرَّض له ذو النون (ع) من الإعتراف بالظلم والإستغفار ينزل عليه من الرحمة والمغفرة ما نزل على هذا العبد الصّالح في بطن الحوت.
الإعتراض والإعتراف
الإعتراض والإعتراف
«الإعتراض» و«الإعتراف» مقولتان متقابلتان، ولهما أثران متعاكسان على الإنسان، فالإعتراض يحجب الإنسان عن رحمة الله، والإعتراف يضع الإنسان في منازل هذه الرَّحمة.
والعلاقة بين «الإعتراض» والحجب عن الرحمة، وكذلك العلاقة بين «الإعتراف» والنزول في منازل الرحمة… علاقة تكوينية بموجب سنن الله تعالى، فان رحمة الله تنزل على موضع «الفقر» و«الحاجة»، والإعتراف إعلان للفقر والحاجة.
وإذا وضع الإنسان نفسه في موضع الفقر إلى الله والحاجة إلى مغفرة الله تعالى استنزل رحمة الله عزّوجلّ.
و«الإعتراض» استكبار، وغرور، وتنصّل عن المسؤولية وعجب، ولا ينزل شيء من رحمة الله على مواضع الغرور والعجب والإستكبار، كما تنحدر مياه الأمطار إلى المواضع الواطئة من الأرض، ولا تستقر على القمم المرتفعة الناتئة من الأرض، فإذا أراد الإنسان أن يستنزل رحمة الله كان عليه أن يضع نفسه في المواضع التي تستنزل رحمة الله، لا موضع الاستكبار والغرور والعجب.
ورحمة الله وعفوه ومغفرته لا تنزل على الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تحجب صاحبها عن رحمة الله، ولا تضعه في مواضع نزول الرحمة، وإنما تنزل الرحمة على حالة الإحساس بالذنب، والإعتراف بالظلم «وليس على الذنب والظّلم»، فقد يذنب الإنسان ويظلم نفسه، فيستخف بذنبه، ويتنصل عن مسؤوليته، ويستهين به، فلا يزيده ذنبه إلاّ بُعداً عن رحمة الله تعالى.
وقد يذنب فيسوؤه ذلك ويشعره بالحياء والخجل بين يدي الله، ويعمِّق في نفسه الإعتراف بالظلم، فيلوذ بالله ويستغفره، ويتضرع إليه فيستنزل رحمته، فتنزل عليه رحمته ومغفرته وفضله، كما نزلت على العبد الصّالح ذي النون (ع)، الذي قال: {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}.
أقرأ ايضاً:
- أدب العودة إلى الله – الندم
- ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻮﻥ (ع) في رحلة العودة إلى الله – إِني كنت من الظالمين