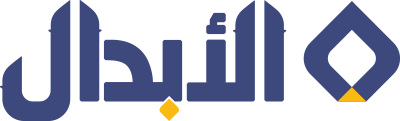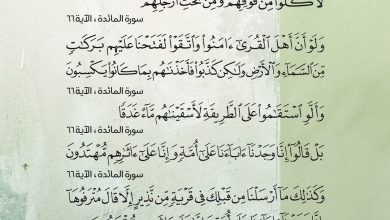الرعاية الإلهية

- رعاية الله في حياة الإنسان الشخصية
- سـتر الله
- التوفيق الإلهي
- النتائج التربوية للإحساس بالتوفيق الإلهي
- مقارنة بين ما يطمح إليه الإنسان وبين توفيق الله للإنسان
- التوفيقات الربانية في حياة الدعاة
- لمسات التوفيق الإلهي للدعاة من القرآن
- الذين يلمسون يد الله فيما ينالهم من التوفيق
- التوفيق باب من أبواب التوحيد
- سنن الله في التوفيق
- اقرأ أيضاً:
- المصادر والمراجع
وهو العامل الثالث لحركة التاريخ، ولا تحسبنّ عجلة التاريخ قادرة على الاستمرار في العمل لولا الرعاية الإلهية. ولا يمكن أن يستقر التاريخ على أساس (الحتمية العلية) و(العنصر الإنساني) فقط… وما أكثر ما أشرفت الحضارة الإنسانية على السقوط والإنهيار الكامل لولا أنْ تتداركها (الرعاية الإلهية) في الوقت المناسب.
والرعاية الإلهية هنا شيء آخر غير السُّنن الإلهية في التاريخ… إنها شيء ما فوق هذه السنن الحتمية، ولها أيضاً أصول وقوانين، ولا تحصل إعتباطاً، إلا أنها من دائرة أُخرى غير دائرة السنن المعروفة.
ولولا أنّ هذه الرعاية الإلهية تواكب حركة التاريخ لسقطت الحضارة البشرية منذ عهد طويل… ونحن عندما نتابع حركة التاريخ نشهد يد الله ـ تعالى ـ ورعايته للإنسان تواكب هذه المسيرة التاريخية، ولم تتخلّ عن رعاية الإنسان والمحافظة عليه وحمايته من السقوط طرفة عين… وكم من مرة شهد التاريخ سقوطاً حتمياً لحضارة الإنسان على يد طغاة مجرمين من أمثال جنكيز وهولاكو وهتلر ـ على صعيد واسع جداً ـ لولا أن تدرك الرعاية الإلهية الإنسانية في الوقت المناسب، وتنقذه من السقوط الحتمي، وكم من مرة يجرف الهوى، والفساد، والفوضى، البشرية إلى حضيض السقوط، لولا أن تدرك الرعاية الإلهية الإنسانية في اللحظة الأخيرة، وتنقذها من السقوط والهلاك، من دون أن تكون السنن الحتمية للتاريخ ووعي الإنسان وإرادته وحريّة قراره كافية لخلاص الإنسان وإنقاذه.
إن الحقيقة التي تكمن وراء ذلك كله أن حضارة الإنسان لا يمكن أن تقوم على دعامتين فقط: (إرادة الإنسان وسنن الله في التاريخ)، ومن دون وجود هذه الدعامة الثالثة (الرعاية الإلهية) تبقى الحضارة الإنسانية متأرجحة وقلقة ومعرضة للسقوط والانهيار.
ولو لم تكن لدينا شواهد وأمثلة ونماذج من خلال إستعراض التاريخ الإنساني للرعاية الإلهية لكنا نحكم بحتمية وجود هذه الدعامة الثالثة للحضارة والمجتمع، نظراً لاستمرار الحضارة البشرية وخروجها من المآزق والمهالك الكثيرة التي تعرضت لها هذه الحضارة في تاريخها الطويل… ولا نحتاج إلى دليل أكثر من ذلك لاكتشاف هذا العنصر الثالث في تقويم الحضارة والتاريخ.
ومن عجب أن هذا العنصر الثالث البالغ الأهمية يختفي بشكل عجيب في الدراسات العلمية التي تتناول تفسير التاريخ والحضارة الإنسانية، ويغيب عن عيون الكثيرين من الباحثين والعلماء، في هذا الحقل الحساس من حقول الدراسات الإنسانية.
ولا يحتاج الإنسان إلى كثير من العناء ليكتشف هذا الأصل الكبير والعامل الأساس في تقويم الحضارة والتاريخ. وبقليل من التأمل والبصيرة يستطيع الإنسان أن يلمس هذا الأصل في التاريخ والحضارة بشكل واضح.
رعاية الله في حياة الإنسان الشخصية
ولنبدأ في إلتماس هذه الرعاية الإلهية في حياة الناس الشخصية، حيث يعلم كل واحد منا تدخّل الرعاية الإلهية في حياته الشخصية، خارج دائرة الحتميات العلية وإرادته وعقله وتجاربه، ويلمس عن قرب أنه لولا أن تتدخل الرعاية الإلهية في حياته الشخصية لما نهض به عقله وإرادته وتجاربه وقوانين الطبيعة والمجتمع، ولو أن الله تعالى يوكل الإنسان إلى نفسه لسقط في لحظة واحدة أمام أول مزلق من مزالق الحياة الكثيرة… ولكن رعاية الله تتابع الإنسان في حياته خطوة فخطوة، وتحفه بالحفظ، والتوفيق، والتسديد، والتأييد، بصورة غيبية، منها ما يشعر بها بصورة محسوسة وملموسة، ومنها ما لا يشعر بها بصورة محسوسة، وهي الألطاف الخفية لله تعالى التي ترعى الإنسان من دون أن يحس بها، وهي كثيرة ومتنوعة، إذا كانت تخفى واحدة واحدة، فلا تخفى على الإنسان في إجمالها وكليتها.
وهذه الرعاية الإلهية تواكب الإنسان في مسيرة حياته عند كل مزلق من مزالق الحياة، وعلى كل شفير يشرف الإنسان عنده على السقوط وكلما تتشابك أمامه الطرق ويلتبس عليه الحق والباطل… ولو أن الله ـ تعالى ـ وكل الإنسان إلى نفسه وعقله وإرادته وتجاربه لما نهض به عقله وتجاربه بالتأكيد.
ولذلك ورد في الأدعية كثيراً هذه الفقرة:
«ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».
وورد في الصحيفة السجادية:
«ولو تكلني إلى حولي… لكان الحول عني معتزلا».
إن حول الإنسان وطوله وعقله وإرادته ـ وكل ذلك مما آتاه الله تعالى، ـ وكل قوانين الطبيعة والمجتمع ـ، وكله من خلق الله ـ لا ينهض بالإنسان إذا تخلت عنه رعاية الله الخاصة، وأوكلته إلى نفسه.
سـتر الله
وليس ذلك فقط على الصعيد المعنوي… بل يصح أيضاً على الصعيد المادي والمحسوس، فما أكثر ما يتعرض الإنسان لأخطار مادية في جسمه فتدركه رعاية الله تعالى وتنقذه، وما أكثر ما يدرأ الله تعالى عن الإنسان الأخطار الحقيقية من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر… يقول بعضهم إن الإنسان في كل دقيقة يواجه احتمال الموت والهلاك مرات عديدة.
وهذه الشواهد الملموسة كلها تدعونا إلى الإيمان بوجود عنصر ثالث في حياة الإنسان غير القوانين الطبيعية، والاجتماعية، والعقل، والإرادة، والتجربة، وهذا العنصر الثالث هو رعاية الله تعالى الخاصة بعباده.
التوفيق الإلهي
وقد ورد التعبير عن هذا العنصر الثالث في النصوص الإسلامية بـ (التوفيق)، كما يقول أميرالمؤمنين “ع”:
<التوفيق عناية>، و<التوفيق عناية الرحمن>[1].
والتوفيق لا يأتي بمعنى تعطيل دور قانون العلية في الحياة في الطبيعة والمجتمع، ولا استحداث قوانين جديدة في الطبيعة والمجتمع لخدمة الإنسان، وإنما يأتي بمعنى: (توجيه الأسباب للإنسان نحو الخير)[2]؛ فإن قوانين الطبيعة والمجتمع تبقى فاعلة وحتمية، ومنها ما يقود الإنسان نحو الخير، ومنها ما يقود الإنسان نحو الشر، وعلى الإنسان أن يختار منها هذا أو ذاك. وعليه يتقرر مصيره في السعادة والشقاء كما ذكرنا. ولكن ليس دائماً تتهيأ للإنسان الفرصة الكاملة لأسباب الخير في الطبيعة والمجتمع. فقد لا تكون هذه الأسباب في متناوله وفي مقدوره. وقد تغيب عنه، ولا يهتدي إليها… وفي مثل هذه الحالات فإن الله ـ عزّوجلّ ـ يأخذ بيد عبده إلى هذه الأسباب التي تقوده إلى السعادة والخير.
ورد عن أبي عبد الله الصادق “ع”: <إذا أراد الله بعبد خيراً أخذ بعنقه، فأدخله في هذا الأمر (الولاء والهداية) إدخالا>[3].
وعنه “ع” أيضاً: «إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً وكل به ملكاً فأخذ بعضده فأدخله في هذا الأمر»[4].
وتعبيرات الإمام أميرالمؤمنين “ع” عن التوفيق ـ كما في غرر الحكم للآمدي ـ دقيقة ومعبرة عن هذه الحقيقة ومنها:
«التوفيق قائد الصلاح»،
و«التوفيق رأس النجاح>،
و«التوفيق رأس السعادة»،
و«بالتوفيق تكون السعادة»،
و«لا قائد كالتوفيق»، والسبب في ذلك كله واضح فان التوفيق الإلهي يقود الإنسان إلى أسباب الصلاح والنجاح والسعادة.
وما لم يوفق الله تعالى عبداً ويرد به خيراً فإنه لا ينال من أسباب الخير بجهده وعقله إلا القليل:
«لا ينفع إجتهاد بغير توفيق»، فإذا أراد الله تعالى به خيراً ووفقه وضع جهده في موضعه من أسباب النجاح والفلاح، فيكون جهده مثمراً.
يقول الإمام “ع”: «خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق».
وقد ورد في الحديث أن «التوفيق أشرف الحظين» ويقصد به حظ الإنسان من أسباب السعادة والخير التي ينالها بجهده وعقله وإمكاناته التي أعطاها الله تعالى إياه، وهو أحد الحظين وأقلهما شأناً، والحظ الآخر هو أن يهدي الله تعالى عبده لما يغيب عنه من أسباب الخير أو لما لا تناله يده من أسباب الخير، ويضعه في موضع أسباب السعادة والخير، وهذا هو الحظ الثاني وهو أشرفهما كما في الحديث.
ولا شك في أن (التوفيق) عامل غيبي من الخارج يضع الإنسان في مواضع الخير وأسبابه، وهو شيء آخر غير الإمكانات العقلية والفطرية والقوة التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان كما قلنا. فإن هذه الإمكانات التي أودعها الله تعالى في الإنسان لا تستطيع لوحدها أن تنهض بالإنسان، وتقوده إلى أسباب الخير وتجنّبه أسباب الشر، فإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً أعانه على صرف جهده وإمكاناته في مواضعها من أسباب الخير. وفي الحديث التالي إيضاح كاف لهذه الحقيقة:
«روي أن رجلا سأل الصادق “ع” فقال: يا ابن رسول الله؟ ألست أنا مستطيعاً لما كلِّفت؟
فقال له “ع”: ما الاستطاعة عندك؟ قال: القوة على العمل.
قال له “ع”: قد أعطيت القوة، إن أُعطيت (المعونة).
قال له الرجل: فما المعونة؟
قال: التوفيق. قال (الرجل): فلم إعطاء التوفيق؟
قال (الإمام): لو كنت موفقاً لكنت عاملا، وقد يكون الكافر أقوى منك ولا يعطى التوفيق، فلا يكون عاملا.
ثم قال “ع”: أخبرني عمن خلق فيك القوة؟
قال الرجل: الله تبارك وتعالى.
قال الصادق “ع”: هل تستطيع بتلك القوة دفع الضرر عن نفسك، وأخذ النفع إليها، بغير العون من الله تبارك وتعالى؟ قال: لا.
قال: فلم تنتحل ما لا تقدر عليه؟
ثم قال: أين أنت من قول العبد الصالح: {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ}>[5].
وهذه الرواية تصنّف القوى العاملة والمؤثرة في حياة الإنسان إلى ثلاثة:
1ـ القوانين الطبيعية والاجتماعية (سنن الله) التي تقود الإنسان إلى الخير أو إلى الشر.
2ـ القوى التي أودعها الله تعالى في الإنسان، والتي يستعملها الإنسان للوصول إلى هذه أو تلك من أسباب الخير أو الشر في الطبيعة والمجتمع.
3ـ التوفيق والعون الإلهي الذي يهدي به الله تعالى عباده إلى أسباب الخير، ويعينهم عليها، ويأخذ بأيديهم إليها، لينالوا منها ما كان يغيب عنهم، أو ما كان تقصر أيديهم عنه. ومن دون هذا الأخير لا ينال شيئاً يذكر من الخير.
روى الكراجكي في الكنز قال: قال الصادق “ع”: <ما كل من نوى شيئاً قدر عليه، ولا كل من قدر على شيء وفق له، ولا كل من وفق لشيء أصاب له، فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة>[6].
النتائج التربوية للإحساس بالتوفيق الإلهي
وعندما يعي الإنسان أهمية عامل التوفيق الإلهي، في بناء حياته، وتقرير مصيره، وهدايته، وسداده، ونجاحه، وفلاحه، ويعي عجزه كإنسان من أن يحقق في حياته شيئاً من ذلك بقواه وإمكاناته الذاتية التي أودعها الله تعالى فيه… ينفعه هذا الإحساس من الناحية التربوية في أمرين أساسيين:
1ـ يكفكف في نفسه غلواء الغرور والزهو، عندما يفتح الله ـ تعالى ـ له أبواب الرحمة، فلا يناله الغرور، ولا يصدّه الزهو الباطل.
وقد روي عن الإمام الرضا “ع”: <أن أيوب “ع” قال: يارب ما سألتك شيئاً من الدنيا قط، وداخله شيء[7].
فأقبلت إليه سُحَابة حتى نادته: يا أيّوب من وفقك لذلك؟
قال: أنت يا رب>[8].
وما أجمل جواب العبد الصالح شعيب “ع” لقومه عندما أنكروا عليه دعوته وقالوا له: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}[9].
إنك لتقرأ هذا الحوار في القرآن فتشعر بظل الأنانية الثقيلة في كلام قوم شعيب: {مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} {نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء}، ثم الاستخفاف والاستهزاء {أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ} { إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}!!
ولنقرأ الآن جواب شعيب:
{قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ, وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}[10].
ونقرأ هذا الجواب، فلا تكاد تحس لهذا العبد الصالح بظل في هذا الحوار: {بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي}: {بَيِّنَةٍ } وليس تعصُباً لما يعبد الآباء. و{مِّن رَّبِّي}، وليس من صنعي، ولا مما انتهيت إليه بفكري وجهدي {وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا}: رزقني الله من لدنه، ومن عنده رزقاً حسناً مباركاً…
نقرأ هذا الكلام فلا نحسّ بشعيب، ولا بظل له. ثم نلتقي بشعيب فجأة يقول: {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ}… وهذه الإرادة منه، ولكنها من التوفيق والرزق الحسن الذي رزقه الله.
ولكن في إطار الإصلاح والهدى… ومع ذلك يسرع فيتدارك هذه (الأنا) مباشرة بـ (ما استطعت)، بحدود قدرته وإستطاعته وهي محدودة… ثمَّ كأنه لا يجد في هذا التحديد والتحجيم (للأنا) ما يبغي من إظهار شأن الله عز شأنه ونكران الذات، فيتدارك الأمر مرة ثانية، ومباشرة {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ}: فما يصنعه من فعل، ويقدم عليه من أمر في الإصلاح لا يتم منه شيء إلا بتوفيق من الله، وليس له في ذلك أي شأن، والجملة ـ كما يقول أهل العربية ـ تفيد الحصر، ونفي أي شيء له في هذا الأمر وحصر الأمر كله في الله تعالى. ثم يشدّد مرة أُخرى على هذا الإحساس بقوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
ولا يتأتى للأنا أن تختفي تماماً عن المسرح، ويتأكد عند صاحبها الإحساس بحضور الله، ومعية الله، وحول الله، وسلطانه، وأن ليس له من حول وقوة إلا بالله. إلا عندما يستشعر معية الله تعالى له وتوفيقه إياه بمثل هذه الدرجة من البصيرة والرؤية.
2ـ وهذا الإحساس ينفع الإنسان ثانياً في أن يضع كل ثقته ورجائه في الله، ويقطع كل أمل ورجاء من عند غير الله.
روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن ابن جميلة قال: سمعت أبا عبد الله (الصادق) “ع” يقول: <كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى “ع” ذهب يقتبس ناراً، فانصرف إليهم وهو نبي مرسل>[11].
ومهما يكن من أمر فإن ظاهرة التوفيق في حياة الإنسان ظاهرة واسعة وممتدة. وأي إنسان إذا أنعم الله عليه بالبصيرة وأنعم النظر فلا يكاد تخفى عليه لمسات يد الله ـ تعالى ـ في حياته في سرائه وضرائه وفي الشدة والرخاء، ولا تغيب عنه رعاية الله، ولا يتخلى عنه التوفيق الإلهي، في حياته المادية وحياته المعنوية وفي حركته وعمله.
مقارنة بين ما يطمح إليه الإنسان وبين توفيق الله للإنسان
وإذا قارننا بين ما يطمح إليه الإنسان في تفكيره وتخطيطه لحياته، وما يؤول إليه أمر حياته، بتوفيق الله، وتأييده، والفارق بين ما كان يريد وما أراد الله ـ تعالى ـ له تنكشف لنا ضخامة دور التوفيق في حياته،
وهذا يذكّرنا بما كان يريد المسلمون من غنيمة باردة عندما خرجوا إلى بدر ليرجعوا بأموال قريش وما أراد الله ـ تعالى ـ لهم من سلوك طريق ذات الشوكة: فلقد كان أكبر همّ المسلمين يومئذ أن يرجعوا بتجارة قريش موفورين، وكانوا يكرهون أشد الكره لقاء قريش والقتال معهم، وأراد الله ـ تعالى ـ لهم أن يلاقوا قريشاً في معركة حاسمة، يعودون منها أشدّاء أقوياء، سادة قوّامين للحق، يرفعون كلمة الله على وجه الأرض في مشارقها ومغاربها.
{وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ}[12].
إن الإنسان قد يريد الوصول إلى شيء من معصية الله، فيخرج إليه فيسلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة.
وقد يسلك طريقاً إلى الراحة والعافية وإيثار الحياة الدنيا، فيسلك الله تعالى به طريقاً إلى ذات الشدة والى الجنّة.
وقد يسلك طريقاً إلى متاع قريب من متاع الدنيا، فيسلك الله تعالى به طريقاً إلى رضوانه وقربه.
وقد يخرج من بيته في مُهمّة، ولا يعلم ماذا يصنع وأين يذهب، وأي باب يطرق، ومن أي وجه يطلب حاجته، فيأخذ الله تعالى بيده ويسلك به الطريق إلى حاجته خطوة خطوة راشداً مهدّياً.
التوفيقات الربانية في حياة الدعاة
إن الإنسان يجد أمامه في الدعوة إلى الله طريقاً صعباً وعراً وعقبات صعبة، وأعداءَ جبابرة، فيحار ماذا يصنع، ويكاد يركن في لحظة من لحظات الضعف إلى اليأس والخوف، فيأخذ الله بيده ويجتاز به هذه العقبات، عقبة، عقبة، ويَمُرّ به على مراحل الطريق الصعبة، مرحلة، مرحلة، ولا يفارقه في مواجهة الأخطار، وفي معاناة العمل الطويلة، وعند منعطفات الطريق الصعبة، وفي إجتياز العقبات. يلمس خلالها يد الله تعالى، ترافقه، وترعاه، وعين الله ـ تعالى ـ تبصره، وتعطف عليه.
وقد كان يقع أحدنا ـ من حملة الدعوة إلى الله ـ في قبضة جلاوزة الطاغوت في حقدهم، ووحشيتهم المعروفة، فتضعف نفسه عندما يجد نفسه وحيداً في قبضة السفاكين، يعملون فيه ما يشاؤون، لينتزعوا منه ما يشاؤون، ويخشى أن تضعف مقاومته أمام التعذيب، ويبوح بما يحرم عليه أن يبوح، فيخسر دينه ودنياه، فيملأ الله ـ تعالى ـ نفسه ثقة، ويَهبُ جسده قوة، ويجعل في نفس أعدائه الضعف والجبن، ويجتاز به الزنزانات، وحفلات التعذيب والتحقيق، ومراحل السجن والعذاب، ويؤنس وحشته في وحشة الزنزانات، ويملأ دنياه الصغيرة بين جدران الزنزانة الموحشة بما لا حد له من اليقين، والإيمان، والثقة بالله، والصبر، وإبتغاء رضوان الله ورحمته.
وإن الداعية ليفر بدينه فيخاف على أسرته وعائلته أن تصيبهم ضراء الجوع والخوف فيهيؤ الله تعالى لهم من المؤمنين من يقاسمونهم لقمة خبزهم، ويؤثرونهم على أهلهم.
لمسات التوفيق الإلهي للدعاة من القرآن
ولنرجع إلى القرآن لنلمس مواضع توفيق الله وتأييده لعباده الصالحين ولحملة دعوته ورسالته وتواكب هذه الرعاية الإلهية المؤمنين في مراحل الحياة الصعبة، وأمام بطش الجبابرة والطغاة. فها هي أم موسى تضع وليدها “ع”، فتخاف أن يقتله جلاوزة فرعون، فيضعف فؤادها لذلك، فيأمرها الله تعالى أن تقذف به في البحر وسط أمواجه العاتية الغاضبة، ليرده إليها من داخل قصر فرعون، ومن قبضة الطاغية، فتمتثل الأم خائفة وجلة:
{وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ * وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ * فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}[13].
سبحانك اللهم! من رب قادرٌ متعال، رؤوف، رحيمٌ تنقذ هذا الوليد الرضيع من بطش فرعون الذي آلى على نفسه أن يقتل كل وليد لبني إسرائيل، ومن وسط عباب أمواج البحر ترافقه رعايتك عبر أمواج البحر، وعبر قصر الطاغية، وبطشه، ويعود الطفل الرضيع إلى أمه، كي تقر به عينها، ولتعلم أن وعد الله حق، وتواكبه رعايتك حتى يبلغ أشده، ويستوي، وتؤتيه من لدنك حكماً وعلماً، وتؤتيه الحكم والنبوة في جانب الطور وهو يبحث عن قبس من النار لأهله في ليلة ظلماء باردة:
{فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ * فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}[14].
يبحث عن جذوة من النار لأهله في ليلة ظلماء باردة، وموحشة فإذا النداء المبارك الذي يملأ قلبه شوقاً، وخوفاً، وإيماناً، ويقيناً «إنّي أنا الله ربُّ العالمين».
ويضعف فؤاد موسى “ع” أن يضطلع بهذه الدعوة الكبيرة (النبوة) فيؤتيه الله تعالى برهانين كبيرين:
{وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ * اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ}[15].
إن حياة رسول الله وكليمه موسى “ع” من ولادته إلى رسالته والى أن نصره الله تعالى على فرعون وجنده، وأنجاه من اليم، وغرق فرعون وجنده فيه إلى نهاية حياته سلسلة متوالية ومتعاقبة من تأييد الله تعالى, وتوفيقه، ورعايته، وتشعر الإنسان بيد الله تعالى تواكب هذا العبد الصالح، وترافقه في مختلف مراحل حياته الصعبة.
وليس موسى “ع” بدعاً من الرسل، ولا يختلف الأمر في الأنبياء، والرسل عن سائر الناس من حملة الدعوة والرسالة.
>ما أمر الله سبحانه بشيء إلا وأعانَ عليه>. كما يقول الإمام أميرالمؤمنين “ع”[16].
يقول تعالى{إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}[17].
ويقول تعالى: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ}[18].
الذين يلمسون يد الله فيما ينالهم من التوفيق
وما أكثر ما يلتقي الناس، وسيّما الدعاة العاملون منهم تأييد الله تعالى في حياتهم، وتوفيقه، وتسديده لهم ويلمسون يد الله عن قرب، دون أن يعرفوها.
إن التوفيق الإلهي سُنَّة إلهية عامة لكل الناس بدرجات مختلفة، إلا الذين يسلبهم الله التوفيق. ومن دون هذا الأصل، لا يمكن أن تستقيم حياة الناس… ولكن قليلا من الناس يلمسون يد الله في حياتهم، ويعرفونها، وأولئك هم ذوو البصائر من عباد الله. وتلك خسارةً حقيقية في عالم (المعرفة). أن ينعم الله على عبد بالتوفيق في حياته، في السراء والضراء، وعند كل خطر، ومزلق من مزالق الحياة، وفي المعاناة، والراحة، والشدة، ثم لا يعرف يد الله في حياته، ولا يعرف رعايته له، ولا يشعر بمعية الله تعالى له في حياته، وما فتح الله تعالى عليه من أبواب رحمته ومعرفته، فيقف الإنسان دون هذا الباب، لا يهتدي إلى اليد الرحيمة التي ترافقه، وتعطف عليه، وتشده، وتعضده، وتفتح عليه مغاليق أبواب الحياة، وتيّسر له ما أغلق عليه من مسائل الحياة، وتؤدبه وتهذبه.
التوفيق باب من أبواب التوحيد
و(التوفيق) من الأبواب الواسعة لمعرفة الله، والإنسان يهتدي إلى الله من أبواب كثيرة أهمّها ثلاثة:
1ـ الفطرة
2ـ والعقل (الأدلة العقلية)
3ـ والتعامل مع الله تعالى.
والأخير (التعامل مع الله) باب واسع للمعرفة يلجه ذوو البصائر من الناس، ويهب الإنسان من الإيمان، والثقة، والطمأنينة، والاتكال ما لا تهبه الفطرة ولا العقل.
فإن الإنسان من خلال التعامل مع الله (الأخذ والعطاء)، أو التجارة مع الله، كما يقول القرآن الكريم، يشعر شعوراً قوياً برحمة الله، وعطائه، وبقرب الله تعالى منه ومعيته له… ومن خلال مراقبة مواقع تأييد الله تعالى وتوفيقه له ومعيته له في السراء والضراء وحفظه إياه من المهالك والمزالق وتسديده له، وهي كثيرة، يشعر بصورة قوية وعميقة بمعية الله.
سنن الله في التوفيق
وقبل أن نفارق الحديث عن (التوفيق) أحب أن أختم الحديث عن أسباب التوفيق وقوانينه في حياة الإنسان… فقد لا نعود إلى هذه النقطة بعد هذا الموضع خلال هذه الدراسة:
إن للتوفيق الإلهي في حياة الإنسان أسباباً، وقوانين، وأصولا، وليس أمراً عفوياً في حياة الناس، فمن أنعم الله تعالى عليه بالتوفيق لابد أن يكون أهلا وموضعاً لهذه الرحمة الإلهية، ومن سلب الله تعالى عنه التوفيق، ووكله إلى نفسه لابد أن يكون هو ممن أضاع هذه الفرصة على نفسه، ولم يكن أهلا لنزول رحمة الله ـ تعالى ـ فلم يعد بعد موضعاً لنزول هذه الرحمة.
فليس في رحمة الله تعالى شحّ أو بخل، ولا نفاد لخزائن رحمته، وإنما ينعم من الناس من ينعم بالتوفيق الإلهي، ويحرم من يحرم من الناس من توفيق الله ضمن سنن وقوانين لله. فمن حل في منازل رحمة الله شملته الرحمة الإلهية، ومن أعرض عنها وغاب عنها حُرم منها. وتختلف درجات الناس وحظوظهم من توفيق الله على قدر إستحقاقهم وأهليتهم وسعة آنائهم، ضمن هذه السنن.
والتوفيق من رحمة الله تعالى، تنزل على عباده من غير حساب، ويحرم الذين خسروا أنفسهم من هذه الرحمة الإلهية رأساً، وينال المؤمنون بعد ذلك من هذه الرحمة الربانية على قدر ما يتسع لها إناء نفوسهم.
أرأيت المطر ينزل من السماء على الأرض، غزيراً، فلا تنال منه الصخرة المرتفعة الناتئة شيئاً، ولا تنال منه الأرض الصلبة إلا القليل، وتمتص الأرض الهشة الكثير منه، وتحتفظ بكميات كبيرة منه في جوفها، ثم تعطي ثماراً طيبة وشهيّة. إن هذا الاختلاف ليس إختلافاً في حجم المطر النازل من السماء، وإنما ينبع من إختلاف الأراضي في قبول المطر وفي الخصوبة.
وكذلك إناء النفوس تختلف في رفض وقبول رحمة الله النازلة، كما تختلف في درجة قبولها لرحمة الله تعالى.
وهذا الاختلاف يتم بفعل الإنسان وإرادته.
وليس في أصل الخلقة حالة إنغلاق على رحمة الله تعالى، فإذا أعرض عن الله هبطت درجة إستعداده لاستقبال رحمة الله، وإذا أصر على هذا الإعراض يتضاءل إستعداده لاستقبال رحمة الله تعالى، أكثر فأكثر، فإذا استمر على هذه الحالة من الإعراض تنعدم قابليته لاستقبال رحمة الله، بصورة نهائية. وبالعكس كلما يقبل على الله تعالى يتسع إناء نفسه لإستقبال رحمة الله، حتى يبلغ مرحلة الصديقين والأولياء من عباد الله.
و(التوفيق) من هذه الرحمة الإلهية الهابطة على العباد، ويتبع هذه السنة الإلهية. فكلما إزداد الإنسان إقبالا على الله تعالى زاد حظه من توفيق الله تعالى ورعايته.
يقول أميرالمؤمنين “ع” في بيان هذه السنة الإلهية في علاقة التوفيق بالإقبال على الله والدين:
«كما أن الجسم والظل لا يفترقان كذلك الدين والتوفيق لا يفترقان»[19]
والمعادلة القائمة بين علاقة الله تعالى بعبده، وعلاقة العبد بربه يحدده قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ}[20].
وفي مقابل (التوفيق) الخذلان، وهو أن يتخلى الله تعالى عن عبده، ويكله إلى نفسه، والى أهوائه، وشهواته، فستفرد به الشيطان، والهوى، والطاغوت، في ساحة الصراع الداخلي والخارجي، وليس ثمَة من ينصره أمام العدو من داخل نفسه ومن الخارج:
{إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ}[21].
إن الإنسان ليقف في ساحة الصراع الملتهبة في مواجهة أعدائه، في داخل نفسه (الهوى)، وفي الخارج (الطاغوت)، يتمتع بمعية الله تعالى، وتأييده، وتوفيقه، فلن يغلبه الشيطان ولا الهوى، ولا الطاغوت، ما كان الله معه، وما كانت يد الله تؤيده وتسدده، فإذا تخلى عنه الله عزّوجلّ، وأحاله إلى نفسه، وأوكله إليها، استفرد به أعداؤه ولم يجد ناصراً ينصره، وبان عجزه وضعفه عن المواجهة.
{وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ}.
اقرأ أيضاً:
المصادر والمراجع
- [1] ـ عيون الحكم والمواعظ.
- [2] ـ راجع سفينة البحار 2: 675 مادة وفق والتعبير قريب مما ذكرناه.
- [3] ـ بحار الأنوار 5: 198، ح 17.
- [4] ـ نفس المصدر ح 18.
- [5] ـ بحار الأنوار 5: 42 والآية الكريمة{وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
- [6] ـ بحار الأنوار 5: 209ـ 210.
- [7] ـ من الغرور والزهو الروحي بالزهد والإستغناء عن متاع الحياة الدنيا.
- [8] ـ بحار الأنوار 12: 353.
- [9] ـ هود: 87.
- [10] ـ هود: 88.
- [11] ـ بحار الأنوار 13: 31ـ32 وفروع الكافي 1: 351 وفيه فإن موسى ذهب ليقتبس لأهله ناراً.
- [12] ـ الأنفال: 7.
- [13] ـ القصص: 8 ـ 15.
- [14] ـ القصص: 29ـ30.
- [15] ـ القصص: 31ـ32.
- [16] ـ ميزان الحكمة 4: 3605.
- [17] ـ محمد: 7.
- [18] ـ غافر: 51.
- [19] ـ ميزان الحكمة 4: 3606.
- [20] ـ البقرة: 152.
- [21] ـ آل عمران: 160.