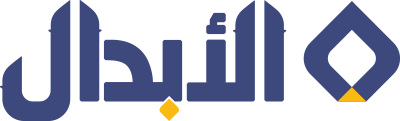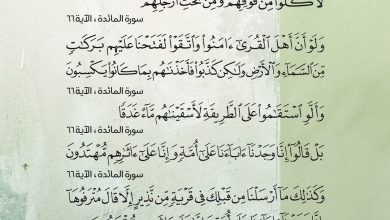أزمة المسلم المعاصر بين التراث والمعاصرة

أزمة المسلم المعاصر بين التراث والمعاصرة
يرى بعض المحدثين من الكتّاب: أن المسلم المعاصر يعيش اليوم في أزمة شديدة بين التراث والمعاصرة، لابد له فيها أن يختار أحد الخيارين، وليس له من سبيل آخر غير هذا الخيار أو ذاك.
والخيار الأول هو خيار المعاصرة، وهو ينطوي كما يقول الذين اختاروا هذا الخيار على الخيار الآخر، وهو التخلي عن التراث، وهو بمعنى التخلي عن الذات، فإن (الذات) في تكوين الأمم تاريخياً، هو تراكم من التراث، وتتميز الأمم فيما بينها، بمواريثها الحضارية وبهذا النحو من التفسير، المعاصرة: التجرد والتخلي عن التراث، وهو بمعنى التجرد والتخلي عن الذات.
والخيار الآخر هو التخلي عن المعاصرة، وهو بمعنى إيقاف عجلة الزمان، وتعطيل الحركة في حياة الأمة.
ولابد للأمة للخروج عن هذه الأزمة من أن تختار أحد الخيارين، إمّا التخلي عن الذات أو عن المعاصرة.
هكذا يطرح الكتّاب المحدثون من أمثال (الجابري) وبعض خصومهم الفكريين هذه المسألة، هؤلاء وأولئك قد أزاحوا أنفسهم، وخرجوا عن هذه الأزمة الصعبة وما يستتبعها من القلق بين القديم والحديث والتراث والمعاصرة باختيار أحد الخيارين.
فاختارت طائفة التراث والذات على المعاصرة والحداثة، وآثرت ماضيها وتاريخها وتراثها على الحداثة ومعطياتها التي لابد منها للإنسان المعاصر.
بعكس الطائفة الأخرى التي آثرت الحداثة على الماضي والتراث والذات، وعرفت أنه لابد من التضحية بأحدهما، ولا يمكن أن تجمع بينهما، فآثرت التضحية بالذات والتراث على التضحية بالحداثة، وحجتهم أننا نعيش ليومنا الحاضر، وليس الماضي، فإذا تقاطع الماضي والحداثة، فلا نختار على الحداثة شيئاً.
وأصحاب هذا الاتجاه هم رواد الفكر (التقريبي) في مجتمعنا.
الحلول التوفيقية:
ولصعوبة التخلي عن هذا أو ذاك يتّجه طائفة عريضة من المفكرين المعاصرين إلى الحلول التوفيقية الوسطية بين التمسك بالتراث والذات والإفادة من معطيات الحضارة الغربية.
يقال: أن الشيخ محمد عبدة، وهو من رواد الحلول التوفيقية، لما كان في باريس، وكان يشاهد نماذج من السلوك الغربي في النظام، والنظافة، والرتابة، والالتزام بالمواعيد، واحترام القانون وغير ذلك من السلوكيات الحضارية في الغرب، مما نفتقده هنا في الشرق، كان يقول: ها هنا، يعني (في باريس)، الإسلام، وهناك.. يعني (في الشرق) مسلمون.
وهذا الكلام يستبطن أن بإمكاننا أن نأخذ بالسلوكيات الحضارية الغربية، من دون حرج، ولا ينقص الغربيين من الإسلام غير شهادة (أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله) ومن الممكن أن نضم إلى هاتين الشهادتين اللتين نجدهما في الشرق النماذج الحضارية الغربية، ونؤلف منهما مؤلفة معاصرة تجمع بين حسنات الشرق والغرب.
ولست أدري إن كانت هذه الرواية عن الشيخ محمد عبدة، وبهذه الشمولية والإطلاق صحيحة أم لا؟ وأنا استبعد أن يُطلق عالم كبير من علماء المسلمين الرأي في الحضارة الغربية بمثل هذا الإطلاق. ولست الآن بصدد مناقشة هذا الكلام، فإن مناقشته تحتاج إلى سعة من الوقت لا أجدها الآن.
ولكنني أقول على عجل: أليس في الغرب إسلام ولا مسلمون، وها هنا في الشرق الإسلام والمسلمون وليس معنى وجود السلوكيات المناقضة للإسلام في الشرق أن ننعى الإسلام مرة واحدة، وننفيه في بلادنا.
أقسام الحلول التوفيقية:
وللحلول التوفيقية أقسام وأنواع، ومن ذلك أن نأخذ الأشكال والصيغ من التراث، والمضمون والمحتوى من الحضارات الغربية المعاصرة.
ذلك أن الثابت في الحضارات دائماً هو الأشكال والقوالب، وأما المحتوى فيتعرض في التاريخ لهزّات وتحوّلات كثيرة، كما في الرياضيات، فإن الثابت فيها هي الصيغ الرياضية، وأما مضمون هذه الصيغ ومحتواها فيتحول دائماً ويتبدل من وقت إلى وقت ومن عملية رياضية إلى عملية أخرى.
وهذا الكلام بمعنى أن نأخذ بالعقلانية الموروثة من الفكر الشيعي، أو المعتزلي ـ مثلا ـ ونحلل بها القضايا الحضارية المعاصرة مثل حقوق الإنسان والتسامح، والعنف، والمساواة.
أو يكون الأمر بالعكس نأخذ المضمون والمحتوى من التراث (الإعراض عن الدنيا، الزهد، الذكر، التقوى، الدنيا، الآخرة، الموت) بالعقلية الحضارية الغربية بـ (المنطق النفعي) مثلاً.
تحليل للحالة الإنسانية المعاصرة
قبل أن ندخل البحث لابد أن نشير إلى حقيقتين لا يمكن إنكارهما، والتشكيك فيهما، وهاتان المسألتان هما:
1ـ التخلف العلمي والاقتصادي والسياسي للعالم الإسلامي، ولا يمكن التشكيك في هذه المسألة البتة، والتشكيك فيها تشكيك في البديهيات.
ونحن عندما نناقش الحلول التنفيذية للأزمة المعاصرة التي يعيشها الإنسان المسلم لا ننفي هذه المسألة.
وفي رأينا أن لهذا التخلف أسباباً وجذوراً عميقة في التاريخ.
في عصور الأمويين والعباسيين والعثمانيين.
وفي البذخ والترف والظلم وسوء التوزيع والتمييز الذي مارسه الحكام خلال هذه الحقب الطويلة من تاريخ الإسلام. ولا يمكن أن نفصل واقعنا السياسي عن هذا التاريخ بالتأكيد.
وإذا قال القائل لا زالت هذه الأمة تعاني من تبعيات سلبيات (الجبر الإلهي والحتمية) التي أشاعها حكام بني أمية لإقناع المسلمين يومئذٍ أن ما يصيبهم من ظلم وإجحاف هو من قضاء الله وقدره، ولا سبيل لهم في تبديله وتغييره… لو قال قائل مثل ذلك لم يكن مجازفة في القول.
2ـ والنقطة الثانية التي لابد أن نشير إليها بهذا الصدد أن الغرب، وكذلك الجهة الشرقية الماركسية، قبل السقوط، لم يحققا للإنسان ما يحتاجه من الأمن والرخاء، والسعادة، وقد فشل القطبان العلمانيان في تحقيق المطالب الإنسانية الأساسية، والنموذج الحضاري الغربي معرّض للسقوط كما سقط النموذج الحضاري الشرقي من قبل والتشكيك في هذه الحقيقة كالتشكيك في الحقيقة الأولى.
والآن نبدأ بنقد الحلول الحضارية التلفيقية.
الخيارات الثلاثة
ونحن الآن أمام ثلاثة حلول لمواجهة هذه الأزمة.
الخيار الأول
الخيار الأول هو مسلك التبعية والتقليد، والارتماء في أحضان الحضارة الغربية بكل أبعادها، واختيار خيار التغريب، وهو لا شك حلّ يسير وسهل، إلاّ أنه تنقصه الحكمة والمعرفة. فليس النموذج الغربي هو النموذج الصالح ـ اليوم ـ للتقليد والتبعية. وإذا كان هذا النموذج يتألّق ويخلب أبصار الناس قبل خمسة عقود من الزمان، فليس الأمر كذلك في يومنا هذا.
فقد فقدت هذه الحضارة الكثير من تألّقها نتيجة الإحباطات الكثيرة التي أصابتها هذه الفترة.
ولو أن الذين يختارون خيار الحضارة الغربية كانوا يضعون في حسابهم هذه الإحباطات، ويقيّمون النتائج التي انتهت إليها التجربة الغربية، ويحسّون فهم القيم التي يختزنها تراثنا الإسلامي لم يتعجّلوا في اختيار هذا الحل.
ولا شك أن هذا الخيار يسير وسريع، ولا يتطلب جهداً، إلاّ أنّه قليل الجدوى عظيم الخسارة.
الخيار الثاني
هو الحل التلفيقي الذي يذهب إليه طائفة من الكتّاب المعاصرين ويعود هذا الحل في جوهره إلى التفصيل بين الشكل والمضمون، فنأخذ الأشكال والصيغ من التراث والمضمون من الحضارة الغربية.. فلَرب قيمة في عصر التشريع تنقلب اليوم إلى ضد القيمة بما يتطلبه عصرنا.
نأخذ من الشريعة (الولاء) و(البراءة) ونترك للمسلم حرية تشخيص (الصديق) الذي يتولاه، والعدو الذي يتبرأ منه لظروف عصره. وليس بالمقاييس التي تحدده له الشريعة.
نأخذ من الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ مثلاً ـ والتشدد أو التسامح في ذلك، ونأخذ من الحضارة الغربية (المعروف) و(المنكر) فلَرب (معروف)، ينقلب اليوم في الحضارة العصرية إلى (المنكر)، ولَرب (منكر) ينقلب اليوم إلى (المعروف).
نأخذ من الشريعة العقوبة على الجريمة، ونترك تحديد الجريمة التي تجب العقوبة عليها، وتحديد العقوبة التي يلزم تنفيذها على المجرم من ثقافة عصرنا.
..وهكذا، وعلى هذا المنوال.
إن جوهر الدعوة المعاصرة في التنظير للحداثة التي تحمل (الهوية الإسلامية) و(المعاصرة) معا، هو هذا المعنى التلفيقي.
وهناك حلول تلفيقية أخرى يذكرها كتاب المعاصرة للاحتفاظ بالالتزام بالشريعة والتراث، وفي نفس الوقت مواكبة متطلبات الحضارة العصرية التي لا يمكن التخلف عنها، كما يقول هؤلاء الكتّاب.
ولدينا كلمتان في نقد هذا الاتجاه التلفيقي.
الكلمة الأولى:
إن التمسك بالصيغ الشرعية، إذا كان لتخفيف وطأة الفترة الانتقالية من الشريعة إلى العلمانية فهو يدخل في دائرة العلاجات النفسية والاجتماعية للمرحلة الانتقالية، وليس لعلاج الأزمة.
وأمّا إذا كان نابعاً من الإيمان بالحدود والأحكام الإلهية وضرورة الالتزام بالشريعة.. فإن الإسلام كل لا يتجزأ. وقد أكملت الشريعة تشخيص الصيغ والأشكال والمضامين جميعاً. يقول تعالى{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }[1].
ولم يترك الله لعباده خياراً في التبعيض والتجزئ، يقول تعالى: { يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ }[2].
ويقول تعالى: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ }[3].
فإذا اخترنا ما اختاره الله لنا، فليس لنا أن نبعّض أو نجزّئ. فأما أن نأخذ بكل ما أنزله الله تعالى مرة واحدة.. أو يأخذ الإنسان سبيله إلى ما تُمليه عليه أهواؤه ورغباته.
والأصل الذي ليس فوقه أصل هو التسليم المطلق لله تعالى في كل ما أنزله الله، وهو قوله تعالى:{ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }[4] وقوله تعالى: { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ }.
ومن الخير لهؤلاء الكتّاب أن يصارحوا الناس بما يريدون. ويُعلنوا تحرّرهم عن الالتزام بالشريعة مرة واحدة، كما أعلن ذلك كثيرون قبلهم، ولن يشفع لهم هذا التلفيق و(الترقيع) في تمرير المشروع العلماني الذي يدعون الناس إليه.
وأنا أعتقد أن الكتّاب الذين يدعون الناس للعلمانية والتحرّر من الدين أشجع وأصدق من هؤلاء في تبيين مشاريعهم الفكرية.
وأما كيف نواجه متطورات الحياة بالنصوص الشرعية، والأولى غير محدودة، والثانية محدودة بالضرورة، وكيف تغطّي اللاّمحدود بالمحدود فهذا ما يأتي الحديث عنه في الخيار الثالث، دون أن يلزمنا علاج هذه الحالة بالتبعيض والتجزئ.
الكلمة الثانية:
إن الحلول التلفيقية فاشلة دائماً، فأما أن يكون المضمون والمحتوى من سنخ الصيغ والأشكال من الشريعة أو لا يكون شيء منهما من الشريعة، وأما أن تكون الوسائل من سنخ الغايات من الشريعة.
أما التلفيق بين الغايات والوسائل من شريحتين حضاريتين، وثقافتين مختلفتين، فلا يحقق هذا ولا ذاك.
والتلفيق بين الصيغ والمضامين من ثقافتين مختلفتين لا يحقق ما تطلبه الشريعة، ولا ما تهواه العلمانية.
الخيار الثالث
أن نأخذ الشكل والمضمون من الشريعة. وعندما نقول الشريعة لا نقصد بها المفهوم الغائم الذي يطرحه الكتّاب المحدثون بكلمات (التراث) و(القديم).
وإنما نقصد بالشريعة هدى الوحي للذي يؤمن بالوحي وهداه. ولا شك إن هدى الوحي عندما يتجذّر في أعماق التاريخ، ويشكّل وراثة ثقافية حضارية في التاريخ يتحوّل إلى قوة ذات مناعة وفاعلية وتأثير في حياة الناس، كما هو الحال في أي ميراث حضاري آخر.. غير أن قيمة هذا التراث من الوحي، وليس من التاريخ والعراقة والميراث، وإن كان للورثة دور في تعريق وتعميق هذا الوعي.
وعندئذٍ نقول: إن الشريعة حالة ثقافية وتشريعية متكاملة من حيث المضمون والشكل.
والالتزام بالشريعة يجب أن يكون التزاماً كاملاً، كما ذكرنا، لا تبعيض ولا تجزئ فيه فنأخذ من الوحي المضامين كالتوحيد، والبرائة من الطاغوت، والالتزام بالعبودية المطلق، والتسليم المطلق لله، والخروج عن حوزة سلطان الطاغوت، والتحرر من سلطان الدنيا، والزهد، وكرامة الإنسان، والثقة، والتوكل على الله، والإخلاص لله، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بحرية إرادة الإنسان في نفس الوقت، والقيم وأضداد القيم، والمعروف والمنكر، والحلال والحرام، وما يجب وما يحرم، وما ينبغي وما لا ينبغي.. وغير ذلك.
ونأخذ بالصيغ والأشكال كذلك من الشريعة كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والانضباط والتقوى، والجهاد، والحركة، والنظام، والعنف، والتسامح، والردع، والمنع، والحسم، والمرونة، والمنهج العقلي للتفكير، والنهج التربوي للتزكية وغير ذلك.
وهذه المضامين من نوع الصيغ والأشكال، وقد يتداخل المضمون والشكل، فلا يمكن فصل بعضهما عن بعض.
يبقى أن نشير إلى سوء التوجيه الفكري لطائفة من المفاهيم الإسلامية في الشكل المضمون.
سوء التوجيه لطائفة من المفاهيم الثقافية
يشير إليها هؤلاء الكتّاب إلى الطابع السلبي لطائفة من المفاهيم الثقافية في الإسلام.
ونذكر من ذلك (الزهد) فهو من صلب المفاهيم الإسلامية، بلا ريب، ويرى هؤلاء أن المضمون الثقافي والحضاري، إذا كان يصلح لمرحلة من التاريخ فلا يصلح للمرحلة الحاضرة. والتمسك بهذا المضمون الحضاري في حياتنا المعاصرة يؤدي إلى تخلف المسلمين عن التقدم التقني والاقتصادي، ولابد من تبديل هذه القيمة الحضارية إلى قيمة حضارية مضادّة لها، وهي الإقبال على الدنيا، والكدح والتخطيط لإعمارها.
إن هذه الإثارات والشبهات وأمثالها نابعة من الخطأ في توجيه وفهم المفاهيم الثقافية في هذا الدين.
فليس في (الزهد) ما يتعارض مع الكدح، والبناء، وإعمار الدنيا.. وليس معنى (الزهد) أن يهجر الإنسان الدنيا، ويعتزل الحياة، فهذا مما ينهى عنه الله تعالى، حيث يقول: { وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا }[5] ويقول تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ }[6].
إن معنى (الزهد) هو التحرّر عن سلطان الدنيا وذم الانشداد بالدنيا.
وشتّان بين هذا المعنى وذاك.
فقد يكدح الإنسان لكسب الدنيا وإعمارها ويملك من الدنيا حظّاً قليلاً أو كثيراً، دون أن ينشغل قلبه بالدنيا، وينشد إليها، وينصرف إليها عن الله تعالى والحياة الأخرى.
إن الإسلام لا يرفض الدنيا، ولا يكرهها، ولا يمقتها، وإنما يمقت انصراف الإنسان إلى الدنيا عن الله، وانشداد الإنسان بالدنيا من دون الله.
وما ورد في وصف الدنيا في النصوص الإسلامية من الذم، فلا يقصد بها الدنيا، وإنما يقصد بها أسلوب التعامل مع الدنيا.
فإذا أقبل الإنسان على الدنيا، وانشد إليها وصرفته عن الله، وكانت غايته من السعي والحركة، وهيمنت على قلبه، وحكمته، وقع الإنسان تحت سلطانها، فتلك الدنيا مذمومة.
وأما إذا عمّر الإنسان الدنيا، وملكها، وأصلحها دون أن يقع تحت هيمنتها وسلطانها، ودون أن تملك الدنيا أمره، واتخذها طريقاً وجسراً إلى الله تعالى فتلك الدنيا كريمة وممدوحة وشريفة.
عن رسول الله2، أنه قال: ( لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن فعليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر ) [7].
وقال أميرالمؤمنين (ع) وقد سمع رجلاً يذم الدنيا:
( أيها الذام الدنيا، المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا، ثم تذمّها؟! أنت المتجرم عليها، أم هي المتجرمة عليك؟! متى استهوتك؟ أم متى غرتك؟…
إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلّى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها؟ وقد آذنت ببينها، ونعت نفسها وأهلها ) [8].
فليس في الدنيا سوء وشر، وليس في الإفادة من الدنيا حرج. وإنما السوء والشر في طريقة النظر إلى الدنيا، وطريقة التعامل مع الدنيا.
يقول أميرالمؤمنين (ع): ( من ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته ) [9].
وهذه كلمة دقيقة وعميقة في طريقة النظر إلى الدنيا.
كيف يكافئ المحدود اللاّمحدود:
ويبقى آخر سؤال في هذا السياق لابد من إثارته والإجابة عنه.
وذلك، كيف يمكن تغطية المساحة غير المحدودة من شؤون الإنسان ومسائله على امتداد الزمان والمكان، بالنصوص الشرعية المحدودة التي نعرفها نحن من الكتاب والسنة.
فإن الزمان والمكان في تمدّد دائم، والنصوص الشرعية ثابتة ومحدودة بالضرورة.
والجواب على ذلك بقدر ما يتيسّر لنا في هذه العجالة.
إن طائفة من النصوص تشكّل القواعد الفقهية التي تتمدّد مع المكان والزمان، وتغطّي كل الحالات المتجددة التي تدخل في عمومها.
فالوفاء بالعقود، ولزوم العقود، قاعدة عامة تشمل كل عقد والتزام، ويتجدد في دائرتي الزمان والمكان، ما لم يدخل في دائرة المحظورات الشرعية.. وقد تجدد اليوم عقود جديدة كثيرة في البنوك والأسواق التجارية، وهي جميعاً مشمولة لقوله تعالى: { أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }[10]، وليس من سبب لتحديد دلالة هذه الآية الكريمة بالعقود المعروفة عصر الرسالة. نعم، لابد أن لا تكون العقود المستحدثة مشمولة للعقود المحظورة شرعاً، كالربا، والغرر مثلاً.
وقد أحصى الفقهاء القواعد الفقهية من العبادات ومن المعاملات فتجاوزت الأربعمائة.
بالإضافة إلى القواعد التي تدخل في كل أبواب الفقه في العبادات والمعاملات معاً مثل قاعدة الضرر مثلاً. هذا أولاً.
وثانياً: فتحت الشريعة على الفقهاء باباً واسعاً للوصول إلى الحكم الشرعي العملي (الوظيفي) عند فقدان النص أو إجماله أو تعارضه، وهو باب الأصول العملية. وهذا باب واسع ينفتح على كل مساحة الزمان والمكان.. ولسنا نستطيع الآن أن نفصل هذا الموضوع بأكثر من هذا.
وثالثاً: فتحت الشريعة باباً واسعاً للتقنين في حياة الناس من خلال الصلاحيات الممنوحة شرعاً للحاكم.. فيحقّ له بموجب هذه الصلاحيات أن يلزم الناس، ويحظر عليهم، ويُحرم المباح من الأحكام، ويلزم به، بمقتضى ما تتطلبه المصلحة الاجتماعية التي يتولاها الحاكم من حياة الناس.
ورابعاً: مكّنت الشريعة الفقهاء من استخدام العناوين الثانوية في الفقه لتغيير الحكم الشرعي، حسب الضوابط التي وضعتها الشريعة لذلك.
فالغسل والوضوء عند الضرر، ينقلبان إلى التيمم، والغبن في المعاملة يرفع الإلزام العقدي، والحرج في امتثال الحكم الشرعي يرفع الوجوب.
وأمثال ذلك.. وهذه العناوين كثيرة وواسعة يعرفها ويستخدمها الفقهاء كثيراً، وهي تمكّن الفقيه من مواكبة الظروف الزمانية والمكانية المتجددة بكفاءة عالية.
إذن (الاجتهاد) يمكّن الفقيه من تغطية المساحة المكانية والزمانية المتجددة اللاّمحدودة من الحاجات والأحداث بالنصوص الشرعية المحدودة من الكتاب والسنة، ولا يواجه الفقيه عجزاً مطلقاً في تغطية الأحداث المتجددة بالنصوص الشرعية.
وهذا باب واسع من العلم لا نستطيع أن نفتحه الآن بأكثر من هذا الحد.
وإنّ فقهاً يملك هذه الدرجة العالية من الكفاءة التشريعية والمرونة والقدرة على مواكبة الزمان والمكان، لن يواجه أزمة في مواكبة الزمان والمكان، ولن يحتاج إلى أمثال هذه الحلول التلفيقية.