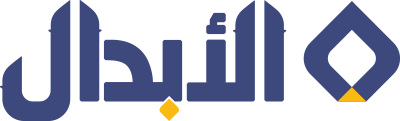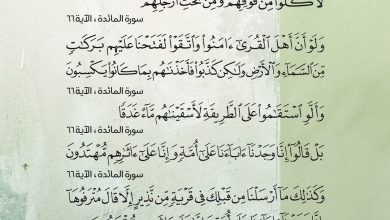الثقافة الإدارية والقيادية في حديث أهل البيت “ع”

فيما يلي نستعرض إن شاء الله طائفة من رسائل أهل البيت^، وهي كثيرة، في الثقافة القيادية والإدارية.
وقد انتقينا منها ثلاث رسائل، وهي:
رسالة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب “ع” إلى محمد بن أبي بكر(رضوان الله عليه) لما ولاّه مصر.
2ـ رسالة أميرالمؤمنين “ع” إلى أهل مصر عندما ولّى عليهم مالك الأشتر، وفيها يوصيه الإمام “ع” بالتعامل مع الناس بالرفق والعدل، وهذه الرسالة من كنوز الثقافة القيادية والإدارية في التراث الإسلامي.
3ـ رسالة الإمام الصادق “ع” إلى عبد الله النجاشي حاكم الأهواز.
وفيما يلي نقتصر على هذه النصوص الثلاثة بتعليقات وتأملات موجزة، بقدر ما يتحمله هذا البحث:
1ـ كتاب أميرالمؤمنين “ع” إلى محمد بن أبي بكر عندما ولاّه مصر
1ـ يقول “ع” في كتابه إلى محمد بن أبي بكر، عندما ولاّه مصر: (فاخفض لهم جناحك، وألِن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك بهم، فإن الله تعالى يسألكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة، والظاهرة والمستورة، فان يعذب فانتم أظلم، وإن يعف فهو أكرم).
هذه الكلمات مواعظ أخلاقية رفيعة, وفي نفس الوقت تبين الأصول العامة للثقافة الإدارية للمجتمع والحياة العامة.
يأمر الإمام “ع” هنا محمداً أن يلين جانبه للناس، ويبسط لهم وجهه، فلا يجد الناس فيه استعلاء المستكبرين وانقباض وجه المتغطرسين.
ينبغي للحاكم أن يبسط سلطانه على القلوب، حتى تخفق لـه حباً وعشقاً، من خلال اللين في الكلام، والابتسامة التي تشيع السرور في النفوس التي تمد أبصارها إلى القائد فتنتظر منه بسط الوجه والرضى والمحبة الدائمة.
(وآس بينهم في اللحظة والنظرة).
ثم ينتقل الإمام إلى المساواة في النظر بين الأشخاص، فيقول: إذا تحدثت إلى رعيتك فليكن نظرك موزعاً بينهم بالسوية، فلا تجعله موجهاً إلى فئة معينة أو شخص واحد وتهمل الآخرين, ولا تحابي بعض الناس في نظراتك دون بعض.
وقد يسأل أحد: ما قيمة النظرة حتى يؤكد عليها الإمام ويأمرنا بالمساواة فيها.
يقول الإمام×: (حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم,ولا ييأس الضعفاء من عدلك بهم).
فإذا ساوى بنظره بين الناس اشعر الناس انه يساوي في اهتمامه ورعايته للناس، فلا يطمع فيه أصحاب المطامع.
وفي الجانب الآخر لا ييأس الضعفاء من عدله، بل يبقى الأمل في نفوسهم أن يشملهم باهتمامه، ويحوطهم برعايته، فيذكرهم إذا غابوا ويتفقد أحوالهم ويعينهم على بلوى الفقر ومتاعب الحياة.
2ـ ثم يقول “ع”: (ولا تسخط الله برضى أحد من خلقه، فأن في الله خلفاً من غيره، وليس من الله خلف في غيره).
يأمر الإمام والي مصر أن يتخذ من الله ولياً وناصراً عوضاً عما في أيدي الأقوياء والمستأثرين الذين يرون بأنهم إذا تخلوا عن القائد وغابوا عن مجلسه فسوف يضعف، ثم يقول لـه لا تسخط الله برضى الأغنياء والأقوياء، فان قوتهم إلى زوال, وارتبط بالقوة الإلهية المطلقة المهيمنة على الكون من أوله إلى آخره.
ثم يقول لـه: (فإن في الله خلفاً من غيره، وليس من الله خلف في غيره).
تذكرنا هذه الكلمة بدعاء الإمام الحسين “ع”: (ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك)؟([2]).
إذا انفضّ الأغنياء من حول الحاكم، فان الله عزّوجل يخلفه بقوته وتوفيقه، وتسديده، ولكن ليس لله بديل ولا عوض، إذا أعرض عن عبده وأوكله إلى نفسه، إذا هجرته الرحمة الإلهية، وتخلى الله عنه و أوكله إلى قوته وحاشيته وحراسه، فإنه لا بديل لقوته المطلقة، فإذا التفت الحاكم إلى هذه المعاني فلا يستوحش لتفرق الناس عنه.
3ـ ثم يقول “ع” لحاكم مصر: (صلَِّ الصلاة لوقتها الموقّت لها، ولا تعجَّل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، واعلم إنّ كل شيء من عملك تبع لصلاتك).
لا ينبغي للقائد أن يؤخر الصلاة ـ التي تعبر عن عمق العلاقة مع الله ـ عن بحجة الهموم الإدارية مهما بلغت في خطورتها الاجتماعية([3]).
إنه التنظيم الدقيق لوقت الحاكم بين الإدارة وبين الالتفات إلى ذاته وعبادته ومراقبته علاقته بالله حتى لا تستغرقه مسؤولياته الاجتماعية، فيهمل أمر الصلاة, لأنه يستمد من عبادته القوة في إدارته وعمله، فهي تجدد طاقاته النفسية، وتعيد الهدوء إلى أعصابه فيتخذ القرار وهو هادئ النفس, فإن هموم العمل تفقد الإنسان التوازن والاتزان والحزم والحسم في القرار.
فيحتاج إلى محطة عبادية وخلوة مع الله بعيداً عن ضجيج الناس يجدد فيها الاتصال بالله.
وبذلك يستعيد قواه ونشاطه وحيويته (فإن كل شيء تبع لصلاتك).
وفي دعاء كميل (حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ورداً واحداً)([4]).
وما أجمل أن تكون حياة القادة تبعاً للصلاة، وتعبيراً للعبودية لله تعالى، وتطبيقاً لمفاهيم الاستعانة والتوكل والثقة بالله.
2ـ كتاب أميرالمؤمنين “ع” إلى أهل مصر عندما ولّى عليهم مالك الأشتر
وهذا دستور آخر للثقافة الإدارية يتحفنا به أميرالمؤمنين “ع” وهو عهده إلى مالك الأشتر، حينما ولاّه مصر.
يقول الإمام علي “ع”: (هذا ما أمر به عبد الله علي أميرالمؤمنين “ع” مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها).
يحدّد الإمام علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين “ع” في عهده إلى مالك الأشتر مسؤوليات الحكومة في ثلاث نقاط:
1ـ الأمن 2 ـ المصالح العامة (الخدمات) 3ـ الإعمار.
والمسؤولية الأولى هي الأمن، من أعداء الداخل والخارج، وما لم يتهيأ للأمة الأمن لا يستطيع الحاكم أن يقدم للناس الخدمات الأخرى.
ثم الخدمات والمصالح الاقتصادية والصحية والتعليمية والمعاشية، وما يشبه ذلك.
ثم الخدمات العمرانية، والبلدية، والطرق، والري، والمنشآت الصناعية، واستصلاح الأراضي، والاتصالات وغير ذلك.
وهذه المهام الثلاثة تحتاج إلى جباية الأموال التي تقوّم هذه المشاريع الثلاثة.
والإمام “ع” يشرح هذه النقطة في هذه الفقرة من عهده إلى مالك الأشتر بقولـه: (جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها).
نظام العلاقات الثلاثة في ولاية الحاكم
ثم يبين الإمام “ع” لمالك الأشتر نظام العلاقات الثلاثة في حياة الحاكم، وهي:
1ـ العلاقة بالله تعالى.
2ـ العلاقة بالناس.
3ـ العلاقة بالنفس.
ويشرح الإمام هذه العلاقات الثلاثة واحدة بعد أخرى.
- 1ـ في العلاقة بالله:
يحدد الإمام العلاقة بالله تعالى بالطاعة لله، وتقوى الله، واتباع أوامر الله تعالى ونواهيه، وأن ينصر دين الله حتى ينصره الله.
يقول “ع” في عهده: (أمره بتقوى الله، وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يُسعد أحد إلاّ باتباعها، ولا يشقى إلاّ مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جلّ اسمه قد تكفل بنصر من ينصره وإعزاز من أعزه).
ثم يقول له: (وإياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته، فإن الله يذلّ كلّ جبار، ويهين كل مختال).
- 2ـ في العلاقة بنفسه:
وهذه العلاقة تمكّن الإنسان من العلاقة الأولى والعلاقة الثالثة، ولا تستقيم هذه ولا تلك إلاّ إذا تمكّن الإنسان من العلاقة بنفسه.
ويعطي الإمام، في عهده لمالك هذه العلاقة قدراً كبيراً من الأهمية فيأمره أن يملك هواه، ولا يأذن لهواه أن يملكه.
وليس بين هذا الملك وذلك أمر ثالث، فإذا ملك الإنسان هواه لم يملكه هواه، وإذا ملكه هواه لا يملك هواه، ولا ثالث، فأما أن يتمكن الإنسان من أهوائه ويفرض عليها سلطان إرادته أو يخضع لسلطانها.
يقول “ع”: (فاملك هواك).
ثم يأمره “ع” أن يشح بنفسه عما لا يحلّ له، ويكون ضنيناً بنفسه، ولا يعطي نفسه للفتن بلا حساب ولا حدود… فإن قيمة العاقل بقدر ما يشح بنفسه من الفتن، وما يعطي منها لله.
ومن إنصاف الإنسان لنفسه أن يشح بها في الفتن، ومن سوء الإنصاف أن يبذّر الإنسان بنفسه فيها.
فليس شيء أعزّ على الإنسان من نفسه ـ إلاّ الله ورسوله ـ فلابد أن يكون شحيحاً بها.
يقول “ع”: (وشحْ بنفسك عمّا لا يحلّ لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبّت أو كرهت).
ثم يأمره “ع” أن يكف جمحات نفسه وثورة أهوائه وشهواته…
يقول “ع”: (أمره أن يكسر نفسه من الشهوات، ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمّارة بالسوء، إلاّ ما رحم الله).
يكفّها عند جمحات النفس وثوراتها.
والنفس البشرية جموحة ثائرة، هائجة، فإذا لم يكسر صاحبها جموحها، ولم يتمكن من هياجها ويسيطر عليها تملكه، وتقوده إلى الهلاك، وما لم يتمكن الإنسان من أهوائه وشهواته لا يصحّ أن يتولى أمراً من أمور المسلمين.
فمن لا يملك أمر نفسه لا يصلح أن يملك من أمور المسلمين شيئاً… وهذا هو معنى العدالة في الولاية.
- 3ـ العلاقة بالناس:
يطول كلام الإمام “ع” في عهده إلى مالك في العلاقة مع الناس، وهو القسم الثالث من العلاقات الثلاثة، ويعطي هذا الشطر مساحة واسعة من عهده إلى مالك.
ولا يسعنا أن نتحدث في هذا الشطر من كلام الإمام بالتفصيل في هذه الخلاصة، رغم أن هذا الشطر من كلام الإمام “ع” في تعامل الحاكم مع الرعية هو موضوع هذه الرسالة.
التعريف بالناس
وأول شيء يلفت نظرنا في كلام الإمام “ع” في التعريف بالناس هو قوله “ع”: (ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم (الناس) صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق).
وهو أجمل تعريف للجمهور الذي يتعامل معه الحاكم وأرحبه… إن هؤلاء الناس لا يخلو أمرهم من (الاخوة في الدين أو المناظرة في الخلق) وكلاهما يقتضي الحاكم الرأفة والرحمة… ولا يصحّ أن يقسو الإنسان على أخ لـه في الدين، تربطه به وشيجة الأخوة في دين الله ورابطة الولاء، ولا يصحّ أن يقسو الإنسان على نظير له في الخلق، يحب ما يحب ويكره ما يكره، ما لم يصدر منه ذنب يستحق منه هذه القسوة… فكما لا يحب الحاكم أن يقسو عليه أحد، ويحب لنفسه التكريم والرحمة، كذلك نظراؤه في الخلق.
طبائع الناس
ثم يبين الإمام “ع” طبائع الناس فإن الزلل والزلات شيء مغروس في طبائع الناس، ما لم يهذّب الإنسان نفسه، ويمتلك أزمّتها بشكل كامل… وهو أمر نادر في حياة الناس.
إذن لا يصح أن يتخذ الحاكم أمر الزلل والزلات في حياة الناس حجّة لاضطهادهم وعقوبتهم والتشديد عليهم… والزلل والزلات غير الإصرار على الإثم والذنب وارتكاب الجرائم والموبقات… وما يجوز ويجب في الجرائم والموبقات لا يجوز في الزلات والزلل.
فلنستمع إليه “ع” وهو يصف طبائع الناس الذين يتعامل معهم الحكام.
يقول “ع” في كلامه السابق: (فإنهم (الناس) صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ).
هؤلاء هم الناس تصدر منهم الأخطاء والزلات، في العمد والخطأ، وتسبق منهم الزلل من غير قصد وتعرض لهم العلل التي تسوقهم إلى الانفعال والغضب والزلات والأخطاء… فيجب أن يتعامل معهم الحاكم بالرفق والعفو دون العنف، من دون ضعف، وفي غير الجرائم التي لابد للحاكم فيها من التشديد والتعنيف.
التعامل من موقع الرحمة
والتعريف المتقدم للناس، والإيضاح المتقدم لطبائع الناس، يتطلب الرحمة بالناس والعطف والتحنن عليهم.
يقول “ع” في عهده لمالك: (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً).
والقائد الذي يمنح رعيته الحب والعاطفة يكسب بالمقابل حبهم وثقتهم وعاطفتهم.
رحم الله الإمام الخميني أحب الناس وأحبه الناس، وبادلوه الحب بالحب، وهو مثال نادر جداً في الزعماء السياسيين في عصرنا.
التعامل من موقع العفو والصفح
ثم يأمره “ع” أن يتعامل مع الناس بالعفو والصفح، فلا يشدد في محاسبتهم، ويعاملهم بالتسامح.
يقول “ع”: (فأعطهم من عفوك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، وولّي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاّك).
فهم يحبون عفوك وصفحك، كما تحب العفو والصفح من الله، فإذا أعطيتهم من عفوك وصفحك ما يحبون أعطاك الله من عفوه وصفحه ما تحب وترضى.
فإنك فوقهم، وولي الأمر فوقك، والله تعالى فوق الجميع.
ثم يقول “ع”: (ولا تندمنّ على عفو، ولا تبجحنّ بعقوبة).
والتبجح بالعقوبة من صفات الجبارين والندم على العفو من وساوس الشيطان.
ثم يقول “ع” لمالك: (ولا تُسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة) وهو درس هام في طريقة تعامل الحاكم مع رعيته ساعات الانفعال والغضب؛ فإن الاستسلام للحظات الانفعال والغضب ضعف، فلا يسرع الحاكم إلى الحكم في لحظات الانفعال والغضب، (والبادرة: الغضب)، كلما وجد إلى ذلك سبيلاً ومندوحة، (والمندوحة: المتسع والسبيل إلى التخلص).
وظلم العباد من محاربة الله تعالى
شر الظلم أن يظلم الإنسان نفسه أو يظلم عباد الله، وظلم العباد من ظلم النفس، فمن يظلم عباد الله يظلم نفسه أكثر مما يظلم الآخرين.
والذي يظلم عباد الله يدخل في دائرة محاربة الله تعالى، فإن ظلم العباد من محاربة الله.
ومن ينصب نفسه لحرب الله يخسر الحرب لا محالة، فلا يقوى على محاربة الله أحد من خلقه.
يقول “ع”: (ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يد (لا قدرة) لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه)، انك لا تقوى على غضب الله ونقمته.
ولا تستغني عن عفوه ورحمته… إذا فلا تعرض نفسك لغضب ونقمته، ولا تبتعد عن منازل عفوه ورحمته، وإذا شئت ذلك فلا تظلم عباد الله، لئلا تتعرض لغضب الله ونقمته، وأحسن إلى الناس لتكون عند عفوه ورحمته تعالى.
والله تعالى يخاصم من يظلم عباده:
والله تعالى يخاصم من يظلم عباده، وظلم العباد مخاصمة لله… ومن كان الله تعالى خصمه خاب وكان من الخاسرين.
يقول”ع”: (ومن ظَلَم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حرباً حتى ينزع أو يتوب).
ولسنا نعرف كلاماً أبلغ وأقوى من هذا الكلام في استعظام ظلم العباد من ناحية الولاة والرعاة.
والنص عجيب يستوقف الإنسان.
إن العباد خلفاء الله في أرضه، والله يدافع عن عباده وخلفائه ويحبّهم، ويخاصم من يظلمهم، وهذه هي المعادلة الأولى.
ومن خاصمه الله أدحض الله حجته، ولا يقوى على محاججة الله في ظلمه لعباده، وهذه هي المعادلة الثانية.
وأعجب منهما وأبلغ المعادلة الثالثة.
(ومن ظَلَم عباد الله… كان لله حرباً حتى ينزع أو يتوب).
إن ظلم العباد بمعنى إعلان الحرب على الله… وناهيك بذلك.
النهي عن الاستعلاء على الناس
وينهاه “ع” من أن يستعلي على الناس، ويستغل موقعه في الأمر والحكم في إذلال الناس وتطويعهم لأوامره ونواهيه، كما يفعل الجبابرة من الحكام.
(ولا تقولن أني مُؤمّر (أي مسلط وحاكم عليكم) آمُرُ فَاُطاع).
إن الطاعة لابد منها في نظام المجتمع، ومن دون الطاعة لا ينتظم المجتمع… ولكن لا يلجأ الحاكم إلى توظيف موقعه، في تطويعهم لأحكامه إلاّ في حالات الضرورة… وفي غير ذلك يحفظ الحاكم نظام المجتمع بالتثقيف والتوجيه، وليس فقط بالإلزام والتشديد والعنف، كما يفعل الجبابرة.
فإن أسلوب العنف والتشديد في التعامل مع الناس من قبل الحاكم يؤدي إلى إفساد قلوب الحكام أولاً، فإن القلوب تفسد بالتشديد والتعنيف والاستعلاء على الناس، والى إضعاف الدين في حياة الناس، فإن الحالة السوية في الدين، أن يحكم الحاكم الناس من غير إكراه وتعنيف، وإذا اضطر الحاكم إلى الإكراه والتعنيف كان ذلك بسبب عجزه في الإدارة والحكم، وليس لحاجة الدين إلى التشديد والعنف؛ فإن الله تعالى قد جعل الدين على منهج معتدل من الفطرة لا يُحْوِجُ الحاكم إلى استعمال الشدة والعنف إلاّ في حالات استثنائية.
وإذا أكثر الحاكم من اضطهاد الناس والتشديد عليهم أدّى ذلك إلى إضعاف دور الدين وإنهاكه في المجتمع وفي نفوس الناس… وهذا هو الأثر الثاني في التشديد والعنف.
والأثر الثالث أن تراكم العنف والشدة والاضطهاد في الحكم يؤدي إلى سقوط الحاكم والنظام، وثورة الناس على الحاكم ولابد أن ينفذ صبر الناس وتحملهم في وقت قريب، فيثور الناس على الحاكم، فلا يستطيع عندئذٍ أن يقاوم غضب الناس وسخطهم.
ولنستمع إلى الإمام “ع” في وصيته لمالك الأشتر: (ولا تسرعن إلى بادرة (حالات الغضب والانفعال) وجدت منها مندوحة (استطعت أن تتفاداها بالحلم والتغاضي وسعة الصدر)، ولا تقولن أني مُؤمّر (مسلط عليكم) آمر فأطاع (إني آمر وعليكم الطاعة)، فإن ذلك (التبجح بالسلطان والشدة في العمل) إدغال (إفساد) في القلب، ومنهكة للدين (ضعف للدين)، وتقرب من الغير).
والغِيَرْ: تقلّب الأحداث السياسية بصورة مفاجئة، فإن هذا الإفساد والتبجّح سرعان ما يثير غضب الناس ويثيرهم، فلا يستطيع الحاكم أن يقاوم غضب الناس، فيسقط.
عندما تتعارض العلاقات الثلاثة
هذه العلاقات الثلاثة حقوق… على عُهدة الحاكم أن يفي بها: حق الله تعالى عليه، وحق الناس، وحق نفسه عليه… وكل منها حق، ولابد أن يعطي لله تعالى حقه، وللناس حقوقهم، ولنفسه حقها.
ولابد أن يوازن بين هذه الحقوق والعلاقات، لئلاّ يجوز ويتجاوز بعضها على بعض.
والتجاوز الذي يحصل عادة في هذه الحقوق الثلاثة يحصل عادة من ناحية إيثار جانب النفس على حقوق الله وحقوق عباده.
وعندما نقول: (إيثار جانب النفس على حقوق الله وحقوق عباده) نقصد بالنفس معنى أوسع من (الأنا)، يشمل خاصة الإنسان وأهله، والقريبين إليه، ومن لـه فيه هوى، من بطانته والمتقربين إليه، وهؤلاء جميعاً امتداد للنفس و(الأنا) بشكل أو آخر، فيأخذ الحاكم جانبهم، ويؤثر جانبهم على جانب حقوق الله عليه وحقوق عباده… وهذا هو ابتلاء أغلب الحكام والولاة.
فيأمره الإمام “ع” أن ينصف الله تعالى وينصف الناس من نفسه، يعني يعطي لله تعالى حقه وللناس حقوقهم الذي جار عليهم لصالحه ولصالح من يميل إليه، وينصف الله، وينصف الناس من نفسه.
يقول “ع” في نفس العهد: (انصف الله، وانصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لله فيه هوى من رعيتك، فإنك إلاّ تفعل تظلم)… إنذار وتهويل.
وهذه الكلمة ذات وقع عجيب في نفس الإنسان (فإنك إلاّ تفعل تظلم).
والظلم هو التجاوز على حقوق الآخرين لصالح نفسه، ولصالح من له هوى فيه، ومن الظلم أن يتجاوز الإنسان على حقوق الله تعالى وحقوق عباده، وان لم ينصف الله من نفسه وينصف الناس من نفسه، فهو يدخل في عداد الظالمين، والظالمون في النار.
العامة والخاصة
العامة والخاصة تعبير عن تقسيم طبقي في المجتمع، يقوم على أسس غير شرعية من الثراء والسلطان.
وأما إذا كان مصدر الثراء والسلطان شرعياً فلن يكون الاختلاف الطبقي داخلاً في هذا التقسيم، ولن يكون موضوع هذا البحث، غير أن الثراء المشروع والسلطان المشروع لن يؤدي في الغالب إلى الفواصل الطبقية الكبيرة إلاّ في حالات استثنائية ونادرة، وكلما وجدنا مجتمعاً طبقياً تنفصل طبقاتها بعضها عن بعض بفواصل كبيرة، كالذي نراه في المجتمعات الرأسمالية في الغرب، فلابد أن يكون هذا الاختلاف الطبقي الكبير حاصلاً من أوضاع غير شرعية في تحصيل المال أو السلطان.
ومهما يكن من أمر: فإن (العامّة) في هذا التقسيم، هي المساحة الاجتماعية العريضة المحرومة، والخاصة هي الطبقة الاجتماعية المحدودة المرفهة من حيث الثراء والقوة من حيث السلطان والقوة.
والطبقتان الاجتماعيتان (العامة والخاصة) في هذه المجتمعات (القائمة على الثراء والسلطة غير المشروعة) متقاطعتان، ونقصد بالتقاطع: انّ ثراء وسلطان الخاصة تتمّ على حساب العامّة، وتتمدد الخاصة في ثرائها وسلطانها على مساحة حقوق العامة في المال والسلطان.
ومعنى ذلك: أن الخاصة في مثل هذه المجتمعات تعتدي على حقوق العامة في المال والسلطان، وتستأثر بها دون العامة من غير حق، كما يحصل ذلك في المجتمعات الرأسمالية الغربية القائمة على العدوان الطبقي.
وهذا هو الذي يقصده أميرالمؤمنين “ع” في كلمته المعروفة (ما جاع فقير إلاّ بما مُتّع به غني)([6]).
وهذه المعادلة تصح من الطرفين: ما جاع فقير إلاّ بما مُتّع به غني، وما تمتع الأغنياء إلاّ بما جاع به الفقراء.
وذلك لأن هذا الثراء والسلطان قد حصل من مصادر غير مشروعة للمال والسلطان… وكل ثراء وسلطان غير مشروع يتم لا محالة بالعدوان على حقوق العامّة في المال والسلطان.
ويقول “ع” ـ أيضا في هذا السياق ـ: (ما رأيت نعمة موفورة إلاّ وبجانبها حق مضيّع) ([7]).
ولاشك أن الإمام “ع” يقصد بـ (النعمة الموفورة) الثراء غير المشروع، ولا نشك أن الفواصل الطبقية الكبيرة، لا يمكن أن تحصل غالباً من مصادر شرعية في الإثراء والسلطان.
وبناء على ذلك يقول الإمام “ع”: إلى جانب كل إثراء غير مشروع حق مضيّع للناس، وهي معادلة ثابتة.
وعندئذٍ نتساءل كيف يتعامل الحاكم مع هاتين الطبقتين، في المجتمعات التي تتواجد فيها هاتان الطبقتان.
فإن هاتين الطبقتين متقاطعتان، لا يمكن أن يجمعهما الحاكم في الرضا، بسبب التقاطع القائم بينهما، ولأن الخاصة تمتد على مساحة حقوق العامة، فإذا أرضى العامة يسخط الخاصة، وإذا أرضى الخاصة يسخط العامة، ولا يمكن أن يكسب الحاكم رضاهما جميعاً، إلاّ إذا زالت عنهما حالة التقاطع والتمادي، وامتداد إحداهما على حقوق الأخرى.
وعندئذٍ فلابد أن يكسب الحاكم أجمع مساحة للرضى (أوسع مساحة للرضا)([8]) داخل المجتمع، حيث لا يمكن أن يعمم كل الساحة بالرضا.
والمساحة الأوسع في المجتمع التي يجب أن يرضيها بالعدل والحق، وان أسخط الأخرى، هي مساحة العامة من الناس (الجمهور).
يقول الإمام “ع” إذا تعذر على الحاكم تعميم الاسترضاء على الجميع، وكان لابد من تقديم إحداهما على الأخرى… يتعين على الحاكم أن يُقدّم رضا العامة على الخاصة، شريطة أن يكون ذلك ضمن قواعد الحق والعدل، فإن رضى العامة يجبر الخلل الحاصل من سُخط الخاصة، وسُخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس العكس، فلا يجبر رضا الخاصة سُخط العامة، ولا ينفع الحاكم رضا الخاصة، إذا سخطت العامة.
فاستمع إليه “ع”: (وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف (يُزيل ويُذهب) برضى الخاصة، وأن سُخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة).
وهو كلام وتحليل دقيق، حيث لا يتمكن الحاكم أن يجمع رضا العامة والخاصة، فلابد أن يقدّم العامة على الخاصة لأن (سُخط العامة يجحف برضا الخاصة، وأن سُخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة)، ولكن بشرطين يذكرهما الإمام “ع” في نفس الفقرة، وهما إقامة الحق والعدل.
(وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل).
ثم يبين الإمام “ع” خصائص كل من الخاصة والعامة.
خصائص الخاصة
وأول ما يتحدث عنه الإمام في هذا العهد السمات البارزة في طبقة الخاصة.
فيقول “ع”: (وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكراً عند الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة).
وهذه سبع خصال رديئة في هذه الطبقة:
1ـ فهي ثقيلة على الولاة في مطالبها في أيام الرخاء.
2ـ قليلة ا لعون والنجدة لهم في ساعات الشدة والابتلاء.
3ـ كثيرة الإجحاف قليلة الإنصاف.
4ـ كثيرة الإلحاف والإصرار في المطالب.
5ـ قليلة الشكر.
6ـ بطيئة في الإعذار عند المنع.
7ـ قليلة الصبر في الملمّات.
وهذه الخصائص والخصال التي يذكرها الإمام “ع” في هذا العهد تجعل هذه الطبقة طبقة اجتماعية تعيش على البطر، وقليلة الجدوى، غير مقاومة، ولا تصلح لمواجهة التحديات، ولا تقف في الملمّات والشدائد مع الناس.
خصائص العامة
ثم يتحدث الإمام “ع” بعد ذلك عن قيمة العامة فيقول “ع”: (وإنما عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الأمة).
وهذه ثلاث خصال:
1ـ هم عماد الدين، يتقوم به الدين في مواجهة التحديات التي تهدد سلامة الدين وبقاءه.
2ـ وهم جمهور الأمة (جماع المسلمين) وهم السواد الأعظم من المسلمين، وعليهم تنزل الرحمة والبركة والنصر من عند الله.
3ـ وهم العدة للأعداء… التي تمتلك المقومات، وتختزن كل المقاومة التي تحتاجها الأمة في أيام البأساء والشدة.
إيثار العامة على الخاصة
والنتيجة التي يستنتجها الإمام× من هذه المقارنة بين العامة والخاصة هو إيثار العامة على الخاصة، بالعدل والحق فهي قوام الدين، وجمهور الأمة، والعدة للمقاومة في أيام البأساء والشدة.
فيقول×: (فليكن صغوك (ميلك) لهم، وميلك معهم).
3 ـ كتاب الإمام الصادق “ع” إلى عبد الله النجاشي
قصة الكتاب:
عن عبد الله ابن سليمان النوفلي، قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق “ع” فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلّم وأوصل إليه كتابه، ففضه وقرأه وإذا أول سطر فيه: بسم الله الرحمن… إلى أن قال: إني بليت بولاية الأهواز، فان رأى سيدي ومولاي أن يحدّ لي حداً، أو يمثّل لي مثالاً لأستدل به على ما يقرّبني إلى الله عزّوجل وإلى رسوله، ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به، وفيما أبذله وأبتذله، وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها، وبمن آنس، وإلى من أستريح، وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري؟ فعسى أن يخلصني الله بهدايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك.
قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله “ع”:
(بسم الله الرحمن الرحيم، حاطك الله بصنعه، ولطف بك بمنه، وكلاك برعايته، فانه ولي ذلك أما بعد فقد جائني رسولك بكتابك، فقرأته وفهمت جميع ما ذكرت، وسألت عنه.
وزعمت إنك بليت بولاية الأهواز، فسرني ذلك وساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك، وما سرني إنشاء الله، فأما سروري بولايتك، فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل محمد عليهم السلام، ويعز بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوي بك ضعيفهم، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم، وأما الذي ساءني من ذلك، فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا، فلا تشم حظيرة القدس، فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه، إنْ أنت عملت به، ولم تجاوزه رجوت أنْ تسلم إنشاء الله.
أخبرني ـ يا عبد الله ـ أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب “ع” عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: من أستشار أخاه المؤمن، فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه.
وأعلم أني سأشير لك برأي إنْ أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفهُ).
ثم يكتب إليه الإمام الصادق “ع” مجموعة من الدروس في هذا السياق.
أول هذه الدروس:
(فأما سروري بولايتك، فقلت عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل محمد عليهم السلام، ويعزّ بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوي بك ضعيفهم، ويطفى بك نار المخالفين عنهم).
إن مواقع المسؤولية في أجهزة الدولة ذات حدين فقد يتولاها ناس صالحون، أصحاب دين وورع وتقوى، فيوظفون هذه المواقع في خدمة الصالحين الهادين المستضعفين من الناس، ودفع الأذى والسوء عن المضطهدين من شيعة آل محمد “ص” الذين كانت السلطات الظالمة تلاحقهم خلف كل حجر ومدر، وقد تكون هذه المواقع بيد ناس ظالمين مستكبرين، يستضعفون المؤمنين الصالحين، ويزيدون في عذابهم وحرمانهم، ويضيّقون عليهم ـ كما كانوا يصنعون في أيام بني أمية وبني العباس.
فإذا تولى هذه المواقع صالح يخدم الناس كان في ذلك رضى الله تعالى ورسوله وأوليائه، وإذا كان خلاف ذلك كان في ذلك عذاب المؤمنين واضطهادهم وظلم الطبقة الفقيرة (العامة) من الناس.
ومواقع المسؤولية لا تبقى فارغة شاغرة، فإذا تولاها الصالحون كانت في خدمة الصالحين وجمهور الناس، وإذا زهد فيه الصالحون تولاها غير الصالحين لا محالة.
والنصوص الواردة في حظر التعامل مع الظالمين تخص الموارد التي يكون فيه دعماً لقيادة الظالمين، لا إسناداً ودعماً للمظلومين.
وقد أستأذن علي بن يقطين الذي كان من خواص الإمام الكاظم “ع”، وأحتل موقعاً سياسياً هاماً في حكومة هارون العباسي، استأذنه في ترك الموقع والانسحاب منه، فلم يأذن لـه الإمام”ع”، وقال: لا تفعل فان لنا بك أنساً، ولإخوانك بك عزاً، وعسى أن يجبر بك كسراً، ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه.
يا علي: كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، إضمن لي واحدة، وأضمن لك ثلاثة: إضمن لي أن لا تلقى أحداً من أوليائنا إلا قضيت حاجته وأكرمته، وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبداً ولا ينالك حد سيف أبداً، ولا يدخل الفقر بيتك أبداً)([10]).
الدرس الثاني:
قوله “ع”: (إعلم إنّ خلاصك مما بك من حقن الدماء، وكفّ الأذى من أولياء الله، والرفق بالرعية، والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، ومداراة صاحبك…).
إن أكثر ما يخافه الصالحون الذين يبتليهم الله تعالى بمثل هذه المواقع أن يقعوا في دماء المسلمين، في مواقع الغضب والقدرة، وهو أمر يفسد على الإنسان دنياه وآخرته بالكامل.
وفي هذا الكلام يبين الإمام سبيل الخلاص من هذه البلوى، وهو (العدل) و(التقوى والإحسان).
والعدل والتقوى هو كف الأذى عن أولياء الله.
والإحسان هو الرفق بالرعية وحسن المعاشرة مع لين، ولكن في غير ضعف.
ومن شأن العدل والتقوى والإحسان أن يمكّن صاحبه من أن يحفظ نفسه عن السقوط فيما حرمه الله.
ولا يتوهم أحد أن اللين بمعنى الضعف، وأن الشدة بمعنى العنف… وعلى المسؤول أن يتحلّى باللين، ولكن في غير ضعف، فإن اللين والحلم والصبر زينة المسلمين، ما لم يؤدي به إلى الضعف، والشدة في مواضع الشدة هيبة الحاكم ما لم تؤدِ به إلى العنف، (وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف).
ولا يتوهم أحد إنّ أخلاق الإدارة تعني الضعف، بل يكون ليناً إذا كان الموقف يستدعي العطف والرحمة، ويكون شديداً صارماً إذا تطلب الأمر ذلك، وهذه الشدة لا تعني العنف أبداً.
والإمام “ع” هنا يضع حداً واضحاً بين مفهوم (الشدة) ومفهوم (العنف).
فإن مفهوم الشدة يعني عدم التساهل مع الأخطاء والتقصيرات الخطيرة التي يحوّل تكرارها الحياة إلى فوضى، كما إن الإنسان المهمل إذا لم يجد الشدة التي تسبب لـه اليقظة والانتباه من غفلته، فانه سوف يستغرق في إهماله فتضيع المسؤولية المكلف بها.
الدرس الثالث:
قوله “ع”: (إياك والسعاة وأهل النمايم فلا يلتزقنّ بك أحد منهم، ولا يراك الله يوماً ولا ليلة وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، فيسخط الله عليك، ويهتك سترك…).
إن بطانة الحاكم يجب أن تكون بطانة صالحة، وعليه أن يحذر من بطانة السوء، فإن بطانة السوء يقربون إليه البعيد، ويبعدون منه القريب، ويرونه الحق باطلاً، والباطل حقاً، ويكرهون إليه العدل والحق، ويحببون إليه الباطل والظلم… والحاكم لا يملك في كثير من الأحوال إلاّ أن يأخذ أخبار ما يحيط به من البطانة التي تلتزق به، ولا يتمكن أن يمدّ قنوات الاستصلاح والأخبار إلى المجتمع مباشرة، إلاّ من خلال بطانته… فإذا كانت البطانة بطانة سوء أفسدوا رأيه في الناس وفي المجتمع لا محالة.
ولما كانت البطانة للحاكم ضرورة، في أغلب الأحيان، فعليه أن يسعى كل جهده لتقريب الصالحين، وإبعاد الفاسدين المتملقين، أصحاب السعاية والوقعية في الآخرين من نفسه، حتى يسلم لـه رأيه ونظره فيما حوله من المسائل التي تهمه.
وفي ذلك يقول أميرالمؤمنين “ع” فيما ينصح عامله الأشتر(رضوان الله عليه): (والصق بأهل الورع والصدق)، (ثم ألصق بذوي المروءات والأحساب)([11]).
إن على الحاكم أن يختار بطانته اختياراً، ولا ينزلق إليهم انزلاقاً عاطفياً، كما يفعل الحكام الضعفاء الفاسدون.
الدرس الرابع:
قوله “ع”: (وإياك أن تعطي درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو متمزح إلاّ أعطيت مثله في ذات الله…).
ثم يحذر الإمام الصادق “ع” عبد الله النجاشي والي الأهواز من أن يتسلل إلى بطانته الشعراء والماجنون والمضحكون الذين يتقربون إلى الحكام بالمدح الكاذب من الشعر، وبالمجون والخلاعة والتملق والطرب والكذب والإطراء الكاذب.
وقد أتخذ الخلفاء في مختلف عصورهم هذه الطبقة ندماء لهم في مجالسهم وكانوا يغدقون عليها العطاء بلا حدود، فكان الشاعر يتملق إلى الخليفة بقصيدة من الشعر والمديح الكاذب فينال بذلك الأموال الطائلة من بيت مال المسلمين.
فكان لكبار المغنين منزلة رفيعة في الدولة كإبراهيم الموصلي… وكانت جوائزهم من الخلفاء تفوق الحصر، ذكروا عن إبراهيم المذكور إنه غنى للأمين بشعر أبي نؤاس:
رشا لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن
فأستخفه الطرب حتى وثب من مجلسه وركب إبراهيم، وجعل يقبل رأسه! فنهض إبراهيم وأخذ يقبل أخمص قدمي الأمين وما وطئتا من البساط فأمر له بمبلغ كبير من المال.
وكانوا يعقدون مجالس للأدب والشعر، ونواد للطرب ومجالس لأخبار العرب وقصصهم في جاهليتهم، مما لا ينفع في دين ولا دنيا، فأختص بكل خليفة جماعة ممن عاصروه من أصحاب الأخبار والشعر مثل عبد الملك الأصمعي الذي لازم هارون العباسي، فكانوا يجالسونهم ويطلبونهم إذا أصابهم قلق أو أرق.
وإلى جانب هذه القصور الصاخبة بالمجون والفسوق والطرب والإسراف والإفساد كان يعيش الفقراء بهمومهم وآلامهم وفقرهم. والخليفة يعيش مع الماجنين والساقطين المتملقين من الشعراء بمنأى عنهم، يمنح أموالهم التي خصهم الله تعالى بها من بيت المال هذه الطبقة الساقطة من المجتمع.
(ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى).
إن تفقّد هذه الطبقة والاهتمام بحاجاتهم والسؤال عنهم وقضاء حاجاتهم، مسكن غضب الله تعالى، وينزل رحمته وفضله، وبخلاف ذلك يغضب الله تعالى على قوم يجفون هذه الطبقة البائسة المحرومة، ويقربون إليهم أصحاب المجون والخلاعة والساقطين من الشعراء المتملقين الذين يتبارون في المديح الكاذب والمجون، ومدح الحكام وأصحاب المال والسلطان.
الدرس الخامس:
(وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك عزّوجل بقدرته).
ثم يشرع الإمام الصادق “ع” بذكر مكارم الأخلاق في القيادة والإدارة الصالحة، فيقول “ع”: (يا عبد الله إياك أن تخيف مؤمناً، فان أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب “ع” إنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلاّ ظله وحشرة في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده.
وحدثني أبي عن آبائه، عن علي “ع” عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله، يوم لا ظل إلاّ ظله، وآمنه يوم الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنة، ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله مادام على المكسو منه سلك.
ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظماء سقاه الله من الرحيق المختوم ريه، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين…).
إلى أن يقول “ع”:
(يا عبد الله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن علي “ع” عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم…
يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه، عن علي “ع” أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه، أوبقه الله بخطيئته، حتى يأتي بمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا، ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت سروراً، ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سروراً، ومن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سروراً فقد سر الله، ومن سَرّ الله فحقيق على الله عزّوجل أن يدخله جنته.
ثم إنّي أوصيك بتقوى الله، وإيثار طاعته، والاعتصام بحبله، فأنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه، فأنه وصية الله عزّوجل إلى خلقه، لا يقبل منهم غيرها، ولا يعظم سواها، واعلم إنّ الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى، فإنه وصيتنا أهل البيت، فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً تسأل عنه غداً فافعل).
قال عبد الله بن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق× إلى النجاشي نظر فيه وقال: (صدق والله الذي لا إله إلاّ هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلاّ نجا)، فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته.
والكتاب طويل قد انتقينا منه هذه النقاط، ومن يحب فله أن يراجعه في مصادره.
اقرأ أيضاً:
المصادر والمراجع
- [1] ـ نهج البلاغة 3: 27 الكتاب27.
- [2] ـ بحار الأنوار 95: 226، ميزان الحكمة 1: 502.
- [3] ـ رحم الله الشهيد الرجائي، رئيس الجمهورية الشهيد للجمهورية الإسلامية، كان يقول: إذا حلّ وقت الصلاة لا تقل للصلاة لدي عمل يشغلني عنك، ولكن قل للعمل هذا وقت الصلاة.
- [4] ـ مصباح الكفعمي ص559.
- [5] ـ نهج البلاغة 3: 83 الكتاب 53.
- [6] ـ نهج البلاغة:كلمة رقم 328 من قصار الكلمات.
- [7] ـ دراسات في نهج البلاغة للشيخ محمد مهدي شمس الدين:40، وروائع نهج البلاغة لجورج جرداق: 83 و 233.
- [8] ـ والإمام “ع” يقصد بـ الأجمع ـ: الأوسع ـ لا محالة، للتفصيل الوارد في نفس المقطع من عهد الإمام “ع”، الذي يشعر بالتقاطع بين رضا العامة ورضا الخاصة، فلا يمكن الجمع بينهما فإذا رضى أحدهما سخط الآخر، لا محالة. يقول “ع” فإن سُخط العامة يجحف برضا الخاصة، وأن سُخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ـ.
- [9] ـ بحار الأنوار 78: 271 ـ 278، ووسائل الشيعة 6: 150 ـ 155.
- [10] ـ الكافي 5: 109 ح1، البحار 48: 172 ح13.
- [11] ـ نهج البلاغة 3: 88 و91.