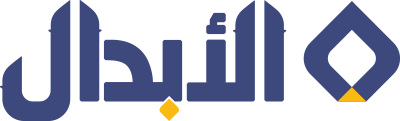هدنة الأيام السبعة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات.. تفاصيل المفاوضات والوساطات مع حماس

بموازاة التصعيد الميداني، واستمرار فترة السماح الأميركي والغربي للكيان الصهيوني للإيغال في دماء الفلسطينيين، ومحاولات جيش الاحتلال تحقيق نتائج ميدانية، بدا، في الأيام الخمسة الأخيرة، أن في واشنطن من بات يشعر بأن الأمور باتت تتطلّب تدخلاً أكبر في القرار الإسرائيلي، سواء لجهة وضع أهداف أكثر دقّة وواقعية للعملية البرية، أو لجهة بدء مفاوضات قد تنطلق من الباب الإنساني. وبحسب معطيات تجمّعت، يبدو أن هناك اختبارات دبلوماسية أولية، تتجاوز الهدنة الإنسانية إلى ما يلامس الحل الشامل.
وبحسب ما العملومات تنشط وساطات عدة، بدأت بين واشنطن والدوحة والقاهرة، واتّسعت لتشمل أنقرة وباريس، بالتنسيق مع وسطاء تنفيذيين، كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وبدأ البحث بعدما أصيبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخيبة كبرى مع تعثّر مشروع فتح مصر لمعبر رفح الحدودي لتهجير أبناء غزة. كما لمست الولايات المتحدة عدم جدوى كلامها العالي بضرورة إطلاق الأسرى المدنيين لدى فصائل المقاومة، قبل أن تبادر حركة «حماس»، من جانبها، بإعلان استعدادها للدخول في صفقة تبادل. إلا أن سلوك العدو الصهيوني فيما يتعلق بإدخال مساعدات عبر رفح، عقّد الأمور كثيراً، ودفع القاهرة، ومعها أنقرة والدوحة، إلى إبلاغ الأميركيين بأنه يصعب إقناع «حماس» بالسير في العملية طالما استمر السلوك الإسرائيلي على ما هو عليه.
وبحسب المصريين – الذين تظهر حكومتهم الخسيسة في كل ما تقوم به ضعفاً غير مسبوق في تاريخ مصر – فإن الكيان الصهيوني يعرقل الاتفاق الأولي الذي قضى بإدخال عشرين شاحنة مساعدات يومياً، وتفرض إجراءات مذلّة تؤخّر وصول الشاحنات وتمنع بعضها من الدخول. ونبّه المصريون إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعقّد أي محاولة سياسية لمعالجة ملف الرهائن.
وبناءً عليه، بدأ العمل على مبادرات عدة، بعضها محصور في الجانب الإنساني المؤقّت، وبعضها الآخر يفتح الباب أمام نقاش يقود إلى حل ينتج توقّفاً للعدوان.
في غضون ذلك، كان الأميركيون يراقبون حال حليفتهم. التعبئة الشاملة في الكيان الصهيوني لم تنعكس توحّداً مثمراً على صعيد عمل حكومة الحرب، مع تخبّط في القرارات، وتوسيع بنيامين نتنياهو لدائرة الاستشارات العسكرية والميدانية، والأصوات المنتقدة له من داخل الحكومة نفسها، وصراعه مع قادة الأجهزة الأمنية.
كل ذلك عزّز الشكوك في إمكانية تحقيق إنجاز نوعي أو سريع. ومع أن واشنطن لم تضغط على إسرائيل لوقف مجازرها، إلا أنها وجدت أن الوقت بات مناسباً لإطلاق مسارات أخرى. وبدأت عملية تحويل مهمة إطلاق سراح المدنيين، ومن بينهم حاملو الجنسية الإميركية، إلى عملية سياسية ولو ذات طابع إنساني، خصوصاً أن التجبّر الأميركي لم يعد قادراً على تجاوز الأصوات الرافضة للحرب.
وقد كانت «حماس» هي الأسرع في التقاط اللحظة، فبادرت بإطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين، معطية الوسيط القطري جرعة تعزّز موقعه التفاوضي لدى الأميركيين، وفعلت الأمر نفسه بإطلاق محتجزتين أخريين عن طريق المصريين المهتمّين بدورهم في المفاوضات. ومع دخول تركيا وروسيا ودول أخرى على الخط، تطوّر الأمر إلى طرح الوسطاء ورقة عمل لإنجاز بنود اتفاق. وقالت «حماس»، من جهتها، إنها جاهزة للتعامل إيجاباً مع عرضيْن: الأول، يتعلق بتبادل جزئي للأسرى، والثاني، يتعلق بعملية شاملة.
في الحل الجزئي، طُرح إطلاق المقاومة نحو 50 من المحتجزين المدنيين لديها ممن يحملون جنسيات أميركية وأوروبية وروسية وتركية وآسيوية، مقابل إفراج العدو عن الأسرى الفلسطينيين النساء والأطفال ومن يعانون أوضاعاً صحية صعبة، بالتزامن مع زيادة المساعدات الإغاثية للقطاع بما في ذلك الوقود.
ومع بدء البحث في التفاصيل، تبيّن أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقّدة، ويتطلّب وقف العمليات العسكرية. وفهم الأميركيون أن عليهم إقناع العدو الصهيوني بـ«هدنة تستمر أسبوعاً على الأقل»، يتم خلالها:
– قيام المقاومة بحصر العدد النهائي للأسرى لدى جميع الفصائل، وتحديد من هم على قيد الحياة ومن أُسروا أمواتاً أو قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وتمييز من ينطبق عليه صفة «مدني» عن العسكريين، إذ تعتبر المقاومة أن جنود الاحتياط ليسوا مدنيين. على أن تنجز فصائل المقاومة في ما بينها آلية لإجراء عملية التدقيق وتفاصيل ميدانية ذات طابع سرّي تتعلق بالتنفيذ.
– تنظّم مصر، إدخال المساعدات وفتح مطار العريش لاستقبال مواد الإغاثة من ضمن آلية تقوم بموجبها الأمم المتحدة بتسريع عملية نقل المساعدات خلال أيام الهدنة إلى كلّ مناطق القطاع، على ألا يكون هناك فيتو على أي مواد بما فيها الوقود.
– ينسّق العدو مع الصليب الأحمر الدولي لتثبيت لوائح بأسماء من يُفترض الإفراج عنهم ونقلهم إلى نقطة التنفيذ.
– توفّر الولايات المتحدة وقطر وتركيا والأمم المتحدة ضمانات للجانبين.
وبحسب المعلومات، كان يُفترض حسم كل هذه النقاط ليل الخميس الماضي، بعدما تبلّغ الوسطاء موافقة الولايات المتحدة. لكنّ تطوراً طرأ مع رفض قادة العدو الصهيوني صفقة مجتزأة وإصرارهم على إطلاق كل الأسرى لدى المقاومة، ورفض تصنيف الأسرى بين مدنيين وعسكريين. وتبيّن أن التعطيل الإسرائيلي سببه ضغط من أصحاب «الرؤوس الحامية» في الجيش ومجلس الحرب للسير مباشرة في العملية البرية، وإقناع الجمهور بأن تحرير الأسرى هو أول أهداف العملية البرية.
وبعدما حاول رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إيهام عائلات الأسرى بأن «حماس» ترفض عقد الصفقة، أطلقت المقاومة موقفاً أولَ في شأن الأسرى على لسان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام «أبو عبيدة». وبعد نشر تصريحات نتنياهو، تقرّر أن يُعلن موقف أكثر وضوحاً على لسان قائد حماس في القطاع يحيى السنوار الذي أعلن استعداد المقاومة لعقد صفقة شاملة فوراً.
ونُقل عن الوسطاء أن إرباكاً ظهر على الأميركيين، قبل أن يؤكدوا أنهم يؤيدون الصفقة، وأنهم يدرسون أساساً سلوك الكيان الصهيوني في الحرب، خصوصاً لجهة التزامها بتوصية وزارة الدفاع الأميركية بالتركيز على ضرب أهداف موضعية لمجموعات المقاومة، دون المغامرة في دخول كبير يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
ورغم تعثّر المساعي، ومبادرة العدو إلى إعلان بدء عملياته البرية، تواصلت الاتصالات، ودخلت مرحلة جديدة، خصوصاً بعد إعلان رئيس حكومة العدو، للمرة الأولى، عن بدء البحث في ملف الأسرى داخل مجلس الحرب.
مبادرة «غربية» لوقف الحرب وإطلاق الإعمار: سلـطة جديدة في غزة وقوات فصل على الحدود
الإرباك الإسرائيلي الواضح في وجهة إدارة المعركة ضد المقاومة في غزة، باستثناء مواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين، دفع الحلفاء الغربيين للعدو الإسرائيلي إلى البدء في البحث عن مخارج تقيه شر الهزيمة الكاملة.
وبحسب المعلومات، فقد تلقّى الوسطاء في المنطقة مؤشرات غربية إلى فتح ثغرة تقود إلى حلول تتجاوز الهدنة الإنسانية. غير أن مصادر فلسطينية أكّدت صعوبة الحديث عن مبادرات مكتملة، إذ إن جيش الاحتلال يسعى إلى تحقيق أي إنجاز ليقنع جمهوره بأنه انتصر. وأضافت أن ما يجري عملياً هو أن الولايات المتحدة تقدّر تخبّط العدو، وأن ما يُطرح تحت عنوان إنساني يمكن تحويله إلى حل دائم، مشيرة إلى أن الحديث عن مبادرات تتعلق بما بعد الحرب، لا يزال في إطاره الأولي، و«قوى المقاومة تدرس ما هو مناسب لحفظ الانتصار وإعادة الحياة إلى القطاع».
وفق المعلومات أن باريس بدأت اتصالات مع كل المعنيين بما يجري على الأرض، وفتحت خطاً مباشراً مع الدوحة وأنقرة لاستطلاع المواقف حول إمكانية البحث في حل مستدام. وحتى اللحظة، ليس معلوماً حجم التفويض الأميركي للفرنسيين، فيما لا تدّعي باريس بأنها تحمل تفويضاً إسرائيلياً، خصوصاً أن الوسطاء يسألون مسبقاً عن الضمانات، وهي في أساس ما تثيره «حماس» في كل نقاش يُفتح معها.
وبحسب المعطيات الأولية، يعمل الفرنسيون على التوصل إلى «هدنة دائمة»، بعنوان إنساني، لكنها تستهدف البحث عن حل سياسي شامل. وتفيد المعلومات بأن مسوّدة المقترح الفرنسي تشمل:
أولاً، إعلان وقف تام لإطلاق النار في كل محاور القتال، ووقف الغارات الإسرائيلية مقابل وقف عمليات القصف من قبل المقاومة.
ثانياً، إعداد جداول إحصائية للأسرى والمفقودين من الجانبين، تشمل أدقّ التفاصيل، لناحية الاسم الكامل مع تاريخ الميلاد وتاريخ الاعتقال ومكان السجن والتفاصيل الخاصة بجنسيته وما إذا كان يحمل جنسية أخرى، إضافة إلى صور شخصية حديثة لكل من هؤلاء.
ثالثاً، يتم الاتفاق على صفقة تبادل شاملة، تطلق المقاومة فيها كل الموجودين لديها، بمن فيهم مَن أسرتهم في حروب سابقة، مقابل إطلاق إسرائيل جميع المعتقلين من دون استثناء، المحكومين منهم أو الموقوفين إدارياً، والتعهّد بعدم اعتقالهم مجدداً.
رابعاً، تتم عملية التبادل في وقت واحد وفق آلية تشرف عليها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وبضمانة الدول الوسيطة التي تتولى ضمان التزام الطرفين بالتقيد بتفاصيل العملية.
خامساً، يتم الاتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من دون أي شروط مسبقة، وإيصال كل أنواع المساعدات إلى مطار العريش في سيناء، على أن تتولى الأمم المتحدة
ويبدو أن للمقاومة هواجسها، وخشية كبيرة من لجوء العدو الصهيوني إلى التنصل من وجود بعض المعتقلين لديه، أو أن يعمد إلى تصفية بعضهم ويعزو الأمر لاحقاً إلى مشاكل صحية، وبالتالي فإن المقاومة تحتاج إلى ضمانات واضحة وكاملة بتقيد العدو الصهيوني بالاتفاق، ومنع أي محاولة من جانب الكيان للتذرّع بمسائل قانونية مثل الإبقاء على من «تلطّخت أيديهم بالدماء»، أو عدم شمول الصفقة للأسرى الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ومن جهة العدو، تتعلق الهواجس ببند المساعدات، وطلب ضمانات تنفيذية تسمح له الاستمرار بتفتيش كل الشاحنات الداخلة إلى غزة، وضمانات بأن لا يكون لحركة حماس ومؤسساتها المدنية أي دور في الإشراف على المساعدات أو توزيعها في القطاع.
أي سلطة تدير القطاع؟
لكنّ الكلام الغربي، لا يقف عند هذا القسم فقط، بل هو ينتقل إلى ما يعتبره مقدّمات الحل السياسي الشامل. ويتصرف الغربيون على أن القسم الأول هو في مصلحة حماس لناحية وقف العدوان وإطلاق الأسرى وإدخال المساعدات، وأن المهم بالنسبة إليهم هو معالجة قلق العدو المتعلق بمستقبل الوضع في القطاع. وفي هذا السياق، تنتقل الورقة الفرنسية لتتناول نقاطاً مثل:
أولاً، إعادة تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها دولياً، وأن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون القطاع بالكامل.
مباشرة الإشراف على تسلّم هذه المساعدات من الجهات المانحة ومواكبة عملية نقلها إلى القطاع والإشراف على عملية توزيعها.
ثانياً، أن لا يبقى من الموظفين في المؤسسات الرسمية سوى المسجّلين على لوائح رواتب السلطة، وتسليم قوات الشرطة التابعة للسلطة، بعد إعادة تأهيلها، المسؤولية الكاملة عن إدارة الوضع الأمني في القطاع، وإلغاء المظاهر المسلّحة غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
ثالثاً، تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار القطاع، على أن تبدأ بإعادة بناء وإعمار ما يتعلق بتعزيز سلطتها.
رابعاً، التدرّج في برنامج إعادة الإعمار، من خلال وضع برنامج لإيواء النازحين الذين دُمرت بيوتهم، سواء عبر استخدام المنازل الجاهزة المؤقّتة أو أي خيار آخر، على أن يتم وضع برنامج عمل لعملية إعادة إعمار سريعة للمساكن مع البنى التحتية الخاصة بها.
الوصاية على غزة؟
وبحسب الأفكار نفسها، فإن النقاش ينتقل إلى البند الأهم، وهو الذي تطرحه إسرائيل من زاوية حاجتها إلى ضمانات عبر إجراءات تسمح لها بالحديث عن وضع مستقر. ومع أن العدو الصهيوني يطرح، كما حاول في لبنان عام 2006، مسألة نزع سلاح المقاومة في القطاع، إلا أن الأفكار الواردة في الورقة المنسوبة إلى الفرنسيين، تتضمّن عناوينَ كالآتي:
أولاً، نشر قوات أجنبية، عربية وإسلامية، على الحدود بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948. وتشترط إسرائيل أن لا تشارك في القوة أي دولة لا تقيم علاقات معها، على أن تتم مراعاة أن تكون لهذه الدول علاقات جيدة أو غير عدائية مع حركة حماس، مع إشارة مباشرة إلى الأردن ومصر وتركيا والإمارات وغيرها. لكنّ أحداً لا يجزم بالهوية الكاملة لهذه القوات أو عديدها وتسلّحها.
ثانياً، تنتشر هذه القوات على الحدود الغربية للقطاع مع أراضي الـ 48، وبعمق يصل إلى 3 كلم داخل القطاع. وهو أمر سيؤدي في بعض الحالات إلى تمركز القوات في مناطق مفتوحة، لكنه في مناطق أخرى يصبح انتشاراً ملاصقاً للمباني السكنية داخل القطاع.
ثالثاً، الشروع في ترتيبات تسمح بإطلاق عملية تفاوض برعاية دولية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم خلال فترة زمنية يجري تحديدها مسبقاً. وتركّز المبادرة على حل الدولتين، من دون الغوص في أي تفاصيل.
عملياً، أبرز المؤشرات في كل ما سبق إيراده، هو أن في الغرب من بدأ يفكر في أن الأمور لن تستقيم وفقاً لتصورات العدو. وإذا ما قارنّا المسار الزمني لمجريات ما يحصل في غزة، بما جرى في لبنان خلال حرب 2006، فإنه بات بالإمكان الدعوة إلى النظر بطريقة مختلفة إلى ما يجري.
ليس واضحاً إن كان العدو قد توصّل إلى قناعة بأنّه خسر هذه الجولة، وهو أمر لن يكون قابلاً للهضم في كل جسم إسرائيل. لكنّ السؤال بات موجّهاً إلى الولايات المتحدة والغرب: هل سيبادرون إلى إنقاذ إسرائيل من نفسها، أم يتركون الباب مفتوحاً أمام جنون يفتح المنطقة على احتمالات الحرب الواسعة ضد حليفتهم؟
ما الرابط بين الأسرى والعملية البرية؟
منذ أكثر من أسبوع، تبدي حركة «حماس» مرونة كبيرة إزاء صفقة تبادل الأسرى مع قوات الاحتلال. المطالبات في أميركا ودول أوروبية بإطلاق حملة جنسياتها من المعتقلين لدى المقاومة، وضغوط أهالي أسرى العدو، اضطرت الجميع لوضع الملف على الطاولة، بالتزامن مع العملية البرية. وزادت الضغوط الداخلية على حكومة العدو بعد إعلان المقاومة مقتل نحو 50 من الأسرى في الغارات الجوية. كما جرى الحديث مرات عدة عن تأجيل العدو عمليته البرية ربطاً بملف الأسرى.
في ما يتعلق بالمقاومة، فهي مستعدّة لعقد صفقة كاملة فوراً أو صفقة جزئية. وهي تقول صراحة إن صفقة شاملة تتطلب وقفاً تاماً للعدوان، وهذه أولوية للمقاومة ليس خشية على بنيتها العسكرية، ولكن لإيقاف حمام الدم وإدخال كميات كبيرة من المساعدات. أما التبادل الجزئي، فيبقي في يدها ورقة مهمة على طاولة التفاوض.
عملياً، يحتاج الكيان الصهيوني إلى تكنولوجيا متطوّرة لتحديد ما هو موجود تحت الأرض، يستخدمها علماء الجيولوجيا، وطوّرت برامجها شركات عالمية تعمل في التنقيب عن النفط والغاز والمياه والمعادن في باطن الأرض، إضافة إلى أجهزة استشعار تستخدمها الجيوش في قطعها البحرية لرصد الأجسام المتحركة من حولها، أو التثبّت من بقايا حطام أو عوائق صخرية. وهذه التكنولوجيا موجودة لدى إسرائيل، وهي تستخدم أجهزة الاستشعار لتحديد ما هو مدفون تحت الأرض أو تحت الماء. وبمقدور العدو تحديد مواقع الأنفاق، لكن في حالة وجود الأسرى، فإن هذه التكنولوجيا، لا تسمح للعدو بالتمييز بين هويات من هم تحت الأرض، عدا أنه بات واضحاً أن قوى المقاومة في غزة، أدخلت موادَّ خاصة في البناء، تعرقل تحديد طبيعة الحركة البشرية بصورة دقيقة.